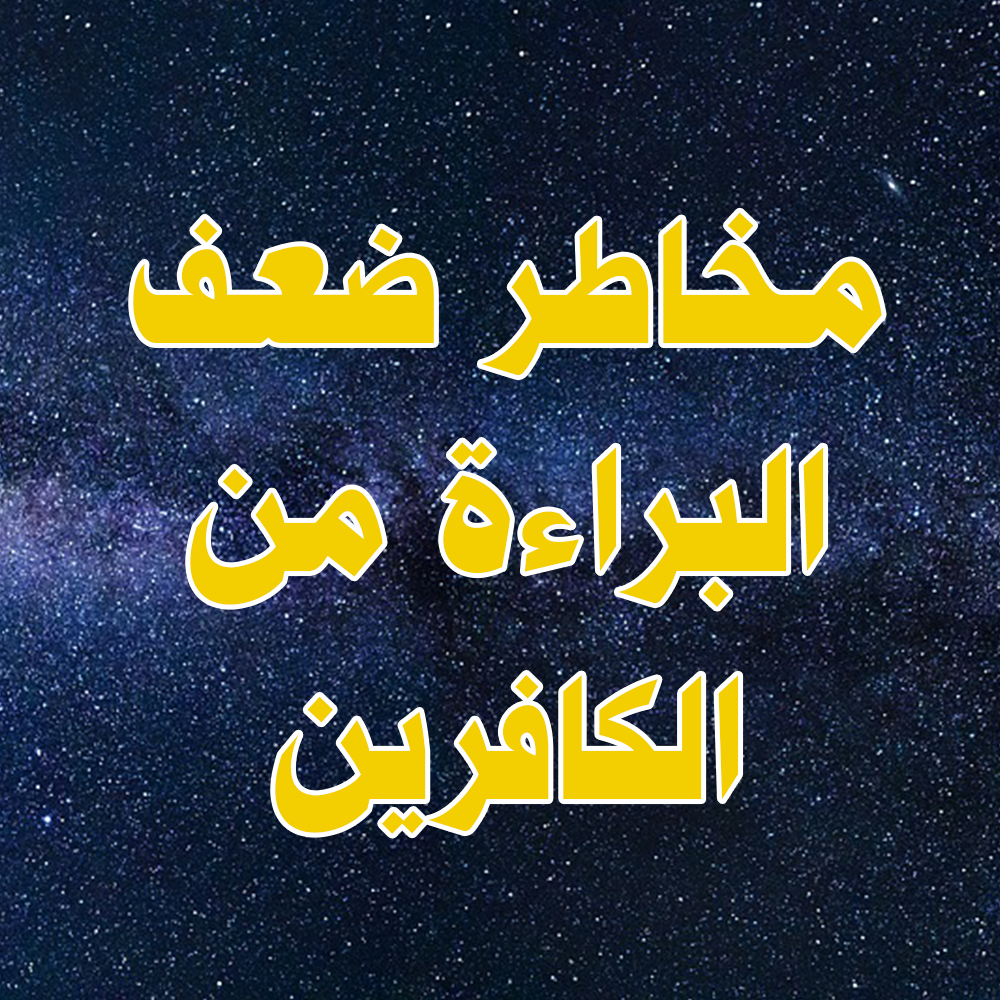آفات النفوس من أشد الآفات خطرا؛ إذ تضيع الجهد وتُبطل العمل، وتشين صاحبها، وتظهر مكنونه في عمله وقوله وسمته، وفي مواقفه. وقد تعم بلواها فيكون التأثير عاما على المسلمين بحسب موقع الشخص.
شهوة خفية
تعد هذه الأمراض الثلاثة ـ العجب والكبر والرياء ـ من أشد الأمراض فتكا بقلوب الناس وهي في الغالب متلازمة، كما تعد هذه الفتنة من أخطر آفات العلم ولا يسلم منها إلا من رحم الله، عز وجل. وهي من الشهوة الخفية التي قد تفتك بطالب العلم شعر بذلك أم لم يشعر. ويكفينا في الحذر من هذه الفتنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أول من تسعَّر بهم النار يوم القيامة.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم». (1ابن ماجه في المقدمة (260) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (209))
آثار السلف في التحذير من هذه الآفات
وللسلف ـ رحمهم الله تعالى ـ مواقف وأقوال كثيرة تصف أحوالهم وتواضعهم للخلق وانقيادهم للحق، واحتقارهم لأنفسهم، وحذرهم وتحذيرهم من هذه الآفات الخطيرة أختار منها ما يلي:
عن حبيب بن أبي ثابت قال: خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس، فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا؛ ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. (2صفة الصفوة 1/ 406)
وعن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله – يعني ابن مسعود، رضي الله عنه -: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم على رأسي التراب. (3نفس المصدر السابق)
وعن بسطام بن مسلم قال: كان محمد بن سیرین إذا مشى معه رجل قام وقال: ألك حاجة؟ فإن كان له حاجة قضاها؛ فإن عاد يمشي معه قام فقال له: ألك حاجة..؟ (4صفة الصفوة 3/ 243)
وقال الحسن: وكنت مع ابن المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فدنا منها ليشرب، ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه؛ فلما خرج قال لي: ما العيش إلا هكذا. يعني حيث لم نُعرف ولم نوقَّر.
قال: وبينما هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك. انتهى إلى حديث وفيه: قال عبد الله: وبه نأخذ. فقال: من كتب هذا من قولي؟ قلت: الكاتب الذي كتبه. فلم يزل يحكه بيده حتی درس. ثم قال: ومن أنا حتى يكتب قولي..؟؟ (5صفة الصفوة 3/ 243)
وقال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك: ما الكِبْر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العُجب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. (6سير أعلام النبلاء 8/ 407)
وعن وهب بن منبه قال: احفظوا عني ثلاثا: إياكم وهوى متبعا، وقرین سوء، وإعجاب المرء بنفسه. (7سير أعلام النبلاء 4/ 549)
يقول الذهبي، رحمه الله تعالى: فمن طلب العلم للعمل کسره العلم، وبکی على نفسه. ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء، تحامق، واختال، وازدری بالناس، وأهلكه العجب، ومقتته الأنفس (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) [الشمس: 9-10] أي: دسسها بالفجور والمعصية. (8سير أعلام النبلاء 18/ 191)
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن علِمني كلمات جوامع نوافع. فقال له عبد الله: لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردُدْه عليه وإن كان حبيبا قريبا. (9صفة الصفوة 1/ 419)
وقال يوسف بن أحمد الشيرازي في “أربعين البلدان” له: لما رحلت إلى شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر أبي الوقت، قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد کرمان، فسلمت عليه، وقبلته، وجلست بين يديه، فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك، ومعولي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي، لأدرك بركة علمك، وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له، وقصدنا إليه، لو كنت عرفتني حق معرفتي، لما سلمت عليّ، ولا جلست بين يديّ، ثم بکی بکاء طويلا، وأبکی من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. (10سير أعلام النبلاء 20/ 307)
وعن عبد الله بن مبارك قال: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال کلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. (11صفة الصفوة 4/ 122)
وعن الشافعي قال: وما کابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبتُه واعتقدت مودته (12سير أعلام النبلاء 10/ 33)
وقال عون بن عمارة: سمعت هشامة الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أرید به وجه الله عز وجل.
قلت – أي الذهبي -: والله ولا أنا. فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله، وحصّلوه، ثم استفاقوا، وحاسَبوا أنفسهم فجرَّهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعْدُ، وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله، فأبی أن يكون إلا لله. فهذا أيضا حسن. ثم نشروه بنية صالحة. (13سير أعلام النبلاء 7/ 152)
تفصيل أوصاف علماء السوء
وذكر الإمام الآجري فتنة عالم السوء بهذه الآفات فقال رحمه الله في وصفه:
“يتفقه للرياء، ويحاجّ للمراء، مناظرته في العلم تكسبه المأثم. مراده في مناظرته أن يُعرَف بالبلاغة ومراده أن يخطئ مناظره، إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن، يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة وهو يجور في المحاجة، يحتج على خطئه وهو يعرفه ولا يقر به خوفا أن يذم على خطئه.
يرخّص في الفتوى لمن أحب، ويشدد على من لا هوى له فيه. يذم بعض الرأي فإن احتاج الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه وعمل به. من تعلم منه علما فهمُّه فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا وإنما منفعته الآخرة ثقل عليه، يرجو ثواب علم ما لم يعمل به ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تخّلف العمل به.
يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمتهوكين. ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها ولا يخاف عِظم الحجة عليه لترکه استعمالها.
إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم ترکه أنَفا. إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم، وإن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما سئل غيره، وكان أولی به أن يحمد ربه إذ لم يُسأل، وإذ كان غيره قد كفاه. إن بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصاب هو فرح بخطأ غيره وكان حكمه أن يسوءه ذلك. إن مات أحد من العلماء سرَّه موته ليحتاج الناس إلى علمه، إن سُئل عما لا يعلم أنف أن يقول: لا أعلم؛ حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب.
إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه. إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطئه فيثبت بنصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين، يتواضع بعلمه للأكابر وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه. ويعُدّ نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء. قد فتنه حب الدنيا، والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به”.
قال محمد بن الحسين الآجري:
“من تدبر هذه الخصال نعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحيي من الله، وأن يسرع الرجوع إلى الحق. (14أخلاق العلماء للآجري ص (98 – 100))
درجات الكِبْر..! 
وقال ابن قدامة، رحمه الله تعالى، في مختصر منهاج القاصدين:
“واعلم أن العلماء والعُبّاد في آفة الكبر على ثلاث درجات:
الأولى: أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم؛ فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع؛ فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها.
الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصّر في حقه؛ فترى العالم يصعّر خده للناس كأنه معرض عنهم.
الثالثة: أن يُظهر الكبر بلسانه کالدعاوى والمفاخر وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره. وكذلك التكبر بالنسب؛ فالذي له نسب شریف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. (15مختصر منهاج القاصدين: ص 233)
الوقاية من مقت الله
في ضوء كل ما سبق من الآثار والمواقف الدالة على ذم الكبر والعجب والتباهي بالعمل يتضح لنا قبح هذه الصفات، وشدة خطرها، وفتنتها على الناس ـ وخاصة العلماء منهم وطلاب العلم.
ومن أخطر ما في هذه الفتنة مقت الله، عز وجل، لأصحابها ويتبع ذلك مقت الناس لهم وعزوف الناس عن علمهم وعدم القبول لهم؛ فبئس العلم الذي لا يدفع صاحبه إلى التواضع والإخلاص وقبول الحق من أي إنسان.
كما أن من فتنة هذه الأعمال أن تكون سببا في حبوط العمل وذهابه يوم القيامة في وقت يكون العبد فيه أحوج ما يكون إلى الحسنة الواحدة؛ فمغبون من تورّط وافتتن بهذه الخلال السيئة التي تُذهب بركة علمه في الدنيا والآخرة.
………………………………
الهوامش:
- ابن ماجه في المقدمة (260) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (209).
- صفة الصفوة 1/ 406.
- نفس المصدر السابق.
- صفة الصفوة 3/ 243.
- صفة الصفوة 3/ 243.
- سير أعلام النبلاء 8/ 407.
- سير أعلام النبلاء 4/ 549.
- سير أعلام النبلاء 18/ 191.
- صفة الصفوة 1/ 419.
- سير أعلام النبلاء 20/ 307.
- صفة الصفوة 4/ 122.
- سير أعلام النبلاء 10/ 33.
- سير أعلام النبلاء 7/ 152.
- أخلاق العلماء للآجري ص (98 – 100).
- مختصر منهاج القاصدين: ص 233.
المصدر:
فضيلة الشيخ/ عبد العزيز الجُليّل، كتاب “ففروا الى الله”، ص216-223.
اقرأ أيضا:
- فتن يجب الفرار منها.. فتنة الغربة
- فتنة الدنيا وزخرفها .. الأموال والأولاد
- مظاهر الفتنة بالأموال والأولاد
- فتن يجب الفرار منها.. فتنة الشرك والمشركين