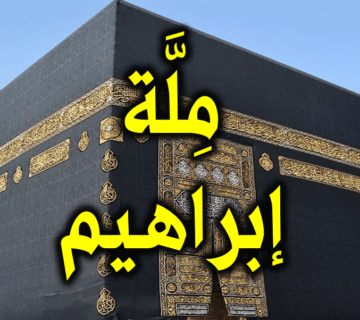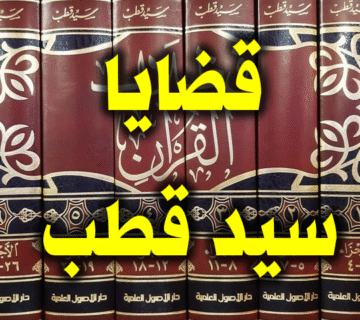الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين.
وبعد، فهذه رسالة أوجّهها للمسلمين المشاركين في المجلس التشريعي في سورية خصوصًا، وفي المجالس التشريعية في عالمنا العربي والإسلامي عمومًا، في العصر الذي تهيمن فيه العلمانية على أنظمتنا وعلاقات مجتمعاتنا؛ إبراءً للذمّة، وقيامًا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد رتّبتُها في فقرات مرقّمة، يُفضي بعضها إلى بعض، وغايتي منها أن يدرك المشارك في هذه المجالس خطورة العمل الذي يمارسه، ومسؤوليّته أمام الله والأمة، والواجب الشرعي الذي يقع على عاتقه عند انخراطه في هذه المجالس.
(1)
لستُ أرجو في رسالتي هذه إخباركم بأنّ الدخول إلى المجلس التشريعي شِرك بالله، بل أرى أن المشاركة في مثل هذه اللحظة التاريخية من بناء الدولة (وليس في أنظمة إجرامية ذات تمثيل نيابي مسرحي) ضرورية للمخلصين ليدافعوا بذلك الجهلةَ من العلمانيين والمتعلمنين، وكي لا يخلو الجوّ في هذه المؤسسة لمن فرّط في دينه أو لم يفهمه. وهو أمر كتبتُ فيه قديمًا وليس موضوع رسالتي هذه.
ما أراه أنّ مشاركة أهل الدين العاملين على إعلاء كلمة الله وإقامة شرعه وحفظ مصالح المسلمين ودفع المفاسد عنهم ضرورية جدّا لدفع الصيال عن الدين والأمة في جميع الساحات؛ في الفكر والممارسات والتشريعات والحقوق والحريّات وغيرها. أما التحرّز من الوقوع فيما يخالف الشرع فليس مستحيلًا على المسلم الواعي، وصُلبه ما سأكتبه في رسالتي هذه. فالخطر كل الخطر أن تدخل إلى المجلس التشريعي دون أن تمارس وظيفتك في إنكار المنكر المخالف لشرع الله والعمل على إزالته بقدر استطاعتك.
والمقصود بالمنكر ذلك المنكر الأكبر المستقرّ منذ الاحتلال الفرنسي، وهو تبديل الشريعة بأحكام وضعية حلّت مكانها في مسائل أخبرنا الله بأحكامها فيما أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والرضا عن هذا التبديل كُفرٌ أكبر بإجماع الأمة، ينقض أصل التوحيد كما سيأتي، ولا أحسب مسلمًا موحّدًا يرضى بذلك، ولكنّ عدم الرضا يجب أن يتجسّد واقعيّا خصوصا في مرحلة من الحريّة كالتي يعيشها أهلنا في سورية اليوم مقارنةً بما مضى. فلا يمكنك أيها المشارك أن تدخل المجلس التشريعي نائبًا وتظل ساكتا عن هذا المنكر، وتلك هي قضيتي هنا، فالنهي عنه واجب على كل مسلم قادر، وهو في حالتك آكَد؛ لملاصقتك للحالة، وللصلاحيات التي تملكها.
(2)
إنّ الإنجازات الدنيوية التي يسعى إليها المشاركون في برامجهم مهمة جدا، وأثق أنكم أدرى بالمشاكل التي يجب حلها والمنجزات التي يجب الشروع فيها. لكن نحن حيثما كنّا لا نخرج عن كوننا بشرًا خلقَنا الله تعالى لعبادته وحده، وأصل العبادة الطاعة مع غاية الحبّ والذلّ والتسليم والانقياد لله، أي لأمره ونهيه، أي لشريعته، وانظروا أقوال المفسّرين في آية تقرؤونها كل يوم مرات عديدة، وهي قوله تعالى: {إيّاك نعبد}، فقد اجتمعوا على هذا المعنى مع اختلاف ألفاظهم في التعبير عنه.
ومن ثم ينبغي أن يكون المسلم خاضعًا لله خالقه سبحانه، متّبعًا شريعةَ الله، داعيا مجتمعه إلى التزامها لأنّ فيها النجاة ورضى الرحمن الذي يعلم مَن خلَق وما يُلائم خَلْقه من تشريعات في كل زمان ومكان. وينبغي للمسلم أيضًا أن يكون مكافحًا للقوانين والتشريعات المخالفة للشريعة في مجتمعه، فكيف إذا أصبح عضوًا في المجلس التشريعي وفي أجواء تأسيسية بنائية كهذه؟! لا شكّ أنّ المسؤولية ستكون أكبر، ولهذا أتوجه إليكم هنا. ولقد رأينا في برامج كثيرٍ منكم التفاتًا لإصلاح بعض القوانين، مما يعني اطّلاعكم على نصوص القانون، والأَوْلى بالإصلاح هو الأخطر والأشد تأثيرا في البشر وإفسادًا لدنياهم وآخرتهم، وهو ما يضادّ العبودية لله عزّ وجلّ، وهذا محلّ إجماع بين عقلاء أهل الإسلام من جميع الطوائف والمذاهب.
(3)
حكى لنا الله في كتابه، بل في سوره المكّية، خطورة التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله. ومَن تصفّح سورة الأنعام، وهي سورة مكّية (انظر الآيات 136-153 على سبيل المثال) سيجد القرآن شديد الحساسية تجاه ممارسات المشركين الذين كان من شِركهم بالله تعالى أنّهم حرّموا وأحلّوا بغير ما أنزل الله، بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير. فهذه مسألة من صلب التوحيد وأصول الدين، قبل نزول تفاصيل الأحكام وفروعها في المدينة.
ولذلك قال في السورة نفسها مبيّنًا أحد أصول التوحيد (فالتوحيد هو إفراد الله بما لا يكون إلّا لله): {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا} (الأنعام: 114)، وهو كقوله تعالى في السورة نفسها: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} (الأنعام: 164)، فكما أنّنا لا نبغي غير الله عز وجل ربّا نؤمن بأنّه وحده الخالق المنعم مالك المُلك، فكذلك لا نبتغي غيره سبحانه قاضيًا يفصل فيما يتنازع حوله البشر بأهوائهم وأذهانهم القاصرة، فله وحده حقّ التحليل والتحريم، وليس للبشر أن يحلّوا ما حرّمه أو يحرّموا ما أحلّه، فإنْ فعلوا كانوا كمن اتّخذ غير الله معبودًا!
وقال سبحانه: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (الشورى: 21). فهذا الدين قد “بانت أصوله واتضحت فروعه وفصوله” كما يقول الإمام البقاعي في “نَظْم الدُّرر”، و”ختم بالقانون الأعظم في أمر الدارين”، وهو “شرع الله الذي ارتضاه لعباده”، فوبّخ سبحانه الضالين “عن قوانينه المحرّرة وشرائعه الثابتة المقرّرة”، وهو “في العبادات والعادات” كما يقول البقاعي أيضًا. أي أنه ليس في أمور المعتقدات والشعائر التعبّدية فحسب، بل كذلك تحريم الربا والاحتكار والنجش والغرر وفرض الزكاة دين، وحكم الله في السارق والزاني وقاطع الطريق والقاذف دين، وغيرها كثير من الأحكام التي جاءت مفصّلةً في الكتاب والسنّة، لتُنظّم أمر الأفراد والجماعة.
قال ابن عطية في “المحرَّر الوجيز” في معنى {شَرَعوا} في الآية السابقة: “معناه: أثبتوا ونهجوا ورسموا، و”الدين” هنا: العوائد والأحكام والسيرة، ويدخل في ذلك أيضا المعتقدات، لأنهم في جميع ذلك وضعوا أوضاعًا”.
وقال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (النساء: 65). فنفى الله – مقسمًا بنفسه سبحانه – الإيمانَ عمّن رفض التحاكم إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلّم أو عمّن تحاكم إلى غيرها، واشترط للإيمانِ الاطمئنانَ والتسليمَ لحُكمه عليه الصلاة والسلام.
وقال سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).
وخلاصة هذا كله أنّ أمر التشريع وما يتحاكم إليه النّاس عند التقاضي خطير جدا، فهو متّصل بأصل الدين وبتوحيدنا وعبادتنا وإيماننا، ولهذا لا يمكن لمسلم يدخل في “مجلس تشريعي” أن يغفل عن هذا، فهو “مسلم”، والإسلام يعني الاستسلام لله تعالى، ولا يصحّ الاستسلام لله تعالى ولغيره في الشرائع، وإلّا كان الإنسان عابدًا لهواه كما قال سبحانه: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} (الفرقان: 43).
(4)
وبناء على ما سبق، ينبغي لكم قراءة نصوص القانون السوري (فضلا عن الدستور) ومراجعته مع أهل العلم الشرعي للكشف عما يخالف محكمات الشريعة. والحديث ليس عن الأمور التي تتسع للاجتهاد، أو ما يدخل في “تنظيم المباح” ممّا لم ينزل فيه شرع من الله، بل عمّا ينكره المسلم العادي مما هو معلوم من الدين بالضرورة من أحكام الشريعة التي فصّل فيها كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم وحذّر من مخالفتها.
ولعلّ قائلًا يقول رغم هذا التوضيح: “هذه مسألة خاصّة بالعلماء وأنا لستُ عالمًا”، يظنّ أنّه بذلك يُخرج نفسَه من المسؤولية! وأؤكّد: المقصود هو قطعيات الشريعة التي لم يختلف حولها أهلُ الإسلام. ومثل هذا ينبغي أن يوضّحه كلُّ مسلم، خصوصًا إذا كان في موضع يكون فيه أقرب الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يتولّى مقعدًا في مطبخ التشريعات المخالفة للشريعة. ولذلك قال الإمام الضحّاك بن مزاحم (ت 105 هـ) في رسالته التي كتبها حول شعب الإيمان، إنّ من أعمال الإيمان:
“وَمَعْرِفَةِ الحَقِّ وَأَهْلِهِ، وَمَعْرِفَةِ العَدْلِ إِذَا رَأى عَامِلَهُ، وَمَعْرِفَةِ الجَوْرِ إِذَا رَأى عَامِلَهُ كَيْمَا يَعْرِفَهُ الإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ إِنْ هُوَ عَمِلَ بِهِ، وَمُحَافَظَةٍ عَلى حُدُودِ اللَّهِ، وَرَدِّ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلى عَالِمِهِ، وَجُسُورٍ عَلَى مَا لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ مِنْ قُرْآنٍ مَنُزَّلٍ وَسُنَّةٍ مَاضِيَةٍ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ لا شَكَّ فِيهِ، وَرَدِّ مَا يُتَوَرَّعُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ إِلى أُولِي الأَمْرِ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وَتَرْكِ مَا يَرِيبُ إِلى مَا لا يَرِيبُ”.
فالكلام عمّا لم يُختلف حول وجوبه من شرائع الإسلام أو تحريمه ممّا يضادّها، من قرآنٍ منزَلٍ أو سُنّةٍ ماضية، وليس في مقام الإفتاء ولا الاجتهاديات ولا ممّا يُتَوَرَّع فيه أو يريب الإنسان كما سيأتي بيانه.
ومعلومٌ لديكم أنّ الاحتلال الأجنبي لبلاد المسلمين كان قد بدّل التشريع والقانون، وإذا أخذنا بلاد الشام نموذجًا فقد ألغى الإنجليز والفرنسيون القانونَ العثماني المبنيَّ على أساس الفقه الإسلامي المؤسَّس على الشريعة (مع تأثيرات غربية لا تمسّ أساسه الشرعي) وهو “مجلة الأحكام العدلية”، وأبقوا على أبواب “الأحوال الشخصية” فحسب، وهي التي تعتني بأمور الزواج والأسرة والميراث وما شابه.
أما بقية الأبواب – وهي معظم مواد القانون – فقد جعلوا مكانها قانونًا سارت على هَدْيه النُّخب السياسية والقانونية العلمانية التي استلمت البلاد خلال الانتداب وبعده، ووضعتْ قانون البلاد في أواخر الأربعينيات مع تعديلاته اللاحقة. وهي قوانين مستلهمة في معظمها من القوانين الأوروبية أو من أهواء البشر، مع القليل من الاستهداء بالفقه والدين لذرّ الرماد في عيون “المتديّنين”!
وأخطر ما هذه القوانين أنها تحكم بأحكام مخالفة لشرع الله فيما نصّ الكتاب والسنّة على حُكمه الأبدي، وهي أحكام عديدة ينبغي مراجعتها وحصرها لتغييرها، وينبغي إعادة بناء آلية التشريع لتكون بما يأذن به الله تعالى، أي على وفاق الشريعة وأصول الفقه الإسلامي، لا وفق أهواء الغالبية. ولكني أذكر هنا نموذجين واضحين للاعتبار وإدراك مدى خطورة الأمر.
(5)
النموذج الأول: استحلال الربا: نجد في المادة 228 من “القانون المدني” الصادر بتاريخ 18/5/1949 وتعديلاته هذا النصّ: “يجوز للمتعاقدَين أن يتفقا على معدّل آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألّا يزيد هذا المعدّل على تسعة في المائة. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا المعدّل وجب تخفيضها إلى تسعة في المائة، وتَعيّن ردُّ ما دفع زائدًا على هذا المقدار”.
وهناك مواد أخرى تعالج “الفوائد” وتُشرعنها. وقد ظنّ المعاصرون أنّهم حين يسمّون الربا “فوائد” يَفرّون بذلك من حكم الله عزّ وجلّ، والواقع أنه من التلبيس كتسمية الخمر بالمشروبات الروحية، وهي – كما وُصفتْ في القانون – “ربا” حرّمه الله وجعله من الكبائر التي شدّد فيها في كتابه.
ومع ذلك فالقانون السوري يجرّم “المراباة” وما يسمّيه “اعتياد المراباة”! فجعل حدّا للربا مقبولا ويسميه “الفائدة القانونية”، وما يتجاوز هذا الحدّ في القروض يسمّيه “جرم المراباة”! فكأنّ واضعه يظنّ أنه بذهنه القاصر يعلم ما ينفع البشر وما ينبغي استحلاله وما ينبغي تحريمه وتجريمه أحسن من الله خالق الإنسان والعياذ بالله! (انظر في “قانون العقوبات” السوري المواد 647-650 حول “جرم المراباة” و”اعتياد المراباة”).
وقد قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (البقرة: 275).
وقال للمؤمنين في ندائه لهم باسمهم الذي سمّاهم به: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (البقرة: 278). ثمّ توعّد المخالف بحرب من الله ورسوله فقال سبحانه: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} (البقرة: 279).
بل حذّرنا من العقوبة في مخالفة أمره هذا بذكره خبر ما حلّ باليهود من قبلنا، فقال عزّ وجلّ: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (النساء: 160-161). وسيأتي ذكر محل الاعتبار من أهل الكتاب في كتاب الله، وهو باب خطير مغفول عنه في عصرنا.
وقال عليه الصلاة والسلام: “اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشِّرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات” (صحيح البخاري). وحسبُك لبيان عِظم جرم أكل الربا أن يكون مع هذه “الموبقات” كالشرك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وغيرها!
وعن عبد الله بن مسعود قال: “لَعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء” (صحيح مسلم). فليس الأمر في مجرّد أكل الربا، بل في التعاقد بناء عليه وقبوله والانخراط فيه.
والآن، بإزاء هذه النصوص كلها من الكتاب والسنّة، كيف يمكن لمسلم أن ينخرط في مجلس تشريعي، وينادي بقانونٍ لإصلاح كذا وقانونٍ لتوفير كذا من شؤون الدنيا وتنظيم المباحات، ثم لا يَنبس ببنت شَفةٍ لإنكار قانونٍ راسخٍ منذ أكثر من سبعة عقود في بلاده، يتّخذه الناس حَكمًا من دون الله، يحلّ لهم الربا الذي حرّمه الله؟!
(6)
النموذج الثاني: حكم السرقة: فقد جاء واضحًا في كتاب الله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (المائدة: 38). وفصّلت السنّة والفقهاء لاحقًا في تطبيقات هذا الحكم وشروطه، ولكنها في جميع الأحوال لم تُبطل هذا الحكم ولم تغيّره وتحلّ حكمًا آخر مكانه، فهذا أمر لم يفكّر فيه أحد من الفقهاء يومًا؛ لأنّه ردٌّ لأمر الله وشِركٌ في التحليل والتحريم.
وحين ننظر في “قانون العقوبات” من القانون السوري نفسه الصادر عام 1949 مع تعديلاته نجد المادة التالية رقم 621:
“1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
2- إنّ القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية”.
ثم نجد في المواد 622-646 أنّ العقوبات في جميع أنواع السرقة وظروفها وأحوالها تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبّدة والسَجن أو الحبس لسنوات مختلفة (من شهر إلى عشرين سنة) والأشغال الشاقة المؤقّتة والغرامة المالية والحبس التكديري، ولا توجد حالة واحدة عقوبتها ما حَكَم الله تعالى به في كتابه، وهو قطع اليد!
فكيف يرضى المسلمُ هذا الحال الذي يشبه حال الذين أَكثرَ القرآنُ مِن وصف مخالفاتهم مِن أهل الكتاب؟!
(7)
وهذه إحدى قصص أهل الكتاب، أسوقها هنا للاعتبار، وللردّ على من يغضّون من قيمة الحدود أو أحكام العقوبات في الشريعة (مع أنّ قضيتي هنا ما يتعلق بالشريعة عمومًا لا بالعقوبات فحسب، ولذلك بدأتُ بمثال الربا) فيقولون: الشريعة ليست حدودًا فحسب! فوهّنوا الحدود في قلوب الناس، وقد عظّمها الله تعالى واتّخذها معيارا واضحًا وفيصلا حاسمًا بين الانقياد لأمر الله عزّ وجلّ والانقياد لأهواء البشر، وهي قضية الإنسان الكبرى. بل قد جاءت هذه الحدود في مسائل يؤدّي تفشّيها في المجتمع إلى انعدام الأمن واختلاط الأنساب وتفكّك المجتمع والفوضى وسفك الدماء وغيرها، فهي من أسس بناء المجتمع السليم.
ولننظر الآن كيف أخبرنا الله بتجربة قوم سبقونا من أهل الكتاب، كيف بدّلوا الشريعة، وماذا كان حُكم الله فيهم من أجل ما فعلوه.
قال تعالى في كتابه حكاية عن قوم من اليهود بعد ذكره حدّ السرقة (فتدبَّر!) في سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * إِنَّا أَنزلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون} (المائدة: 41-44).
وعن البراء بن عازب في بيان قصة نزول هذه الآيات، قال: مرّ على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيهودي مُحَمّمٌ مَجلود، فدعاهم، فقال: “هكذا تجدون حدّ الزاني؟” فقالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم فقال: “نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟” فقال: اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حدّ الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كَثُر في أشرافنا، فكنّا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحدّ، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، وتركنا الرجم.
فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه” فأمر به فرُجم، فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} إلى قوله: {يقولون إنْ أوتيتم هذا فخذوه وإنْ لم تؤتوه فاحذروا} إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} في اليهود، إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} في اليهود، إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [المائدة:٤٢ – ٤٧]، قال: هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية” (سنن أبي داود، ورواه غيره).
وقال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا}: “إنْ أفتاكم محمد بالجلد والتحميم في صاحبنا فخذوه، يقول: فاقبلوه منه، وإنْ لم يفتكم بذلك وأفتاكم بالرجم، فاحذروا”. وذكر روايات نزولها، وهي مبسوطة في كتب التفسير والسنن.
لكنّ غاية ما أريد التركيز عليه هنا أنّ هؤلاء قوم قرّروا تبديل حكم من أحكام الله بأهوائهم، لأنّهم رأوا أن مصلحتهم في عدم إقامته، فألغوه وتواضعوا على حكم ليس في كتاب ربّهم الذي أنزله عليهم، أي التوراة. فكان وصف الله لفعلهم هذا هو الكفر: {فأولئك هم الكافرون}. والخلاصة المستفادة: مَن لم يَشْرع للناس ما شَرَعه الله لهم لِيَحكمَ به في مواضع النزاع؛ {فأولئك هم الكافرون}.
وهذا هو عين ما فعله أولئك العلمانيون الذين شرعوا القوانين الوضعية مع تأسيس الجمهوريات العربية والمسلمة، بما في ذلك الجمهورية العربية السورية، فبدّلوا الشرائع، ونبذوا ما شرعه الله للنّاس في تلك الأحكام كالربا والزنا والسرقة والحرابة والقذف وسائر الأحكام في الدماء والأموال وراء ظهورهم، واتّخذوا بأهوائهم أحكامًا جديدة قدّموها على أحكام الله تعالى.
ومن العجيب أن نقرأ أفعال أهل الكتاب من تحريفٍ لكتابهم وكتمهم العلمَ ونقضهم الميثاق، ويأخذنا العجب ممّا فعلوه، ومع ذلك لا نعتبر من ذلك، ولا نشعر أننا نسير في الطريق نفسه، وأنّ الله عزّ وجلّ إنّما أكثر لنا من ذكر سيرتهم لنحذر ونجتنب الوقوع فيما وقعوا فيه! ومن ذلك قوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلا} (النساء: 155). قال الإمام الطبري فيها: “فبنقض هؤلاء الذين وصفتُ صفتهم من أهل الكتاب ميثاقَهم، يعني: عهودَهم التي عاهدوا الله أن يعملوا بما في التوراة”.
والسؤال: هل عملنا نحن بما في كتاب الله عزّ وجلّ أم نقضْنا عهودنا ونبذنا أحكامه ولم نطالب بإقامتها؟
وإليك هذه اللفتة: فعن عائشة رضي الله عنها: أنّ قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقتْ، فقالوا: من يُكلم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ ومن يجترئ عليه إلّا أسامة، حِبّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فكلّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: “أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟!” ثم قام فخطب، قال: “يا أيها الناس، إنما ضلّ من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ، وايم الله لو أنّ فاطمةَ بنت محمد سرقتْ لقطَع محمدٌ يدَها” (صحيح البخاري).
فقد أخبرتُك قبل قليل أنّ قصّة اليهود الذين بدّلوا حكم الرجم جاءت في سورة المائدة بعد ذكر الله عزّ وجلّ حدَّ السرقة، فكأنها جاءت على سبيل التحذير من التفريط بهذا الحدّ وما هو مثله من حدود الله تعالى. وكأنّ في الآيات والأحاديث إشارة إلى تلك الطبيعة البشرية المتفلّتة، التي تميل مع طول العهد إلى التفلّت من أحكام الله تعالى.
ولذلك لم يكن عبثًا أن يأمر الله عزّ وجلّ رسولَه صلّى الله عليه وسلّم في آيات سورة المائدة أن يحكم بينهم “بالقِسط”: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، فالقسط هو العدل، وفيه تنبيه إلى أنّ المدخل للتفلّت عن هذا الحكم هو ما يضادّ القسط، وهو الجَور والعدول، وهؤلاء اليهود كان منشأ تفريطهم في حكم الرجم أنّهم لم يعدلوا، فحكموا للشريف بحكم وللضعيف بحكم، وكذلك حذّر الرسول صلّى الله عليه وسلّم الصحابة من التشفّع في حدّ من حدود الله، كي لا يكون هذا مدخلًا إلى الجَور الذي فعله اليهود قبلهم، فتأمّل.
وتأمّل كيف أنّ الله عزّ وجلّ قد أرسل رسُله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} (الحديد: 25). فقد جاءت الشريعة بالغاية في العدل. وكثير ممّن ينادون “بالعدالة” اليوم من النشطاء السياسيين غافلون عن هذا، إلّا من رحم ربّك.
(8)
إنّ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد أهم واجبات المسلم في هذه الدنيا، بل هو من صفات خيرية هذه الأمة كما قال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (آل عمران: 110). فلم يكتف بجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس خيرية هذه الأمة، بل قرنَه بالإيمان ليُعلمك عظيم قدر هذا الواجب الشرعي!
وقال عمّن سبقنا من بني إسرائيل ليحذّرنا من الوقوع فيما وقعوا فيه: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (المائدة: 78-79). فجعل أولى الصفات التي استحقّوا عليها اللعنة تركهم النهيَ عن المنكر!
وقد جعل سبحانه فلاحَنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال لنا: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (آل عمران: 104). فإذا لم تكن من هؤلاء أيها المشارك في المجالس التشريعية التي هي مطبخ صناعة التشريعات الوضعية المخالفة للشريعة فماذا تكون؟ وما قيمتك؟ وأين موقعك من هذه الأمة ورسالتها العظيمة؟!
وقال عليه الصلاة والسلام: “والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشكنّ اللهُ أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم” (سنن الترمذي).
وعن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (المائدة: 105)، وإنّا سمعنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: “إنّ الناس إذا رأوا المنكر لا يغيّرونه؛ أوشك أن يعمّهم الله بعقابه” (سنن ابن ماجة).
فالأمر في إنكار ما تجد من منكر يمسّ أصل الدين وشريعة ربّ العالمين ليس تفضّلًا منك أيها المشارك في المجالس التشريعية، بل هو واجب شرعي تأثم إنْ لم تقم به وأنت في هذا الموقف الخطير والمسؤولية العظيمة.
(9)
وهذا يقودنا إلى ما يخشاه بعض النّاس من ردود فعل “المجتمع الدولي” و”القوى العظمى” إذا ما ظهر في الشام أو غيرها من يدعو إلى إزالة ما يخالف الشريعة والعمل على إقامتها على قدر الاستطاعة. فمَن تدبّر آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحاديثه التي ذكرنا، وما توعّد الله سبحانه من عقاب جرّاء ترك هذا الواجب العظيم، كيف يخشى النّاس أشدّ من خشية الله؟
قال تعالى في ذكر قتال المشركين: {أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (التوبة: 13)، وقال سبحانه في قتالهم أيضًا: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا} (النساء: 77).
هذا في “القتال”، وقد نزلت هذه الآيات تبيّن أنّ الله أحقّ بالخشية من خشية الناس، فكيف والمطلوب الآن ليس الشروع في قتال الأمم، بل إزالة الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة، وأن يعمل هذا المجتمع المسلم بشريعته التي أنزلها الله سبحانه في كتابه، والتي هي جزء من دينه الذي هو أغلى ما يملك. فهل وصلت الخشية إلى هذا الحدّ المؤسف؟!
وهل يسوّغ فرضُ العقوبات الاقتصادية (إذا افترضنا أنه حدث) التفريطَ بأحكام الشريعة؟! وقد قال لنا سبحانه في آيات المائدة السابق ذكرها: {فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون}، فتأمّل!
إنّ المخاطَب في هذه الرسالة هو المسلم الذي يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة، فهو يتّخذ الصياغة والوسيلة التي يجدها مناسبة باجتهاده لإزالة ما يخالف الشرع وحثّ الناس على العمل بما عُطِّل منه. فكيف إذا كان من النُّخب التي تتولّى مسؤوليّةً ذات شأن خطير، ولها حضورها الإعلامي تبعًا لذلك؟
إنّ الواجب عليه أن يسعى في جعل هذه القضية قضيّة مجتمع وأمة، فيغدو المجتمع المسلم – في سورية وفي كل بلاد المسلمين – هو الذي يطالب بإزالة الأحكام المخالفة للشريعة وإقامة ما عُطّل منها؛ لأنّها تعبّر عن أحد ركائز تحقيقه للعبودية الخالصة للخالق عزّ وجلّ، وهذا أمر ينبغي أن يكون فوق السلطة وفوق المجتمع الدولي وفوق حسبان أحد.
فإذا عَطّل المسلمون ركائز من عبوديّتهم خشيةً من ردود فعل المجتمع الدولي فلن يقيموا الشريعة التي كُلِّفوا بها يومًا، وإنما الواجب أن يُقام من الدين ويُؤمر بالمعروف ويُنهى عن المنكَر على قدر الاستطاعة. والخوفُ من المجتمع الدولي ليس مسوّغًا كافيا للسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل لإعلاء كلمة الله!
ولا تنس أنّ وجودك في المجلس التشريعي ليس لأداء الوظائف التقليدية فحسب (التمثيل، التشريع، الرقابة على السلطة التنفيذية)، بل باتت المجالس التشريعية اليوم مع وجود الإعلام القوي منابر صانعة للوعي، ومن ثم فإنّ دورك يتعاظم من هذه الناحية أيضًا. ولتكن هذه فرصتك لإعادة بناء وعي المجتمع الذي نردّد في مختلف المحافل أنه متعَب مرهَق بعيد عن الدين ويجهل الكثير منه. إذن هذه هي الفرصة لتعريفه بدينه، بل بأساس دينه وهو معنى عبوديته لله وحده، وأنت أيها المسلم المتصدّر للمجلس التشريعي أحد أبرز الأصوات في سبيل ذلك بالتعاون مع العلماء والدعاة وسائر المسلمين الواعين العاملين لدينهم.
وأقول أخيرا: إنّ الخوف من فشل أي تجربة لا ينبغي أن يدفعنا إلى دفن قضية الشريعة، فهذه حسبة أرضية سطحية، منقطعة عن السنن الإلهية. فكما نوّهتُ قبل قليل يؤدّي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى معاقبة هذه الأمة وحلول اللعنة عليها كما حدث للأمم السابقة، فهذه واحدة.
ثم إنّ الله عزّ وجلّ قد بيّن لنا في كتابه بوضوح أنّنا إذا كنّا نرجو الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والأمن لهذه الأمة، فلا بدّ لنا من إخلاص العبودية لله والعمل بشريعته سبحانه. قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (النور: 55). ومن ثمّ يصبح “ما نخاف منه” هو أحد حبال النجاة والتمكين وإحلال الأمن في الدنيا قبل الآخرة!
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من كل من قرأ هذه الرسالة أن يرسلها لمن يعرف من المشاركين في المجلس التشريعي أو الناخبين لهم أو لأي مسلم له أثر في هذا الباب. قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة: 2)، وقال عليه الصلاة والسلام: “من دلّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله” (سنن أبي داود). والحمد لله رب العالمين.
المصدر
صفحة الأستاذ شريف محمد جابر، على منصة ميتا.