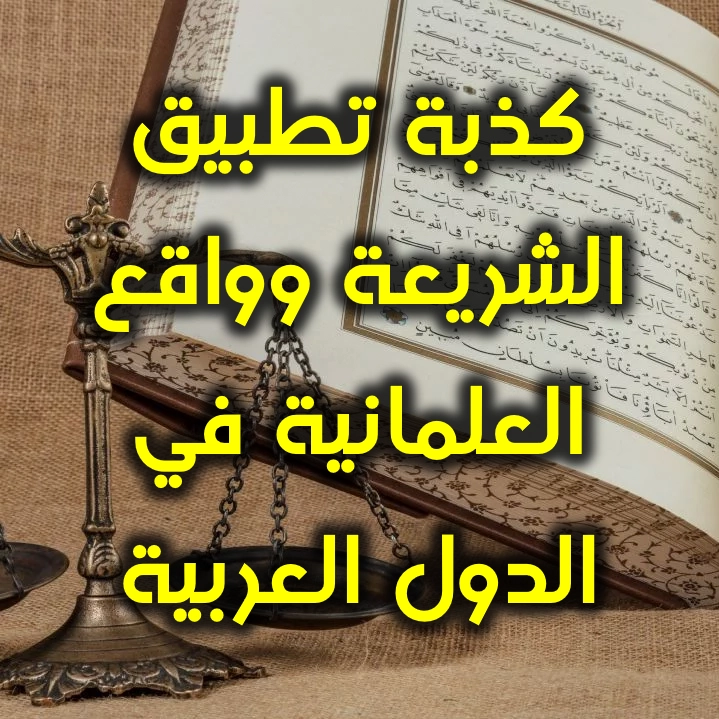هل الشريعة مطبقة فعلا في دولنا العربية والإسلامية أم أنها لا تقيم للشريعة وزنا إلا في أقل القليل في الأحوال الشخصية وبعض الأخلاقيات والحريات الدينية؟….
مقولة “الشريعة مطبقة”.. من يروّجها ولماذا؟
كذبة “الشريعة اليوم معظمها مطبّقة” مقولة تضليلية ما كنت أحسب أن أحدًا غير العلمانيين سوف يردّدها.
فمع الصراع العلماني الإسلامي منذ عقود، ومئات الدراسات التي كتبت في تفنيد مقولات العلمانية؛ يبدو أن بعض مشاهير الدعاة والمتحدّثين في الشأن الإسلامي لم يطلعوا على شيء من ذلك، وتحوّلوا إلى ناطقيين رسميين بلِحى إسلامية يردّدون الشبهات العلمانية التي كنّا نفنّدها من قديم!
والسؤال ما الأمور غير المطبَّقة من الشريعة؟ ولماذا نصف هذه البلدان العربية – بما في ذلك سورية – بأنها دول علمانية؟
الأصل المغيّب: سيادة الشريعة مقابل سيادة الهوى
سأذكر الأصل المغيَّب، ثم سأذكر نماذج بارزة من الأحكام القطعية المغيّبة.
فأما الأصل المغيَّب فهو ردّ أمر القانون والتشريع إلى الشريعة، وذلك من خلال منظومة “أصول الفقه” التي تمثّل طريقة المسلمين في استخراج الفقه العملي (الذي سيعمل به الناس: حكامًا ومحكومين) وبنائه على أسس الشريعة، فإما أن يكون في الأمر نصّ من الكتاب أو السنّة أو الإجماع لا اجتهاد فيه، وإما أن يكون بناء على نصّ من خلال القياس، وإما أن يكون ضمن أصول الفقه الأخرى كالمصالح المرسلة وغيرها، وجميعها تقع ضمن منظومة أصول الفقه التي عرفها الفقهاء مع اختلافات يسيرة لكنها لا تخرج عنها.
أما الحاصل اليوم فهو منظومة أخرى تماما غير مبنية على الشريعة، ومن يمارسها في البرلمانات لا يُشترط أن يكونوا فقهاء مجتهدين، بل هي مبنية على “أكثرية الأهواء” كما أحب تسميتها، أي أن إلزامية التشريع تحدّدها أصوات الأغلبية.
مواد الدستور الدينية: ذرّ للرماد في العيون
والمواد التي تقول “إن الإسلام دين الدولة” أو “مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع” أو “الفقه الإسلامي مصدر أساسي/رئيسي من مصادر التشريع” (موجودة في نظام الأسد والسيسي ومبارك إلخ!) فهي لذرّ الرماد في العيون، ولم تؤدّ إلى الانتقال إلى منظومة الفقه الإسلامي في بناء التشريعات، ولم تلغ ما يخالف الشريعة من قوانين نافذة تناقض أحكام الله منذ عقود طويلة، بل تفسيرُها القانوني كما يعرف خبراء القانون لا يعني أن الشريعة “مصدر إلزامي” بل “مصدر مادي” يغترف منه المشرّع الوضعي لبناء قانونه الوضعي، وقد يغترف من مصادر أخرى تخالف الشريعة، فلا توجد مادة تمنع مخالفة الشريعة، وإذا قضى قاضٍ – مثلا – بقطع يد سارق بلا ريبة ولا شبهة استجابةً لإلزامية الشريعة ليحقّق عبودية الله عزّ وجلّ (أي ليحقق لا إله إلا الله) فإنّ هذا القانون الوضعي الذي يوجد في دستوره “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي من مصادر التشريع” سوف يُبطل حُكمَه؛ لأنّه ببساطة يخالف نصّ المصدر الإلزامي وهو “القانون”! (وقد حدث شيء مثل هذا في مصر من قديم).
السيادة الحقيقية: للشريعة أم لأذهان الحكام والمشرّعين؟
هذا من حيث الأصل: أن سيادة الشريعة غير متحققة في هذه الدول، بل سيادة أذهان الحكام المستبدين وأهوائهم أو السيادة الشكلية لأذهان ممثّلي الأمة وأهوائهم مع تفاوت بين بلد وآخر وظرف وآخر. لكن كل ذلك لا يخرج عن كونهم يشرّعون لأنفسهم بأذهانهم القاصرة دون الانقياد للشريعة والتأسيس على مرجعيتها بأدوات أصول الفقه. بل أخذوا منذ الاستعمار طرائق الغربيين في تشريع القانون، واتبعوها حذو القذّة بالقذّة، مع “رشّة” من الشكليات والشعارات الدينية ومراعاة بعض الأمور في الأحوال الشخصية كي لا يصادموا المجتمع وعلمائه.
مجالات التعطيل الكبرى للشريعة
أما تفصيل المضامين التي تُظهر تعطيل الشريعة في المجال العام فأذكر أربعة مجالات تندرج تحتها أحكام عديدة:
تبديل الهوية: الولاء للقُطر بدلاً من الولاء للدين
– تبديل الهوية والولاء: فالولاء متمحور حول “القُطر الوطن” لا حول الدين كما ينبغي، و”المواطن” هو الأساس في تحديد الحقوق أو نزعها، ولا علاقة للإسلام في شيء. وقد فصّلت في هذا الموضوع في مقالي “لماذا يجب أن نتخلّى عن هوياتنا الوطنية؟” فانظره.
أحكام الأموال: إباحة الربا بنص القانون..
– أحكام الأموال غير منضبطة بالشريعة، فالبنوك الربوية شرعية وشائعة وتدير أموال الناس دون نكير أو منع من الدولة، بل الربا – وهو من أشد المحرّمات في الإسلام – مباح بنصّ القانون، ومقيّد بنسبة معيّنة فقط. وهذا وحده كافٍ ليكون “تبديلا للشريعة” وهو من الكفر (هذا حكم على الفعل لا على أشخاص بعينهم أو حكومة بعينها فالقانون قديم وموقف الإنسان منه هو الذي يحدد إسلامه من كفره). ووصفه بالكفر ضروري، يقول الشيخ مصطفى صبري في كتابه “موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين”: “ومن البلية أن الحركات التي تثار في الأزمة الأخيرة وترمي إلى محاربة الإسلام في بلاده بأيدي أهله والتي لا شكّ أنه الكفر وأخبث أفانين الكفر، يباح فعلها لفاعليها ولا يباح تسميتها باسمها لمن عارض تلك الحركات وحارب المحاربين. ولله در المعرّي حيث يقول: وتَعارَف القوم الذين عرفتهم .. بالمنكرات فعُطّل الإنكارُ. ولو قال “فأُنكر الإنكار” لكان أوفق بزماننا” (ص 4/282). وتحدث بعد ذلك عن تبديل الشريعة في مصر بكلام نفيس، هذا في الهامش. أما في المتن فقد حكم الشيخ مصطفى صبري على الحكومة التي بدّلت أحكام الشريعة وعلى من يطيعها في ذلك بالردّة. وما أقوله هنا ببساطة هو وصف فِعل التبديل لحكم الله في الربا من التحريم إلى الإباحة، فهذا كفر عند جميع أهل الإسلام، ويجب على المسلمين أن يعرفوا بأنّه كفر.
أحكام العقوبات: تعطيل الحدود واستيراد منظومة سجون فاشلة
– الكثير من أحكام العقوبات التي تسمّى في الشريعة “الحدود” معطّلة ومبدّلة بأحكام أخرى. ومن الخطأ التقليل من أهمية الحدود فهي منصوص عليها في كتاب الله، وهي أحد ركائز حفظ الدماء والأموال والأعراض بناء على الشريعة، بل ربَطها سبحانه بالإيمان في قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} إذ نزلت في قصة رجم اليهودي الزاني، فالاعتياد على التقليل من أهميتها عند بعض المعاصرين دليلٌ على عدم فقه خطورتها، ومنظومة الغرامات والسجون العلمانية التي حلّت مكان قتل القاتل العمد والقصاص في الجروح وقطع يد السارق وقطع أطراف المحارب وجلد الزاني البكر ورجم الزاني الثيّب وجلد القاذف؛ فشلتْ فشلا ذريعًا في حفظ الدماء والأموال والأعراض، بل أنشأت منظومة لتوليد الجريمة المنظّمة عند اجتماع المجرمين في السجون وتبادلهم العلاقات والخبرات، ومع ذلك لا نعتبر ولا نفيء إلى أمر الله!
رسالة الدولة: تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
– رسالة الدولة في الإسلام هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أسس إقامة الشريعة، وهذا معطّل لأن دولة المواطنة العلمانية لا يجوز أن تكون متبنّية لدين معيّن تدعو إليه وتطبقه في مختلف المجالات، ومن هنا نشأت “وزارة الأوقاف” ذات الطابع المادي العلماني، لأنها تحصر الدين في مجال محدّد، لتدير بعض الشؤون الخاصة بالمسلمين وأوقافهم: كالمساجد والمراكز الدينية والأنشطة الدعوية وما شابه، لكنها لا تضبط أمر الأموال مثلا كما قال قوم شعيب عليه السلام حين أدركوا مرامي الإسلام: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ}، فلن تُصدر وزارة الأوقاف مرسوما بحظر الربا في البنوك لأنّه محرّم، فهذا ليس من اختصاصها. بل تخصيص وزارة بهذا الشكل هو أحد مظاهر علمنة الدولة والمجتمع، إذ الدين هنا “جانب” من الحياة وليس “منهجًا” للحياة.
وهذه “الكوارث” في هذه المجالات الأربعة كافية وحدها لندرك أن الشريعة معطّلة عن الأمر العام سوى القليل من الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث وبعض الآداب العامة، وهي تشبه في هذا ما تفعله الدول العلمانية في الشرق والغرب.
تزييف الوعي ومقارنات مضللة
أما الحديث عن أمور تمارسها الدولة ونسبتها إلى الشريعة كحماية الناس وإفساح حرية الدعوة لهم والسعي في “راحتهم” فليست خاصة بالشريعة كي يقال إنها من “تطبيق الشريعة”، وسيجدها المسلم – مع الأسف – بمستويات أعلى في بلدان غربية كبريطانيا على سبيل المثال دون أن تسمى دولة إسلامية مطبّقة للشريعة! بل التضييق في المدارس الدينية الخاصة يجده المرء في بلد مسلم أكثر مما يجده في بلد غربي والله المستعان، لأنّ بلداننا حين تبنّت العلمانية تبنّت النماذج الشمولية منها، فهي الأكثر ملاءمة لمزاج السلطويين الذين يتهافتون لحكمنا!
الخلاصة والتوصيف الحقيقي
والخلاصة أنه من حيث الأصل يجب الإقرار بعلمانية دولنا العربية المعاصرة، سواء عذرنا العاملين في المجال السياسي أو الممسكين بزمام السلطة حديثًا بأعذار العجز والضغوط الدولية وظروف المجتمع إلخ أو لم نعذرهم.. فأمر طلب الشريعة والسعي في إقامتها شيء تُظهر صِدقَه السنين.
لكن القضية هنا عموما ليست في الحكم على القائمين على السياسة أو المنخرطين فيها، فهذا مبحث آخر، بل القضية في توصيف أوضاع الدولة والحكم بكل صدق وأمانة: أنها لا تقيم للشريعة وزنا إلا في أقل القليل في الأحوال الشخصية وبعض الأخلاقيات والحريات الدينية، أما أساس الشريعة والتشريع والولاء فعلماني معزول عن الشريعة.
المصدر
صفحة الأستاذ شريف محمد جابر، على منصة ميتا.
اقرأ أيضا
(أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) شريعتنا هي كل ديننا