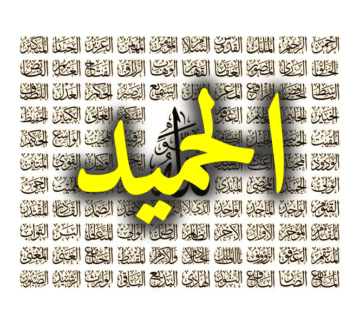إن لاسم الله الحكيم من الآثار العظيمة التي لا تعد ولا تحصى والتي ينبغي أن تنعكس على إيمان العبد في قلبه وسلوكه وحياته وأن يتعبد لربه بها.
تظهر آثار اسمه سبحانه (الحكيم) الجلية في:
1 – خلقه وصنعه في الآفاق والأنفس.
2 – وفي أمره الديني الشرعي.
3 – وفي أمره الكوني القدري.
الثمار العظيمة للإيمان باسمه سبحانه (الحكيم)
وهذه الآثار العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ينبغي أن تنعكس على إيمان العبد في قلبه وسلوكه وحياته وأن يتعبد لربه بها، ومن أهم هذه الثمار العظيمة ما يلي:
أولاً: أن شهود آثار حكمته سبحانه في خلقه وإتقانه لصنعه تثمر في القلب:
أ- محبة عظيمة لله – عز وجل – وذلك لما يشاهده العبد من الحكمة البالغة والخلق البديع والصنعة المتقنة التي تكفل للإنسان، الحياة الطيبة السعيدة، والتي تنشأ من هذه النعم العظيمة في خلق الإنسان وفي هذا النظام البديع الدقيق في خلق هذا الكون الفسيح الذي سخره الله – عز وجل – للإنسان ليعمره بطاعة الله تعالى وعبادته.
ب- كما أن هذا الشهود يثمر في القلب تعظيم الله تعالى والخوف منه سبحانه والحياء منه، والتأدب معه، وذلك بإخلاص العبادة له سبحانه والتماس مرضاته، وتجنب مساخطه.
ثانيًا: وفي شهود آثار حكمته سبحانه في أمره الديني الشرعي وأحكامه الشرعية التي شرعها لمصالح عباده في الدارين ثمار عظيمة تظهر آثارها في قلب المؤمن وحياته كلها ومن ذلك:
أ- محبة الله – عز وجل – المحبة العظيمة، حيث أنزل هذه الأحكام العظيمة التي تظهر فيها حكمته سبحانه المتمثلة في هذه المصالح الكبرى والخير العظيم الذي احتوته هذه الشريعة التي تحفظ للإنسان دينه، ونفسه، وعقله، وماله، وعرضه، وتكفل له الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة.
ب- شعور الغبطة والسرور بالهداية لهذه الشريعة العظيمة التي هي من لدن الحكيم الخبير، تنزيل من حكيم حميد، والسعي الحثيث لشكر الله تعالى عليها، والمحافظة عليها، وتجنب أسباب زوالها، والسعي لنشرها بين الناس.
جـ- الإذعان لأحكامه سبحانه الدينية وأوامره الشرعية، والاستسلام التام لها وألا يكون في القلب منها أدنى ريبة ولا حرج، قال الله عز وجل: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) [الأحزاب: 36]، وقال سبحانه: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء: 65]. وهذا الإذعان لأحكام الله تعالى الشرعية واجب وفرض متعين على الفرد، والمجتمع، والدولة، وذلك بأن يكون الحكم والتحاكم إلى شرع الله وحده، ورفض ما سواه. فمن لم يرى الكفاية في شرع الله تعالى فأعرض عنه أو بدله بغيره ولو في بعضه فإن هذا العمل مناقض للإيمان باسمه سبحانه (الحكيم) فضلاً عن أنه شرك في الطاعة والاتباع، بل شرك في توحيد الربوبية والذي من خصائصها السيادة، والحكم، والتشريع، وكلها حق لله تعالى لا يجوز صرفها لغيره سبحانه.
وإن خطورة هذا الشرك لتظهر جليًا في عصرنا اليوم الذي أُقْصي فيه شرع الله – عز وجل – جانبًا، وحكم في الأنفس، والعقول، والأموال، والأعراض بأنظمة البشر وأهواء البشر، التي تخلو من العلم والحكمة، ومعرفة عواقب الأمور، وإنما الذي يسيطر عليها الجهل، والهوى، والتخبط. وإنه لم يظهر مثل هذا الشرك الخطير في تاريخ الأمة الإسلامية كما ظهر في زماننا اليوم 1(1) يرجع إلى رسالة (تحكيم القوانين)، للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى..
وعن الاستسلام لشرع الله تعالى وأوامره ونواهيه يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:
“إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها، وآمنت بما جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به، ونهاها عنه، وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. بل انقادت، وسلمت، وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها، وإيمانها، واستسلامها على معرفته، ولا جعلت طلبه من شأنها. وكان رسولها أعظم في صدورها من سؤالها عن ذلك كما في الإنجيل: “يابني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا، ولكن قولوا: بم أمر ربنا”؛ ولهذا كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولاً، ومعارف وعلومًا لا تسأل نبيها لم أمر الله بذلك؟ ولم نهى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه، فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه، ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه، فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه، وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر، وأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورًا به، بحيث يتوقف الإنسان على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فهذا من عدم عظمته في صدره، بل يسلم لأمر الله وحكمته، ممتثلاً ما أمر به، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر، فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمر، أوفقهها العقل، كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال، وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده، ولم يقدح في امتثاله، فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت لا يعللها بعلل توهنها وتخدش في وجه حسنها فضلاً عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافها، فهذا حال ورثة إبليس. والتسليم والانقياد والقبول حال ورثة الأنبياء”2(2) الصواعق المرسلة 4/ 1560 – 1562..
ثالثًا: وفي شهود آثار حكمته سبحانه في أقداره ثمار عظيمة في القلب والسلوك
منها الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والإيمان بأن ما يقضيه الله – عز وجل – من أحكامه الكونية القدرية فيها الحكمة البالغة، وفيها الصلاح والخير، إما في الحال أو المآل مما نعلمه وما لا نعلمه مما يعود إلى كمال علمه وحكمته، ولو ظهر فيها شيء مما تكرهه النفوس وتتألم منه مما يقدره الله سبحانه، ففيه الخير والصلاح للناس، ولو لم يظهر للبشر هذه الخيرية؛ فلابد من الإيمان بأن الله – عز وجل – له الحكمة البالغة فيما يقدر، وهذا مما يقتضيه اسم الله (الحكيم).
يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى: “إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرًا، ووراء المحبوب شرًا، إن العليم بالغايات البعيدة المطلع على العواقب المستورة هو الذي يعلم وحده، حيث لا يعلم الناس شيئًا”3(3) في ظلال القرآن 1/ 223. أهـ.
والمقصود: أن الإيمان بأن الله سبحانه حكيم في قضائه وقدره؛ يثمر في قلب المسلم الاستسلام والرضا بما يقدره الله – عز وجل – من الأحكام الكونية القدرية، من مصائب وأمراض وغيرها، مما لا يستطيع دفعه بالأسباب الشرعية، أما ما يمكن دفعه ومنازعته بقدر آخر من أقدار الله – عز وجل – فإن هذا لا يعارض الإيمان بالقدر.
فالإيمان بعلم الله – عز وجل – وكتابته لجميع المقادير قبل وقوعها، ثم الإيمان بأنه سبحانه حكيم فيما يفعل ويقضي ويقدر، كل هذا يبث الرَّوح والطمأنينة ويسكبها في قلب المسلم المخبت لربه، المطمئن لقضائه وقدره، الموقن بأن كل ما يكتبه الله – عز وجل – عليه من مصائب وغيرها فهي خير له إما عاجلاً أو آجلاً، كما قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 185]، وكما قال صلى الله عليه وسلم: (عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)4(4) صحيح مسلم (2999)..
ولقد كان أنبياء الله – عز وجل – يدركون ما في أسماء الله – عز وجل – من العبوديات وما يلزم عليها من الرضا والتسليم والطمأنينة لقضاء الله وقدره.
فهذا نبي الله يعقوب – عليه الصلاة والسلام – عندما جاءه الخبر بحجز ابنه الثاني عند عزيز مصر – وقد سبق ذلك فقده ليوسف – عليه السلام – توجه برجائه ودعائه لله عز وجل.
قال تعالى يحكي حاله: (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [يوسف: 83].
وكذلك الحال ليوسف – عليه السلام – عندما جمعه الله بأبويه، حيث قال: (وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [يوسف: 100].
ومن خلال التأمل للآيتين السابقتين نلاحظ أن يعقوب وابنه – عليهما الصلاة والسلام – قد ختما تضرعهما لله – عز وجل – بعد المصائب التي حلت بهما بهذين الاسمين العظيمين (العليم الحكيم).
واختيار هذين الاسمين الجليلين في هذا المقام له دلالته ومغزاه؛ فأعرف الناس بالله – عز وجل – هم أنبياؤه ورسله، ولقد ختما تضرعهما إلى الله – عز وجل – باسم (العليم الحكيم)، وذلك – والله أعلم – لما يبثه هذان الاسمان الكريمان في قلب المسلم من الرضا والطمأنينة والتسليم لقدر الله – عز وجل -، وأن شيئًا في هذا الكون لا يحدث إلا بعلم الله – عز وجل – وحكمته البالغة.
والمقصود أن ظهور آثار حكمته سبحانه في قضائه وقدره، والإيمان الجازم بأن له سبحانه الحكمة البالغة بما ظهر أو لم يظهر لنا من الحكمة كل ذلك يثمر الطمأنينة، والسعادة، والرَّوح فيما يصيب المسلم من مصائب ومكروهات، كما يثمر راحة القلب من الهموم والحسد، والحقد التي هي في حقيقتها معارضة لأحكام الله القدرية، وارتياب في حكمة الله تعالى البالغة.
رابعًا: سؤال الله – عز وجل – الحكمة لأنه سبحانه هو مالكها ومسديها مع بذل الأسباب في تحصيلها بالعلم النافع، والعمل الصالح
قال الله سبحانه: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) [البقرة: 269].
يقول الشيخ السعدي – رحمه الله تعالى – عند هذه الآية: “والحكمة هي: العلوم النافعة، والمعارف الصائبة، والعقول المسددة، والألباب الرزينة، وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا، وأجل الهبات، ولهذا قال: (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال، إلى إصابة الصواب فيها، وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم، واستعد لنفع الخلق أعظم نفع، في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة، التي هي: وضع الأشياء في مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام، ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم، وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا (أُولُو الْأَلْبَابِ) وهم: أهل العقول الوافية، والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه، والضار فيتركونه، وهذان الأمران، وهما: بذل النفقات المالية، وبذل الحكمة العلمية، أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس) ” 5(5) تفسير السعدي 1/ 214..
موقف المسلم الحق أمام ما خفي من الحكم في خلق بعض المخلوقات
وأختم الحديث عن هذا الاسم الجليل الكريم بكلام نفيس للإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى – يبين فيه موقف المسلم الحق أمام ما خفي من الحكم في خلق بعض المخلوقات، وما خفي من الحكم في أوامره الشرعية وأوامره القدرية، يقول رحمه الله تعالى: “قد شهدت الفِطَر والعقول بأن للعالم ربّاً قادرًا حليمًا عليمًا رحيمًا كاملاً في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريدًا للخير لعباده مُجرِيًا لهم على الشريعة والسِّنّة الفاضلة العائدة باستصلاحهم، الموافقة لما ركّب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طِباعهم عليه من إيثار النافع لهم، المُصلِح لشأنهم، وترك الضارَ المُفسِد لهم.
الله عز وجل لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبدًا
وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وأنه المحيط بكل شيء علمًا، وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية، بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوّون بين مَن هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلمونه، وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم، وفي منازلهم حتى لا يقيموا في بلد فيها إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك المعنى الذي قصدوه منه، ولا يأمرون رعيتهم بأمر ولا يضربون عليهم بعثًا، ولا يسوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدّته، بل لا تتصرّف بهم الأحوال في مطامعهم وملابسهم ومراكبهم إلا أوقفوهم على أغراضهم فيه. ولا شكّ أن هذا مُنافٍ للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن ربّ العالمين، وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبدًا.
فحسب العقول الكاملة أن تستدلّ بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها، وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه، وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته وهل في قوى المخلوقات ذلك، بل طوى سبحانه كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع خلقه، فلم يُطلِع على ذلك ملكًا مقرّبًا، ولا نبيّاً مرسلاً.
أفعال الله وأوامره لا تخرج عن الحكمة والرحمة والمصلحة
والمدبّر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفى في ذلك عن تتبّع مقاصده فيمن يولي ويعزل، وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه، وفي تدبيره لرعيّته وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله، اللَّهم إلا أن يبلغ الأمر في ذلك مبلغًا لا يوجد لفعله منفذ ومساغ في المصلحة أصلاً، فحينئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم. ولن يجد أحد في خلق الله ولا في أمره ولا واحدًا من هذا الضرب، بل غاية ما تخرجه نفس المتعنت أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتها. وأما أن ينفي ذلك عنها – فمعاذ الله – إلا أن يكون ما أخرجه كذب على الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه. وإذا عرف هذا فقد علم أن ربّ العالمين أحكم الحاكمين، والعالم بكل شيء، والغني عن كل شيء، والقادر على كل شيء، ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قطّ عن الحكمة، والرحمة، والمصلحة، وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة، وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامّة الشاملة التي علموا ما خفي منها بما ظهر لهم. هذا وإن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرّفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما، وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها”6(6) مفتاح دار السعادة 1/ 318..
الهوامش
(1) يرجع إلى رسالة (تحكيم القوانين)، للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى.
(2) الصواعق المرسلة 4/ 1560 – 1562.
(3) في ظلال القرآن 1/ 223.
(4) صحيح مسلم (2999).
(5) تفسير السعدي 1/ 214.
(6) مفتاح دار السعادة 1/ 318.
اقرأ أيضا
اقتران اسم الله (الحكيم) ببعض الأسماء الحسنى


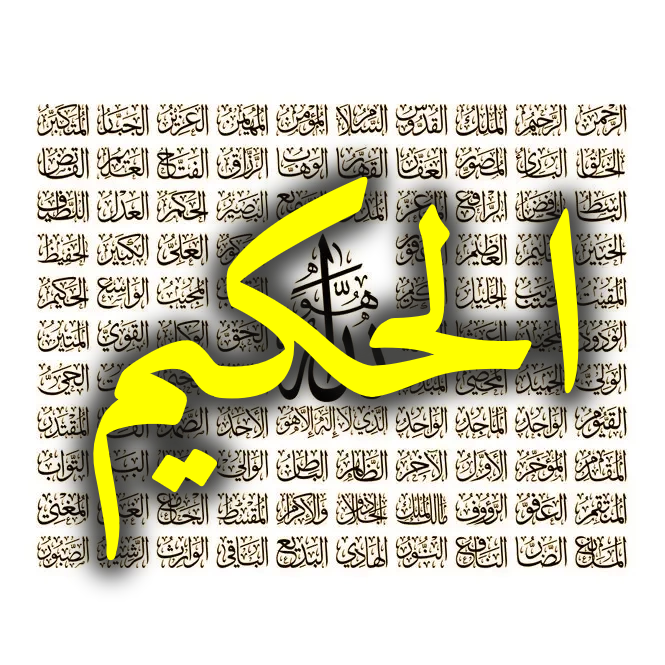



![من أسماء الله الحسنى: [المجيد] 5 المجيد](https://nasehoon.org/wp-content/uploads/2023/09/المجيد.png)