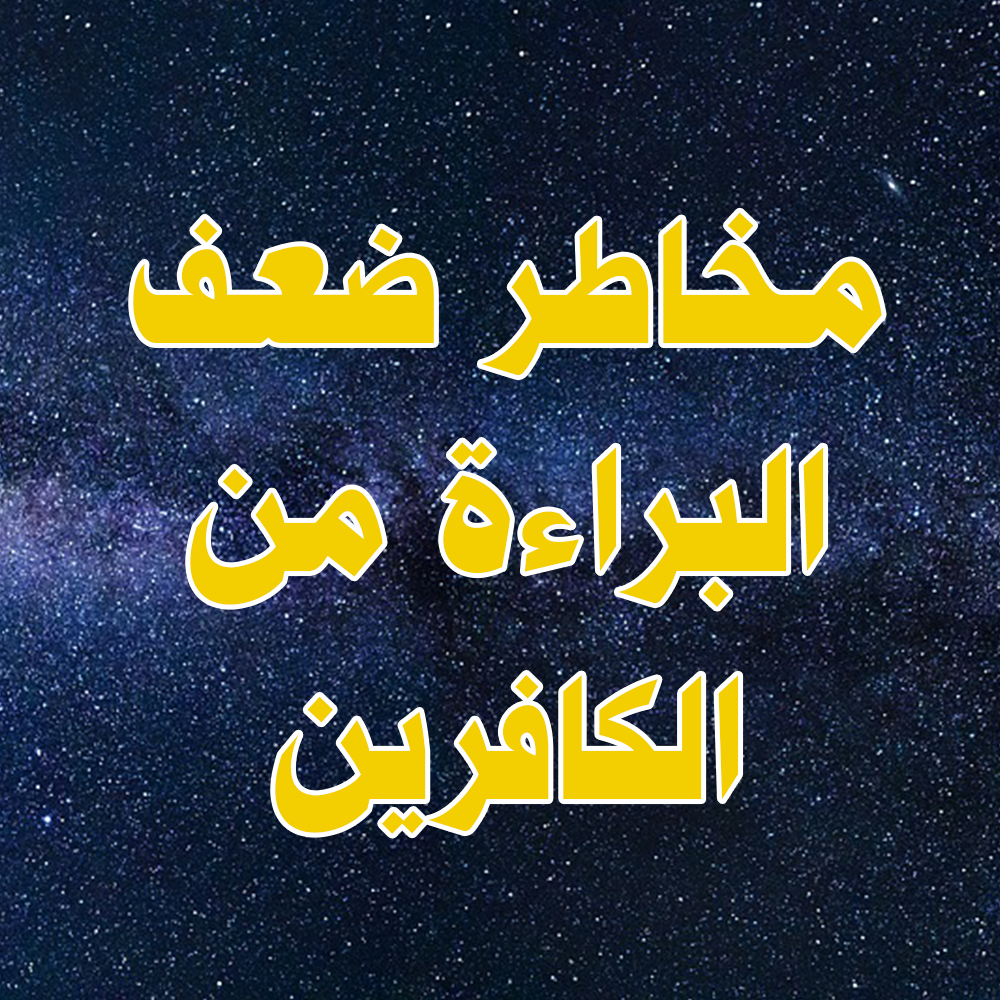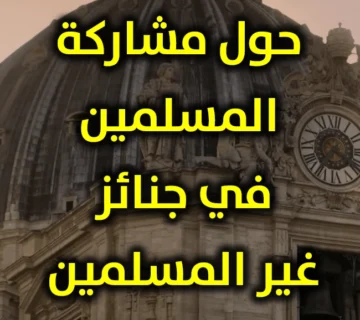هذا المقال يعين المسلم على تدبّر كتاب الله تعالى، لأنّ التوحيد هو المقصد الأول في كتاب الله سبحانه، وسيجد المسلم معانيه مبثوثة من أوله إلى آخره، وحريّ بالمسلم أن يفهم حقيقة هذا التوحيد ودلالاته وآفاقه في الواقع الذي يعيشه، وقد جمع الله لنا في سورة الأنعام معالم هذا التوحيد بوضوح شديد، أوردها بترتيب ظهورها في السورة.
اتخاذ الله وليّا وموالاة المؤمنين
{قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (الأنعام: 14).
توضح هذه الآية أنّ اتّخاذُ غير الله “وليّا” يُحَبُّ ويُستنصَر، سواء كان وثنًا أو غير ذلك، هو “شرك” منافٍ للإسلام. وهذا المعنى للولاء ينتظم سلوك المسلم في الحياة.
فكما أنّه يتّخذ اللهَ سبحانه وليًّا ويصبح من “أولياء” الله: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} (يونس: 62-63)، فإنّ الله سبحانه يكون “وليّه” من أجْلِ ما حمله من الإيمان: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ} (البقرة: 257)، فإذا والى الله ونصر دينه تولّى الله نُصرتَه وهدايته.
ويمتدّ هذا المعنى للولاء المملوء بالمحبّة والنصرة والإعانة إلى العلاقة مع البشر، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض في الدنيا: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (التوبة: 73).
والمؤمن لا يتّخذ من دونهم وليّا يحبّه ويناصره ويعينه: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} (آل عمران: 28). وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (المائدة: 51).
فهذا فعل المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النّار: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} (النساء: 138-139).
وحين يتلو المسلم هذه الآيات المتعلّقة بالولاء وأمثالها في كتاب الله، ينشأ في صدره موقف عظيم أساسه محبّة الله وولايته ونصرته ونصرة دينه، ويمتدّ هذا الموقف إلى موالاة المسلمين ونصرتهم وإعانتهم. وهذا الموقف ليس موقفًا قلبيّا سكونيًّا، بل ينسحب على الواقع لتتشكّل “أمّة” ينتمي إليها ويحمل معها رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين عمومًا كما دلّت آية سورة التوبة أعلاه.
إنّ التوحيد في هذا المجال يحمل غاية تبدأ بما خفق في القلب من محبّة لله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وتنساب في آفاق الدنيا محبّةً للمؤمنين ونصرةً لهم وتعاونًا معهم على البرّ والتقوى وعلى حمل رسالة هذا الدين. فلا يتآمرُ المسلم مع غير المسلمين على المسلمين، ولا يناصر أعداءهم عليهم، ولا يوالي ويعادي على أُسس وطنية أو قومية، فالإسلام هو محور ولائه، والأمة الإسلامية هي الأمة التي ينتمي إليها بعظمه ولحمه، لا يفرّق بين أبنائها على أساس الانتماءات القُطرية أو القومية، بل يصل الناسَ بالحبّ والولاء والنصرة بقدْر ما فيهم من إيمان وإسلام.
قبول شرع الله ورفض ما سواه
يقول الله تعالى: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا} (الأنعام: 114)، وفي هذه الآية تتجلّى حاكمية الله العليا التي تتحقّق بانقياد المسلم لشريعة الله تعالى التي أنزلها في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم.
وفي القرآن آيات عديدة تؤكّد هذا المعنى وتربطه بالتوحيد، فمن ذلك قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} (يوسف: 40). ولئن كانت القضية في هذه الآية هي عبادة الأوثان، فإنّ المدخَل الذي دخل منه يوسف عليه السلام لنفي هذه العبادة هو مدخل اتّباع أمر الله وقبوله، فإذا كان الله قد أمر ألّا نعبدَ إلّا إيّاه، فإنّ علينا ألّا نخضع لشيء سواه، سواء كان هذه الأوثان أو القائمين عليها ممن يقدّسونها ويروّجون لها في أعين النّاس ويأمرون وينهون، فيضعون الشعائر والشرائع التي تُتَّبَع من دون الله.
ارتباط الانقياد للشريعة بالإيمان والتوحيد
ومع أنّ لفظ “العبادة” وحده يدلّ بوضوح على تضمُّنها للطاعة والانقياد والخضوع لشريعة الله كما أجمع أهل التفسير، فإنّ كتاب الله مليء بالآيات التي تؤكّد ارتباط الانقياد للشريعة بالإيمان والتوحيد:
– كما في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلا بَلِيغًا * وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا * فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (النساء: 60-65).
– وفي قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).
– وفي قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (المائدة: 50).
– وفي قوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (آل عمران: 32).
– وفي قوله تعالى عن المشركين: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (الشورى: 21). فالتحليل والتحريم من دون الله هو من أفعال المشركين التي أخرجتْهم من عبادة الله وحده، فعبادته وحده تقتضي أن يُحلّوا ما أحلّ ويُحرّموا ما حرّم سبحانه.
– وقال تعالى عن أهل الكتاب: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (آل عمران: 64). قال الإمام فخر الدين الرازي (نحو 544-606 هـ) خلال تفسيرها: “إذا كان الخالق والمنعم بجميع النِّعَم هو الله، وجبَ أن لا يُرجع في التحليل والتحريم والانقياد والطاعة إلّا إليه، دون الأحبار والرهبان”.
– وقال تعالى مخاطبًا نبيّه صلّى الله عليه وسلّم: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} (الجاثية: 18-19).
– وقال له صلّى الله عليه وسلّم في موضع آخر واصفًا كتاب الله بالحُكم العربيّ: {وَكَذَلِكَ أَنزلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ} (الرعد: 37).
– وقال مخاطبًا الأمّة جميعًا: {اتَّبِعُوا مَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ} (الأعراف: 3).
حقيقة العبادة ولُبابها
وهكذا، تؤكّد هذه الآيات وغيرها حقيقة العبادة ولُبابها، فهي انقياد وخضوع لأمر الله تعالى، أي لشريعته التي أنزلها في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم. ومن ثم يتحدّد المنهج الذي ينبغي للمسلم اتّباعُه كي يُحقّق غاية وجوده في هذه الحياة.
كما أنّها تؤكّد نفيَ الشرك في الطاعة والاتباع والانقياد، فالمسلم لا ينقاد لهواه ولا يتّخذه إلهًا من دون الله: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} (الجاثية: 23). قال الطبري ناقلا أحد الأقوال في تفسيرها: “معنى ذلك: أفرأيت من اتخذ دينه بهواه، فلا يهوى شيئا إلا ركبه، لأنه لا يؤمن بالله، ولا يُحرِّم ما حَرَّمَ، ولا يُحلل ما حَلّلَ، إنما دينه ما هَوِيَتْه نفسُه يعمل به”.
وليست لدى المسلم معايير “حقوقية” أو “أخلاقية” وضعها البشر بأهوائهم يتلقّى منها الأحكام والقيم والأخلاق الصالحة سوى الشريعة وما حُمّل عليها، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية “سيداو” المتعلقة بالمرأة، ومعايير الصوابية السياسية (Political correctness) المستندة إلى المبادئ الليبرالية وغيرها مما يضعه البشر بأهوائهم بمعزل عن شريعة الله.
وهو لا يوزّع قلبَه على “شركاء متشاكسين” يتنازعون سُلطة القيَم في حسّه؛ فتارةً يأخذ قِيمَه من مصادر بشرية، وتارة يأخذها من الوحي! ولا يرضى عن التشريعات الوضعية التي تخالف ما أحلّ الله وحرّم، بل يسعى متعاونًا مع أمّته إلى تغييرها وإعادة باب التشريع والقوانين والأعراف العامة إلى الانضباط بما أنزل الله سبحانه، ولا يتغافل عن هذه القضية فقد ذمّ الله أقوامًا من أهل الكتاب فرّطوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر فوصفهم سبحانه قائلًا: {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (المائدة: 79).
وإنّ آفاق الشريعة كما تبدو في الكتاب والسنّة لَتتّسع لتشمل الحياة بأسرِها، من أحكام الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحجّ وسائر الشعائر، وأحكام العلاقات الزوجية والأسرية والاجتماعية، وأحكام الأموال بمختلف أنواعها، وأحكام السياسة والعلاقة مع الدول والمجتمعات الأخرى، والأخلاق والقيم، ومجالات الثقافة والتعليم والمعرفة وغيرها.
شعائر التعبُّد وأعمال القلوب
قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} (الأنعام: 162-164).
يقول الإمام الطبري في تفسير الآية الثالثة هنا: “يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صلّى الله عليه وسلّم: {قُل} يا محمد لهؤلاء العادلين بربّهم الأوثان، الداعيكَ إلى عبادة الأصنام واتّباع خطوات الشيطان: {أغير الله أبغي ربًّا} يقول: أَسِوى الله أَطلُبُ سيّدًا يَسودني؟ {وهو رَبُّ كلّ شيء} يقول: وهو سيّدُ كلّ شيءٍ دونَه ومدبّرُه ومُصلحُه”.
وقد ذكرت الآية الأولى هنا “الصلاة”، وهي أبرز الشعائر التعبّدية في الإسلام. وذكرت “النُّسُك”، وهو الذبح، والمقصود الذبحُ لله وحده، لا للأصنام أو الموتى أو الجنّ مما كان يذبح له المشركون.
والصلاة والنُّسُك شعيرتان من شعائر الله، وما ينطبق عليهما فيما يتعلّق بالتوحيد ينطبق على سائر الشعائر التعبّدية التي تحمل معنى التقرّب إلى الله أو دعائه وطلبه بوجهٍ غيبيٍّ غير معقول المعنى، أي بما لا نفهمه في إطار معاملاتنا الدنيوية مع البشر وأشياء هذا العالم المحسوسة، وتشتمل على أعمال القلوب كالدعاء والاستعانة والاستعاذة والنَّذر والذبح والسجود والتوكّل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والخشية وما إلى ذلك، فصَرْفُ أيٍّ من هذه العبادات إلى غير الله قادح بالتوحيد، سواء كان شركًا مخرجًا من الإسلام أو “شركًا أصغر” يتجنّبه المؤمن ويَحذر من الوقوع فيه؛ لأنّه يخدش التوحيد ويُشتّت قلبَه ويُضعف إيمانه.
لقد صنع منهاج العبادة في القرآن القلبَ القويّ الذي تنبع قوّته من تعلّقه بالله وحده ودعائه وحده وتوكّله عليه وحده وخشيته منه وحده. وهذه المعاني القلبية وغيرها وإنْ كانت من عبادة الله وحده بلا شريك، فإنّها تُعين الإنسان أيضًا على احتمال هذه الرحلة الأرضية الشاقّة قبل بلوغه الجنّة، ففي هذه الدنيا صوارف ومنغّصات هي من صلب الابتلاء، من شهواتٍ وأهواءٍ وشياطين، ولا بدّ له من ركن مكين يلجأ إليه ويسند به قلبَه إلى أن يبلغ برّ النجاة.
والآيات التي تتناول باب الشعائر من صلاة وسجود ودعاء وما يتبعها من أعمال القلوب كثيرة جدًّا، نظرًا إلى أنّها كانت مشكلة المشكلات في المجتمعات الوثنية التي نزلت عليها الرسالة، وفي المجتمعات الوثنية السابقة التي حكى القرآن قصصها مع رُسُلها وأنبيائها عليهم السلام.
فقد كان المشركون يسجدون لغير الله تعالى فقال لهم: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (فصلت: 37).
وكانوا يدعون غير الله من الأرباب المزعومة: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} (الإسراء: 56-57). فأرشدهم – بعد بيانه فسادَ دعاء غير الله – إلى عبادة التوسّل والرجاء والخوف التي كان يقوم بها مَن جعلوا منهم أربابًا وهم أهل إيمان بالله تعالى.
وقال عزّ وجلّ ناهيًا عن دعاء غيره: {وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (القصص: 88). وقال سبحانه: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (الجن: 18). قال الإمام الطبري في تفسيرها: “ولا تُشركوا به فيها شيئا، ولكنْ أَفرِدوا له التوحيد، وأَخلِصوا له العبادة”.
وقال تعالى في مواجهة عبادة المشركين لأربابهم من أوثان وغير ذلك مما يعبدونه من دون الله: {تَنزيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} (الزمر: 1-3).
وقال سبحانه داعيًا عباده إلى دعائه وحده: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (غافر: 60). وقال مرغّبًا: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (البقرة: 186).
وقال عن الاستعانة: {إيَّاكَ نعبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (الفاتحة: 5). وممّا ذكره الإمام أبو المظفّر السمعاني في سبب تقديم {إيَّاكَ نعبُدُ} على {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قوله: “لأنّ الاستعانة نوعُ تعبُّد، فكأنه ذكر جملة العبادة، ثم ذكر ما هو من تفاصيلها”.
وقال عن الاستعاذة: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} {الفلق: 1}، وقال: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (الناس: 1).
وقال عن الخشية: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} (المائدة: 3).
وقال عن التوكّل والصبر: {وَمَا لَنَا أَلا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} (إبراهيم: 12). وقال عزّ وجلّ: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (المائدة: 23).
وقال عن الخوف: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (آل عمران: 175).
وقال عن الرغبة والرهبة والخشوع في وصف زكريا وزوجه ويحيى عليهم السلام: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} (الأنبياء: 90).
قيمة الإنسان تتحدّد بإيمانه وعبادته لله سبحانه
ومن أجمل ما علّمنا ربُّنا جلّ جلاله في كتابه قوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ} (الفرقان: 77).
يُعْلِمنا أنّ قيمة الإنسان تتحدّد بإنجازه الأهم، وهو إيمانه وعبادته لله سبحانه، فلا قيمة للإنسان حين يتجرّد عن رسالته وغاية وجوده في هذه الدنيا.
وإذا كان الإنسانُ يجزع من ألّا يعبأ به أحدٌ من الخَلْق الهالكين، فكيف وقد سقط من بال ربّ العالمين؟!
وكم غفلَ الناس اليوم عن هذا المعنى الذي تُقرّره الآية، وهو أنّ أول من ينبغي أن تسعى إلى رضاه وذكره (و”اهتمامه” و”تقديره” بلسان أهل هذا العصر) هو الخالق سبحانه الذي امتنّ عليك بفرحة وجودك بعد أن كنت في العدم، وببُشرى أبديّة النعيم في جنان الخُلد لو اجتزتَ هذا الابتلاء الدنيويّ منغمسًا بسعادة التوحيد.
ولكنّ الإنسان ينسى، فيطلب بالَ الناس واهتمامهم وتقديرهم، وتنفرج أساريره بآرائهم وتصفيقهم، ثمّ يغترّ بخالقه الكريم!
فاللهمّ أَخرجنا من عتمة بال الخَلْق إلى ضياء بالك، ومن “قلق السعي إلى المكانة” بين ظَهرانيهم إلى شرف السعي في مرضاتك ودفء التلفّع بذكرك.
المصدر
صفحة شريف محمد جابر على منصة ميتا.
اقرأ أيضا
سورة الأنعام وأضواء على ركن من أركان التوحيد
سورة الأنعام .. البدء بالعقيدة وأثره العملي
حدود الولاء المكفر .. حفظا للأمة ومنعا للغلو