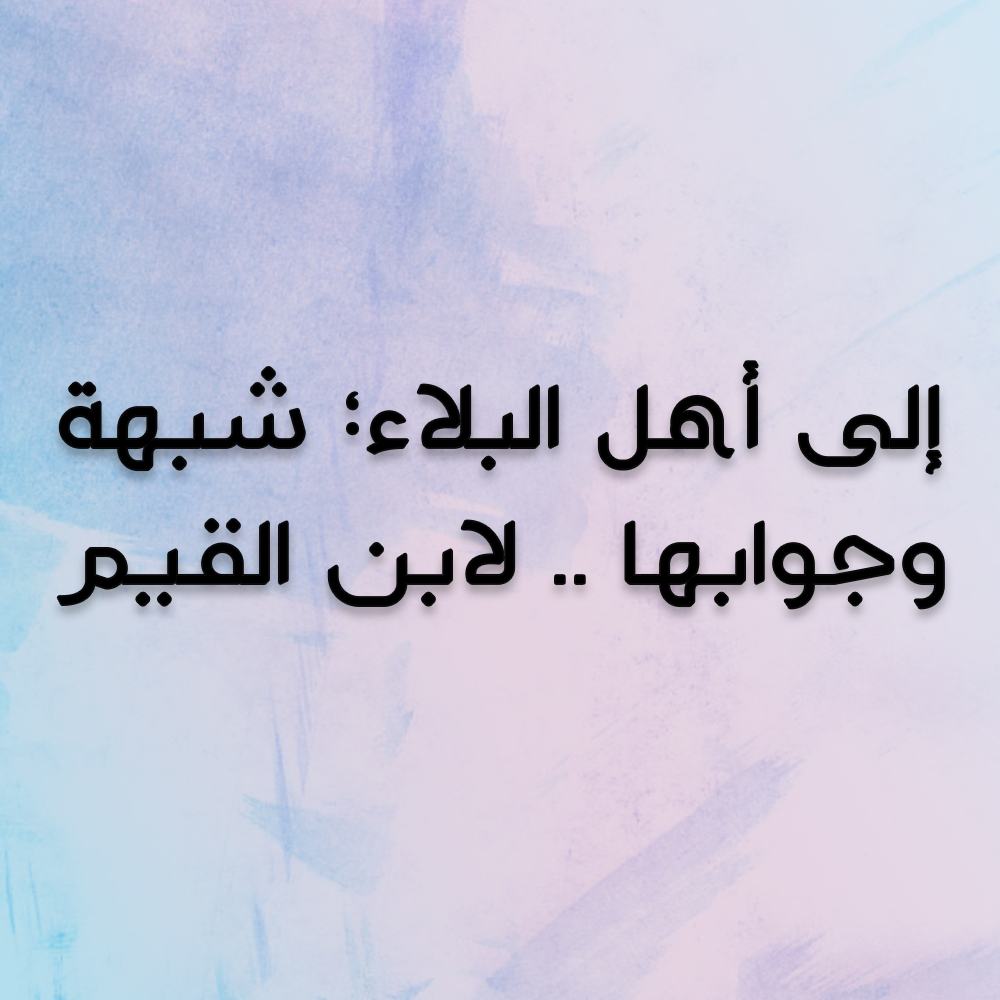في البلاء حكمة. وثمة نفوس تخطيء في فهم قراءة قواعد الصراع بين الحق والباطل، والحكمة من الأمر، أو تيأس من نصر دينهم وتظن إدالة الباطل مستقرة.
مقدمة
تضطرب النفوس عن بلاء إدالة العدو حينا وتتساءل؛ مرة عن الحكمة، ومرة تتصور تصورات خطأ بأن الباطل مدالٌ ومستقر، وأن ليس للحق انتصار في الدنيا.
ثمة ظنون يحسن العبد فيها الظن بنفسه ويسيء الظن بإخوانه أو بربه.
ذكر الشبهة
أورد ابن القيم رحمه الله، هذه الشبهة على الوجه التالي؛ ثم أجاب عنها:
أن الإنسان قد يسمعُ ويرى ما يُصيب كثيرًا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينالُ كثيرًا من الكفار والفُجار والظلمة في الدنيا من الرياسة والمال، وغير ذلك، فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل، وكذلك قد يعتقد أن العزَّة والنُّصرة في الدنيا تستقرُّ للكفار والمنافقين على المؤمنين.
فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8]، وقوله: ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات:173]، وقوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِ﴾ [المجادلة: 21]، وقوله: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: 83]، ونحو هذه الآيات، وهو ممن يصدق بالقرآن، حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط، وقال: أما الدنيا فإنَّا نرى الكفار والمنافقين يغلِبون فيها، ويَظهرون ويكون لهم النصر والظفَر، والقرآن لا يَرِدُ بخلاف الحسِّ.
ويعتمد على هذا الظن إذا أُديل عليه عدوٌّ من جنس الكفار والمنافقين، أو الفجرة الظالمين؛ وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى، فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق، فيقول: أنا على الحقِّ، وأنا مغلوبٌ، فصاحب الحقِّ في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهور، والدولة فيها للباطل.
فإذا ذُكِّر بما وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين، قال: هذا في الآخرة.
وإذا قيل له: كيف يفعلُ الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه، وأهل الحق؟
فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح قال: يفعل الله في ملكه ما يشاء، ويحكم ما يريد ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء:23].
وإن كان ممن يعلل الأفعال قال: فعل بهم هذا ليعرّضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة وعلوِّ الدرجات، وتوفية الأجر بغير حساب.
سبب الظن السيء ومقدماته
وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنيةٌ على مُقدمتين:
إحداهما: حُسْنُ ظن العبد بنفسه وبدينه، واعتقادُه أنه قائمٌ بما يجبُ عليه، وتارك ما نُهي عنه، واعتقاده في خصمه وعدُوِّه خلاف ذلك، وأنه تارك للمأمور، مرتكب للمحظور، وأنه نَفْسَه أولى بالله ورسوله ودينه منه.
والمقدمة الثانية: اعتقاده أن الله تعالى قد لا يُؤَيِّد صاحب الدين الحق وينْصُره، وقد لا يجعلُ له العاقبة في الدنيا بوجهٍ من الوجوه، بل يعيشُ عمره مظلومًا مقهورًا مُسْتضامًا، مع قيامه بما أُمِرَ به ظاهرًا وباطنًا، وانتهائه عما نُهي عنه باطنًا وظاهرًا، فهو عند نفسه قائمٌ بشرائع الإسلام، وحقائق الإيمان، وهو تحت قَهْر أهل الظلم والفجور والعُدْوان.
فلا إله إلا الله، كم فَسَد بهذا الاغترار من عابدٍ جاهلٍ، ومُتَديِّن لا بصيرة له، ومُنْتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين.
بيان بطلان حسن ظن العبد بنفسه
فأما المقام الأول الذي وقع فيه الغلطُ؛ فإن العبد كثيرًا ما يترك واجبات لا يعلم بها، ولا بوجوبها، فيكون مقصِّرًا في العلم.
وكثيرًا ما يتركُها بعد العلم بها وبوجوبها؛ إمَّا كسلًا وتهاونًا، وإما لنوع تأويل باطل، أو تقليد، أو لظنِّه أنه مشتغلٌ بما هو أوجبُ منها، أو لغير ذلك.
فواجباتُ القلوب أشدُّ وجوبًا من واجبات الأبدانِ، وآكدُ منها، وكأنها ليست من واجبات الدِّين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائلِ والمستحباتِ..!
فتراهُ يتحرَّجُ من ترك فرض، أو من ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهمُّ من واجبات القلوب وأفراضها، ويتحرَّجُ من فعل أدنى المحرَّمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشدُّ تحريمًا وأعظم إثمًا.
بل ما أكثر ما يتعبدُ لله عز وجل بترك ما أوجب عليه؛ فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قُدْرَته عليه، ويزعُمُ أنه مُتقرِّبٌ إلى الله تعالى بذلك، مجتمعٌ على رَبِّه، تاركٌ ما لا يعنيه؛ فهذا من أمْقَتِ الخلق إلى الله تعالى، وأبغضهم إليه، مع ظنِّه أنه قائمٌ بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام، وأنه من خواصِّ أوليائه وحزبه.
والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علمًا وعملًا، لم يضمن نصر الباطل، ولو اعتقد صاحبُه أنه محقٌّ.
وكذلك العِزَّة والعُلوُّ إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رُسُله، وأنزل به كتبه، وهو علمٌ وعملٌ وحالٌ..
قال تعالى: ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139]؛ فللعبد من “العلو” بحسب ما معه من الإيمان.
وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8]؛ فله من “العزة” بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاتَهُ حظٌّ من العلو والعزة، ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان، علمًا وعملًا ظاهرًا وباطنًا.
وكذلك “الدفع عن العبد” هو بحسب إيمانه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: 38]؛ فإذا ضُعف الدفعُ عنه فهو من نَقْصِ إيمانه.
وكذلك “النصرُ” و”التأييدُ الكامل”، إنما هو لأهل الإيمان الكامل؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر:51].
وقال: ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: 14]؛ فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من “النصر” و”التأييد”؛ ولهذا إذا أصيب العبدُ بمصيبة في نفسه أو ماله، أو بإدالة عدُوِّه عليه؛ فإنما هي بذنوبه؛ إما بترك واجبٍ، أو فعل محرم، وهو من نقص إيمانه.
فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جُندٌ من جنود الله، يحفظهم بها، ولا يفرِدُها عنهم ويقتطعها عنهم، فيُبْطلُها عليهم، كما يَتِرُ (يقصد الإبطال وإذهاب الأجر) الكافرين والمنافقين أعمالهم، إذ كانت لغيره، ولم تكن موافقة لأمره.
بيان بطلان سوء ظن العبد بربه
وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلطُ؛ فكثيرٌ من الناس يظنُّ أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذِلاء مقهورين، مغلوبين دائمًا، بخلاف مَن فارقهم إلى سبيل أُخرى، وطاعة أخرى؛ فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده، بل إمَّا أن يجعل ذلك خاصًّا بطائفة دون طائفة، أو بزمان دون زمان، أو يجعله مُعَلقًا بالمشيئة، وإن لم يُصرِّح بها.
وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالى، ومن سوء الفهم في كتابه.
والله سبـحانه قـد بـين في كـتابه أنه ناصـر المـؤمنين في الدنـيا والآخـرة؛ قـال تعـالـى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر:51].
وقــال تعـــالــى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة:56].
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ * كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِ﴾ [المجادلة: 20-21].
وقد بيَّن سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة، أو إدالة عدوٍّ، أو كسرٍ، وغير ذلك فبذنوبه؛ فبيَّن سبحانه في كتابه كلا المقدِّمتين، فإذا جمعت بينهما تبين لك حقيقة الأمر، وزالَ الإشكالُ بالكلية.
أصول نافعة جامعة
وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة؛ منها:
شدة البلاء وخفته
الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذَى دون ما يصيبُ الكفار، والواقعُ شاهد بذلك، وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير.
الأجر لأي الفريقين..؟
الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرونٌ بالرضا والاحتساب، فإن فاتَهُمْ الرضا فمعَوَّلهم على الصبر، وعلى الاحتساب، وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنته؛ فإنهم كلما شاهدوا العِوَض هان عليهم تحمل المشاقِّ والبلاء.
والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، وإن صبروا فكصبر البهائم، وقد نبه تعالى على ذلك في قوله: ﴿وَلا تَهِنُوا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإٍنّهُمْ يَأْلمونَ كَمَا تَأْلمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَالا يَرْجُونَ﴾ [النساء: 104]؛ فاشتركوا في الألم، وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى.
الحَمل والإعانة
الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أُوذيَ في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه، ووجود حقائق الإيمان في قلبه، حتى يحمل عنه مَن الأذَى ما لو كان شيء منه على غيره لعَجز عن حمله.
وهذا مَن دَفع الله عن عبده المؤمن؛ فإنه يدفع عنه كثيرًا من البلاء، وإذا كان لا بدَّ له من شيء منه دَفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعَته.
تأثير المحبة
الأصل الرابع: أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورَسَخت فيه، كان أذى المحبِّ في رضا محبوبه مُسْتحلًى غير مسخوط، والمُحِبُّون يَفتَخِرُون عند أحبابهم بذلك، حتى قال قائلهم:
لئن ساءني أن نِلْتَنِي بمساءَة لقد سَرَّني أني خَطَرْتُ ببالك
فما الظنُّ بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه.
مقدار العز الحاصل
الأصل الخامس: أنَّ ما يصيبُ الكافرَ والفاجرَ والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصلُ للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك ذلٌّ وكسرٌ وهوان، وإن كان في الظاهر بخلافه.
قال الحسنُ رضي الله عنه: «إنهم وإن هَمْلَجت بهم البراذين وطَقطَقَتْ بهم البغال إن ذلّ المعْصِية لفي قلوبهم؛ أبَى الله إلا أن يُذل مَنْ عصاه».
وظيفة ابتلاء المؤمن
الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدَّواء له يَسْتخرجُ منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته، أو نقصَتْ ثوابه، وأنزلت درجته، فيستخرجُ الابتلاءُ والامتحان منه تلك الأدواء ويَستعدُّ به لتمام الأجر وعلوُّ المنزلة.
ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه؛ كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له، وليس ذلك إلا للمؤمن؛ إن أصابته سَرَّاء شكرَ، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضَراء صبر، فكان خيرًا له».
فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته؛ ولهذا كان أشدُّ الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأقرب إليهم فالأقرب؛ يُبتلى المرءُ على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شُدِّد عليه البلاءُ، وإن كان في دينه رِقِّة خُففَ عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يَمشي على وَجه الأرض وليس عليه خطيئة.
لوازم الدار الدنيا
الأصل السابع: أنَّ ما يصيبُ المؤمن في هذه الدار من إدالة عَدُوه عليه، وغلبته له، وأذاه له في بعض الأحيان: أمرٌ لازم لا بدَّ منه، وهو كالحرِّ الشديدِ، والبرْد الشديد، والأمراض والهموم والغموم.
فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال والبهائم، لما اقتضَتْه حكمةُ أحكم الحاكمين؛ فلو تجرَّد الخيرُ في هذا العالم عن الشرِّ، والنفعُ عن الضرِّ، واللذة عن الألم، لكان ذلك عالمًا غير هذا، ونشأة أخرى غير هذه النشأة، وكانت تَفُوتُ الحكمة التي مزَج لأجلها بين الخير والشر، والألم واللذَّة، والنافع والضار.
وإنما يكون تخليصُ هذا من هذا، وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار؛ كما قال تعالى: ﴿لَيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الَخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فى جَهَنّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأنفال:37].
من حكمة إدالة العدو أحيانا
الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم، وكسرهم لهم أحيانًا، فيه حكمةٌ عظيمةٌ لا يعلمها على التَّفْصِيل إلا الله عز وجل.
استخراج عبوديات
فمنها: استخراج عبوديتهم وذُلِّهم لله، وانْكِسارهِمْ، وافتقارِهم إليه، وسؤاله نصرهم على أعدائهم، ولو كانوا دائمًا منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا، ولو كانوا دائمًا مقهورين مغلوبين منصورًا عليهم عدوُّهم لما قامت للدين قائمةٌ، ولا كانت للحق دولة.
فاقتضت حكمةُ أحكم الحاكمين أن صرَّفَهم بين غلبهم تارةً، وكونهم مغلوبين تارةً؛ فإذا غُلِبُوا تَضَرَّعُوا إلى ربهم، وأنابوا إليه، وخضعوا له، وانكسروا له، وتابوا إليه، وإذا غَلبُوا أقاموا دينه وشعائره، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وجاهدوا عدوَّه، ونصروا أولياءه.
طروّ آفات لو اطردت أحد الحالَيْن
ومنها: أنهم لو كانوا دائمًا منصورين، غالبين، قاهرين، لدخل معهم من ليس قصده الدِّين ومتابعة الرسول؛ فإنه إنما ينضافُ إلى مَن له الغلبة والعزَّة.
ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا لم يدخل معهم أحدٌ.
فاقتضت الحكمة الإلهية أنْ كانت لهم الدولة تارةً، وعليهم تارة، فيتميز بذلك بين مَن يريد الله ورسوله، ومَن ليس له مرادٌ إلا الدنيا والجاه.
تكملة العبودية في الحاليْن
ومنها: أنه سبحانه يُحِبُّ من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء، وفي حال العافية والبلاء، وفي حال إدالتِهم والإدالة عليهم.
فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبوديةٌ بمقتضى تلك الحال لا تحصلُ إلا بها، ولا يستقيم القلب بدونها؛ كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحرِّ والبرد، والجوع والعطش، والتعب والنصب، وأضدادها.
فتلك المحن والبلايا شرطٌ في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنعٌ.
ومنها: أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم، ويخلصهم، ويهذّبهم؛ كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أُحد:
﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ ندَاوِلهُاَ بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمينَ وَلِيمُحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَق الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّونَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرونَ وَمَا مُحمَّد إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ منْ قَبْلِهِ الرُّسُل أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئا وَسَيَجْزِى اللهُ الشّاكِرِينَ﴾ [آل عمران:139-141]. (1إغاثة اللهفان: (2/ ص176-194)، بتصرف يسير)
خاتمة
هذا بعض ما ساق الإمام ابن القيم رحمه الله من الحقائق الشرعية والقدرية، وبعض ما تلمس من الحكمة المنصوص عليها في القرآن، والمشاهَدة بعين الاعتبار والاستقراء.
وهو مما يفيد المؤمن بصيرة وعلما، وثباتا ويقينا، والله الهادي الى صراط مستقيم.
………………………………
هوامش:
- إغاثة اللهفان: (2/ ص176-194)، بتصرف يسير.