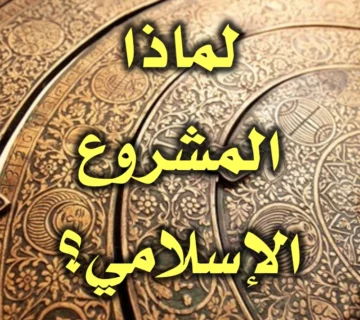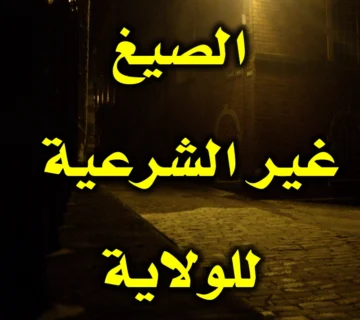يسعى هذا الطرح إلى تجاوز الثنائية الحادة في الخطاب الإسلامي بين مثالية شريعة منفصلة عن الواقع وواقعية تنازلية تهمّش الشريعة، وذلك بالسعي لبناء خطاب سياسي شرعي متوازن يجيب عن سؤال “كيف نتعامل مع ما هو كائن” وليس فقط “ما ينبغي أن يكون”..
السياسة الشرعية بين المثالية والواقعية: نحو خطاب توازني
هذه مقالةٌ على شكل أسئلة وأجوبة أكتبها لبيان ما أراه في أهم أبواب السياسة الشرعية المعاصرة. وصُلب هذا الطرح هو الحفاظ على حالة التوازن بين خطاب الشريعة وخطاب السياسة، دون التركيز على واحد منهما مع تجاهل الآخر كما يحدث غالبًا، فعلينا الخروج من هذه الثنائية النكدة التي تحصر الأمة بين التصعيد غير المحسوب والتنازل المفرط بدعوى الواقعية. كما علينا تجاوز التركيز على سؤال: “ما ينبغي أن يكون” لنعالج أيضًا الإجابة عن سؤال: “كيف نتعامل مع ما هو كائن”.
ولأنّ كثيرًا ممّن يسمع مفردات “حاكمية الشريعة” و”السياسة الشرعية” يظنّ أنّه سيقابل خطابًا مثاليّا صداميّا يريد تغيير العالم دون فهمه، أو شعاراتٍ بلا رصيد من الفهم السياسي الواقعي. ولقد عزّز هذا التصوّر أنّ هناك خطابين يتنازعان الخطابَ الإسلامي المعاصر في الغالب: خطاب ينطلق من الشريعة لكنْ برؤية مثالية تتحدّث عن الواجب فعله فحسب، لكنّها تتجاهل تفاصيل الواقع وتعقيداته ولا تقدّم حلولًا، وخطاب يتخلّى عن رؤية مفردات الواقع انطلاقًا من الشريعة، ويتبنّى المفاهيم الغربية الشائعة في مساعيه الإصلاحية كالمواطنة والمساواة والديمقراطية وغيرها، فيكون بذلك قد تنازل عن الشريعة وإنْ تمسّك بها على مستوى الشعارات.
من أجل ذلك أحببت كتابة هذا البيان للتأكيد على وجود “طريق ثالث” إنْ جاز التعبير، طريق متوازن لا يفرّط بالشريعة ولا يُهدر فهم الواقع ومراعاته.
هل تعني السياسة الشرعية تطبيق أحكام الشريعة فقط؟
كلّا، بل تتضمّن كلّ إجراء سياسي يسعى إلى حماية مصالح الأمة وتجنيبها المفاسد بما تقدّره النخبة السياسية دون مصادمة قيم الشريعة ومبادئها وأحكامها، حتى لو لم يرد في نصوص الشريعة وفتاوى الفقهاء.
هل يجب على الدولة المسلمة إعلان تطبيق الشريعة بشكل كامل منذ لحظة الإمساك بالحكم؟
كلّا، بل تقيم من الدين ما تستطيع، ويدخل في اعتبار الاستطاعة النظر في مآلات الأفعال وما تشكّله من خطورة على المشروع وحالة المجتمع، لكن لا تؤجل ذلك إلى يوم الدين بحجة عدم جاهزية المجتمع والضغط الدولي، ولا تتبنّى المفاهيم المخالفة للشريعة في أبواب السياسة والمجتمع وتعزّزها بحجّة مسايرة الواقع، بل تسعى إلى بثّ روح الشريعة وحبّها وفهمها والعمل بها في المجتمع من خلال الدعاة والمفكّرين والمربّين، وتعمل في الوقت نفسه على تجاوز العوائق الداخلية والخارجية، عبر تأهيل المجتمع أو شريحة كافية منه وتحقيق تماسكه، وعبر تحصيل عناصر قوة الدولة التي تحميها من الإملاءات الخارجية وسهولة إسقاط التجربة، وأساسها بناء قاعدة صناعية تقنية متقدّمة تشكّل أرضية لبناء قوة عسكرية رادعة، وعبر عقد التحالفات، وتقيم مع الوقت ما تستطيعه من أحكام الشرع دون تلكّؤ أو إهمال لقضية الشريعة، سواء عبر تأهيل الكوادر وتوفير الرؤى والاجتهادات المعاصرة وغير ذلك.
الخلاصة: عليك تحقيق “الممكنات المرحلية” مع إبقاء “المبادئ الاستراتيجية” بوصلةً لا تغيب، لا أن تعلن المبادئ الاستراتيجية من البداية دون أن تتمكن من تحقيق شيء، لا المبادئ الاستراتيجية ولا الممكنات المرحلية!
كما أنّ فكرة “الإعلان” ليست واجبًا شرعيًا، عليك أن تقيم الشريعة لا أن تعلن عن إقامتها. ولكن أيضًا: لا تزعم إذا أقمتَ سياسة بشرية مصلحية تصفها بالعدل أنك أقمت الشريعة، فالشريعة تقام بتطبيق أحكامها الجزئية المفصّلة في الكتاب والسنّة وما حُمل عليهما بطرق الاجتهاد المنضبطة بأصول الفقه.
هل يجوز للدولة الاعتراف بحدود الدولة القطرية وتقسيمات الاستعمار؟
هذه التقسيمات ليست شرعية وقد فرّقت الأمة، ولا يجوز للدولة ارتكاب أي خطاب يعززها ويضفي عليها رمزية وقداسة تحت شعارات الوطنية وتراب الوطن وما شابه، لكن تتعامل مع الأمر الواقع وترفض أي تقسيم إضافي لها وتحكم القُطر الذي في حوزتها كاملًا لأنه المستطاع وليس لأنه التراب الوطني الخاص بشعبها المخترَع. وهذه السلطة التي في أحد أقطار المسلمين ليست خلافة جامعة ولا تملك حقوق الخليفة الجامع للأمة، ومن ثمّ فليس من الواجب على جميع المسلمين مبايعتها حتى لو أقامت الشريعة، لكن هذا لا يعفيها من إقامة الشرع بكل ما تستطيعه والتعاون مع سائر قوى الأمة لتحقيق شكل معاصر يستوفي صفات الخلافة الجامعة للأمة.
كيف تتعامل الدولة مع الدول المحيطة والقوى الإقليمية؟
التفريق بين من يريد سلخك عن الإسلام وقيمه وأحكامه ومن يحب الدين ولديه أواصر الأمّة الواحدة معك لكن لديه مزيج من العجز البنيوي عن إقامة الدين والفهم الخاطئ له وخلطه بمفاهيم الليبرالية والعلمانية، وبين من يريدك ضعيفًا تابعًا ومن يريدك قويًا تسنده ويسندك، وبين مَن تتعارض معظم مصالحه مع مصالحك ومصالح أمتك ومَن تتلاقى معظم مصالحه مع مصالحك ومصالح أمتك. ومن ثمّ العمل بناءً على هذا التفريق، لا رمي الجميع عن قوس واحدة!
تقديم مصلحة الأمة التي تحكمها والأمة الإسلامية عمومًا على مصلحة أفراد السلطة الحاكمة، فمن يتصدى لسياسة المسلمين إذا كان تصديه من باب حفظ مصالح الأمة وعدم إضاعة الفرصة، فالواجب أن يستمر بهذه الروح وألا تتحول السلطة إلى مكاسب شخصية أو أسريّة أو حزبية يقدّم التنازلات للحفاظ عليها.
عدم ارتكاب خطيئة التعجّل؛ سواء التعجّل في إعلان المواقف والخصومات واتخاذ القرارات السياسية الحاسمة قبل استكمال بناء قوة الدولة والمجتمع، أو التعجّل في الانتعاش الاقتصادي ورفع العقوبات عبر الاستسلام التام لمنظومة الوحوش الاستثمارية الرأسمالية الدولية والإقليمية وتقديم تنازلات باهظة في سبيل التعجيل في هذا الانتعاش، فكلا التوجُّهين يؤديان إلى ضياع المشروع والدولة إما بتعجيل الصدام بلا جاهزية، وإما باجتياح الدولة بالقوى الاقتصادية الدولية التي تفرض شروطها السياسية وتجعل الدولة تابعة وعاجزة عن بناء مشروعها المستقلّ.
التعامل مع الحكومات العربية (حتى تلك العلمانية الفاسدة والمتآمرة على الأمة) هو من باب أنّ البلدان التي تحكمها هي جزء من مقدّرات الأمة ومن الفضاء الإسلامي والعربي الذي يجب الانفتاح عليه والتقارب معه. وهذه الحكومات تملك هذه المقدرات وتهيمن على هذا الفضاء ولا بدّ من التعامل معها، سواء على مستوى الاقتصاد أو السياسة والدبلوماسية أو غير ذلك، لكن دون الارتهان لها وإعطائها اليد العليا وتقديم التنازلات في سبيل تلقي اعترافها ودعمها.
الصواب عدم البدء بإعلان معاداة أحد والتعامل معها بندّية وحذر ومعرفة خارطة المصالح المشتركة للعب عليها بثقة، دون الانجراف إلى مستنقع الابتزاز والارتهان لرغباتها. والتعاطي معها من منظور الانفتاح على الأمة التي تحكمها أكثر من أن يكون من منظور التقارب مع الطُّغمة الحاكمة وأفكارها وارتباطاتها.
هل يجوز الانخراط في النظام الدولي؟ وما هي ضوابط التعامل معه؟
النظام الدولي الأمريكي حالة هيمنة مفروضة ينبغي التعامل معها بحذر، مع تفعيل كل القنوات الدبلوماسية والتفاوضية الذكية معه، وعقد التحالفات مع بعض القوى الإقليمية والدولية الملائمة، وعدم الانغلاق تمامًا لتجنيب الأمة عدوان النظام الدولي وتدخّلاته المجحفة قدر الإمكان. وهذا لا يكون برفع شعارات “الموت لأمريكا” بل بتغليب مضامين الإسلام التبشيرية ومفاهيم “السلام العالمي” و”إنقاذ الحياة الإنسانية” والدعوة إلى الخير العام والبرّ الذي تتضمّنه قيم الإسلام وأحكامه وغيرها من المركزيات الكبرى التي جاء الإسلام لأجلها في خطاب الدولة الخارجي.
وفي سياق النظام الدولي هناك نقطة مركزية تغيب عن خاطر كثير من الإسلاميين، وهي أنّ هناك متغيّرين أساسيّين لم يكونا في عهد النبوة:
الأول: وجود نظام دولي مترابط سريع الوصول والهيمنة بسبب أدوات التقنية الحديثة المتنوعة كالطيران وغيره، وقادر على فرض حصار اقتصادي لارتباط اقتصاد جميع الدول بهذا الاقتصاد العالمي بشكل كبير كما لم يكن قبل العصر الحديث.
والثاني: أنّ الفجوة التقنية والعسكرية اليوم ضخمة جدًا بالمقارنة مع الفجوة التي كانت بين المسلمين وبين الروم أو الفرس من جهة أخرى، فلم تكن الهوّة بهذه الضخامة في معظم عصور المسلمين، مما يستدعي بناء سياسات جديدة تتلاءم مع ذلك، فلا يجوز الركون فقط إلى قوله تعالى: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ} دون تفعيل سائر قيم الإسلام، فإذا كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى الذين يقولون “ذَرْنا نتَّخذ مَعَاول فنُقاتل بها المشركين بمكة” عن قتال مشركي مكّة في مرحلة الاستضعاف، فكيف والهوّة اليوم بين أي قُطر مسلم وبين النظام العالمي ودوله الكبرى وأدواته أكبر بما لا يقاس كمًّا وكيفًا؟!
وهنا تكون النجاة في الحفاظ على المكتسبات القيمية والمادية، مع التمسّك بالخطاب المستند إلى الشريعة، والعمل على بناء المجتمع والدولة ومراكمة عناصر القوة لكن دون التعجّل في المواجهة. وهذا يختلف عن الانخراط في النظام الدولي من باب الأمر الواقع دون وجود أي مشروع أو رؤية لكيفية الخروج من هيمنته أو التخفيف منها تدريجيا، مع الخضوع لإملاءاته والدخول في مساراته وتوصياته المظلمة.
ومن المهم في هذا الباب الاستناد في التعامل مع النظام الدولي إلى مراكز دراسات وتوسيع دائرة التشاور والأخذ برأي نخب المجتمع، وعدم اتخاذ قرارات الانخراط في موقف أو علاقة دولية بشكل شخصي، فما يغيب عن الفرد من مخاطر تدركه دراسات المتخصصين والتفكير الجماعي وتفعيل الشورى.
هل يُسوّغ خوفُ إسقاط التجربة الخضوعَ لإملاءات النظام الدولي؟
ينبغي التفريق بين السياسات التي قد تجعل النظام الدولي غير راضٍ ولكنه لا يُقْدم بسببها على إسقاطك، وبين السياسات والمواقف والإجراءات التي قد تجعله يتخذ قرار شنّ حرب شاملة عليك لإسقاطك، فليست كل السياسات شيئًا واحدًا، ومجرّد الخوف من بعض العقوبات لا يسوّغ التماهي التام مع النظام الدولي والخضوع لجميع إملاءاته.
في النهاية أنت أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا أن تمضي في بناء مشروع حضاري مغاير للنظام الدولي حتى ولو تدريجيّا، وهذا سيجعلك تمرّ بمصاعب بلا شكّ، أو تتنازل عن أي مشروع حضاري مغاير وتتماهى مع النظام الدولي قلبًا وقالبًا، وحينها قد تتوهّم أنّك لن تمرّ بمصاعب، لكن الواقع أنّك إذا كنت باعتبارك السلطة ستعيش فترة سلام، فإنّ أمّتك التي أنت مسؤول عنها ستعاني من تمرير المشاريع الدولية عليها بكل قذارتها، ابتداءً بباب القيم والثقافة والاستهلاك، وصولًا إلى فقدان هذه الأمة لمقدّراتها المادية وحقوقها في بلادها، لأنّ النظام الدولي الحالي هو عبارة عن مشروع هيمنة أمريكي، شكل جديد من أشكال الاستعمار والهيمنة وسرقة مقدّرات الأمم، لكن بطرق دبلوماسية أكثر لباقة من المشاريع الأوروبية في القرنين الماضيين!
ما النموذج الاقتصادي الأفضل الذي يجب أن تتخذه الدولة؟
لا توجد وصفة جاهزة، لكن هناك خطوط عريضة أهمّها السعي إلى الاستقلال الاقتصادي واستغلال كل موارد الدولة لتأسيس غطاء إنتاجي يعوّض عن فقدان العملة الصعبة والذهب، والابتعاد عن الغرق في القروض الربوية الدولية التي أفلح من رفضها من دول العالم غير المسلم، فما بالك بالمسلم الذي يدرك مغبّة التعاطي بالربا!
وينبغي للدولة تجنّب الغرق في اقتصاد السوق الحرّ، وتوجيه الاقتصاد لما يصبّ في مصلحة الأمة وبناء قوة الدولة، وتنويع موارده بين زراعة وصناعة وغير ذلك. وهنا أيضًا تنبغي الموازنة بين الانفتاح على التجارة العالمية وعدم الانغلاق على الذات، وبين وضع حدود وضوابط للسوق والاستثمار لحماية اقتصاد الدولة والمجتمع.
ولا يمكن أن تقوم قائمة لأي دولة إذا كان اقتصادها كله ريعيًّا أو قائمًا على الاستثمارات الأجنبية دون الشروع في بناء قاعدة صناعية في مختلف المجالات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وصناعة القوة، فكل اقتصاد لا ينخرط في ذلك سيُبقي الدولة في حالة ضعف وتبعية مع تلاعب القوى الإقليمية والدولية بها.
وعلى الدولة أن تبذل كل المستطاع بالتعاون مع غيرها من القوى المسلمة لتفعيل قيم الشريعة وأحكامها في الاقتصاد والأموال، فمع صعوبة الخروج من إملاءات النظام الاقتصادي العالمي وربطه بالدولار الأمريكي ينبغي السعي إلى التحرّر من هذه الإملاءات ولو تدريجيّا، ولا يكون ذلك بالانفراد بل باجتماع قوى الأمة، وهو ما يؤكّد ضرورة السعي إلى بناء القوة السياسية الجامعة (الخلافة)، فلا يمكن إقامة الشريعة كما يرضى الله بغير هذا البناء.
كيف تتعامل الدولة مع المجتمع؟ هل وظيفتها الإدارة والخدمات فحسب؟
هنا أيضًا تجب الموازنة بين “الخطاب التعبوي” الذي يفتقد إلى الأسس، وبين خطاب “إدارة الدولة وتقديم الخدمات” فحسب، فالمطلوب ليس تحول الدولة إلى مصنع بيانات ثورية ترهق المجتمع الذي يفتقد إلى كثير من أسس الحياة، لكن من جهة أخرى لا ينبغي للدولة أن تتحوّل إلى مجرّد أداة لتقديم الخدمات وإدارة مختلف القطاعات الحيوية دون أن يكون لها دور في صناعة الرأي العام الداخلي عبر وسائل الإعلام ونظام التعليم وغير ذلك، وكثيرًا ما يغفل الإسلاميون الذين يصلون إلى الحكم هذا الباب، خوفًا من وصمهم بأسلمة الدولة أو لافتقادهم المشروع والرسالة الحقيقية، فيكتفون بتقديم الخدمات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية!
وهنا لا أقصد أن تتحوّل الدولة إلى مصدر المعرفة والحقيقة الوحيد، بل أن يكون لها دور مركزي في بناء المجتمع وجعله أقرب لخصائص المجتمع المسلم الصابر المرتبط بالله والآخرة، الذي يهمّه دينه وقيَمه أكثر من دنياه، وهذا من جملة واجب “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وهو جزء من تطبيق الشريعة، وفقدانه يعوّد المجتمع المخترَق بالغايات الدنيوية على نمط أكثر دنيوية؛ لأنّ الدولة قدّمت نفسها جهازًا للإدارة والخدمات وتحقيق فرص العمل والانتعاش الاقتصادي، أي ركّزت على الجانب الدنيوي دون الجانب الديني والأخروي.
كيف تتعامل الدولة مع الأقليات الدينية غير المسلمة؟
لا شكّ أنّ من واجبات الدولة الاهتمام بتحقيق مبادئ التسامح الإسلامي مع الأقليات الدينية الأخرى، خصوصًا إذا كانت مندمجة في المجتمع ولم تتكتّل لتشكّل كيانات انفصالية معادية للأمة، تلك المبادئ التي وجدناها في عصر النبوة والخلافة الراشدة، فلا تمارس الدولة خطابَ الاضطهاد ضدّ تلك الأقليّات، بل هي أَولى باحتوائها من القوى الخارجية المتربّصة لتأليبها، وسياسة الاحتواء دون تقديم تنازلات مع الأقليات الدينية هي أفضل طريقة لتجاوز خطر تأليبها أو التدخّل بحجّة حمايتها، ومعظم تجارب البطش والقهر أثبتت أنها تجارب فاشلة في تجاوز هذا الخطر، بل هي تحفّزه وتثيره.
هل تسمح الدولة بنشأة الأحزاب والأُطر السياسية؟
من أهم واجبات الدولة توفير فرص إقامة الحراك السياسي المجتمعي عبر مختلف الأُطر من تنظيمات وأحزاب ونقابات وتجمّعات ثقافية وغير ذلك، إلى جانب مشاركة هذه الأُطر في مؤسسات الحكم لتحقيق مشاركة الأمة في السلطة عبر المجالس المختلفة كالرقابية وغيرها. والمقصود بشكل أساسي تلك الأُطر التي تتخذ الإسلام منطلقًا أساسيا لها للحفاظ على هوية الدولة الإسلامية حتى وإنْ لم تكن تابعة للسلطة أو الحزب الحاكم، فهذا يعزز من قوة المجتمع وقدرته على الحفاظ على المشروع وتمسّكه به وحسم هوية الدولة، إذ لن يكون الأمر خاصًّا بجماعة إسلامية أو حزب أو تنظيم حاكم بل بأمّة، وتساعد أيضًا في تأهيل المجتمع وتقويته لأنّ الدولة لن تتمكن وحدها من سدّ الفجوات القيمية والفكرية والتربوية في المجتمع الواسع.
كما أنّها تساعد في توليد الجوّ المضادّ للاستبداد بالسلطة من قبل فئة ما، فهذه الأُطر جميعها وما تمثّله من شرائح المجتمع ونخبه وقادته تحقق مفهوم “الجماعة” التي خوطبت في كتاب الله عزّ وجلّ كثيرا، وكانت موجودة في عهد الخلافة الراشدة لنُصح السلطة وتقويمها والأخذ على يدها إن أخطأتْ وإعانتها في المعروف. والمجتمع اليقظ القويّ يعني وجود دولة قوية، أما الاستبداد واستئثار حزب واحد أو أسرة أو جماعة بمفاصل السلطة فهو إضعاف للمجتمع ومدخل لاختراق الدولة وإدخالها في التبعية للقوى الإقليمية والدولية.
هل سيحكم الدولة رجالُ الدين وهل ستصبح دولة “ثيوقراطية”؟
لا وجود لمصطلح “رجال الدين” في الإسلام، بل هناك علماء فقهاء ومتخصصون في مختلف المجالات الشرعية، وكلّما كانت المعرفة الشرعية أكبر عند النخب الحاكمة – إلى جانب الخبرة السياسية والمعرفة بالواقع ومختلف المجالات – كان ذلك في مصلحة الدولة، فالشريعة ضياء ونور، وهؤلاء لا يحكمون بقداسة دينية لأشخاصهم ولا يزعمون أنّهم ملهَمون من الله عزّ وجلّ، بل يحاولون بدعمٍ من أمّتهم تطبيقَ سياسة راشدة تُرضي الله تعالى وتحقّق مصالح الأمة.
كما أنّ للعلماء وظيفة مهمة ومركزية في بناء الدولة، إذ لا ينبغي أن يكونوا مجرّد مؤسسة في يد السلطة تستخدمها لإضفاء الشرعية على قراراتها وإجراءاتها، حتى وإنْ شغل بعضهم وظائف في الدولة كالقضاء وغير ذلك، بل ينبغي لهم الاستقلال عن السلطات السياسية المتعاقبة، وتكوين مجلس أو مؤسسة مستقلّة لأهل العلم غير تابعة للسلطة وظيفتها ترشيد السلطة. وكلما كانت مؤسسة العلماء أكثر تمثيلًا للمشارب الشرعية الاجتهادية المتنوّعة في البلاد وابتعادًا عن المال السياسي؛ كان أثرها أكبر وفي صالح الأمة ومنع تغوّل السلطة أو وقوعها في قبضة الخارج. ففي الوقت الذي يظنّ فيه بعض الناس أن قوّة أهل العلم الشرعي ستحوّل الدولة إلى استبداد ديني، فإنّ الطبيعة السنّية للمدارس العلمية الشرعية تجعل قوّة أهل العلم المستقلّين في صالح الأمة وتحرّرها من تغوّل السلطة.
وبعد، فهذه بعض أبرز ملامح أي مشروع سياسي إسلامي يرجو بناء دولة، وأحسب أنّ من أعظم ما يهدد المشاريع الإسلامية المعاصرة الانقسام بين خطاب مثالي حالم يغيب عنه فقه الواقع وكيفية التعامل معه، وخطاب متماهٍ مع الواقع الفاسد بذريعة الواقعية السياسية مع فقدان الرؤية والمشروع والثوابت.
المصدر
موقع غراس، أ. شريف محمد جابر.
اقرأ أيضا
الخطاب الديني والخطاب السياسي (1)
الخطاب الديني والخطاب السياسي (2)