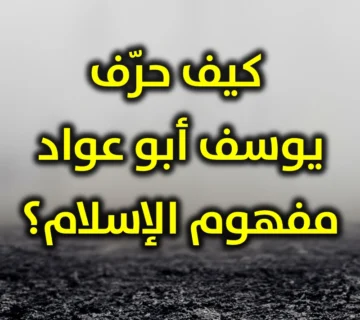يوسف أبو عواد: امتداد لمنهج شحرور في الانزياح عن المعاني الشرعية
يوسف أبو عواد وجه جديد التُقِط وصُدّر للناس اليوم باعتباره خليفة لشحرور ومنهجه المبني كما يزعم على تتبع الجذر اللساني للألفاظ القرآنية، ومحاولة العثور على دلالات جديدة للخروج عن المعنى الشرعي الواضح المتعارف عليه لتلك الألفاظ.
الاشتقاق الأصيل: تجربتي الشخصية مع منهجية المعاجم والتفسير
في الواقع أنا عاشق للاشتقاق، ومعجم “المقاييس” لابن فارس في مكتبتي منذ عشرين عامًا، وقد أدمنت المطالعة فيه بشكل شبه يومي حتى يومنا هذا. وأنجزت أطروحة الماجستير في أحد المفسّرين الاشتقاقيين الكبار وهو الحكيم الترمذي، الذي له فضل كبير عليّ في الكشف عن أهمية معرفة معاني الألفاظ المعجمية الاشتقاقية، فهي ترسّخ المعنى القطعي المتّفق عليه للألفاظ الشرعية بين علماء الأمة، وتجعله يدخل في مساحة أعمق من الفهم والشعور ممّا يعين المسلم على التفاعل مع كتاب الله تعالى والاستجابة إلى خطابه.
الانزياح المقصود: محاولة مسايرة العصر العلماني
أما ما يفعله شحرور ومن بعده يوسف أبو عواد فهو تكلّفٌ ممجوج، تظهر فيه بوضوح الرغبة في مسايرة مزاج العصر العلماني الذي نعيشه؛ فـ {النساء والبنين} عند شحرور هما “الموضة” و”المباني”، لأنّ لديه رغبة واضحة في عدم “تشييء” المرأة والأطفال بوضعهما مع ما زُيّن للناس من الدوابّ والذهب والفضّة، فهذا لا يليق في مزاج الحضارة الغربية المعاصرة!
أمثلة على التحريف: اختزال الإسلام والمؤمن وبني إسرائيل
والإسلام عند يوسف أبو عواد وصف سلوكي معناه “كفّ الشرّ”، وليس شأنًا اعتقاديّا دينيّا مرتبطًا بالتوحيد واتّباع شريعة الرسول محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وهو مرتبط بالسِّلم المجتمعي ويمكن أن يوصف به أي مجتمع غربي أو شرقي أقام “السِّلم” حتى لو لم يكن مسلمًا ولم يتلفّظ أفراده بالشهادتين أصلا!
أما “المؤمن” عنده فهو من تأمنه على مالك وعيالك! وهذا ينسجم مع النزعة الإنسانية المعاصرة التي ترى الإنسانية أمة واحدة ولا ينبغي التفريق بين البشر بحسب الدين والمعتقد. وبنو إسرائيل عند يوسف أبو عواد ليسوا قومًا مخصّصين من ذرية نبيّ الله يعقوب عليه السلام، بل هم كل البشر الذين بقوا على الأرض بعد نوح، وهم الذين “أسْرَوا إلى الله”، أي هم من آمنوا برسالة الأنبياء واتبعوها وما زالوا في مرحلة الإسراء، أي نشر المبدأ ليعرفه كل المجتمع الإنساني (لاحظ التكلّف!)، وذلك لنفي اختصاص الإسلام عن الرسالات السابقة بالعالمية، وليمزج لاحقًا بين الإسلام وغيره من الأديان المحرّفة ضمن الديانة الإبراهيمية الجديدة، بل نصبح بحسب كلامه من “بني إسرائيل”!
إشكاليات المنهج التحريفي
المشكلة الأولى: التعسير في موضع التيسير
– مشكلة هذا التناول الأولى أنّه يُشْبه قول العوام “هذه أذني” مع مدّ اليد اليمنى حول العنق من الخلف لتمر من خلف الأذن اليسرى ثم تلامس الأذن اليمنى، بدلا من لمس الأذن اليمنى مباشرة من الطريق الميسّر! فالله عزّ وجلّ يسّر القرآن للذكر والفهم كما أخبرنا في كتابه: {فإنّما يسّرناه بلسانك لعلّهم يتذكّرون}، {ولقد يسّرنا القرآنَ للذكر فهل من مدّكِر}، ومن غير المعقول أن تخفى هذه المعاني المركزية التي يردّدها شحرور وأبو عواد بموثوقية وهم يعانون في شرحها وإيصالها بطريقة متكلّفة ممجوجة!
المشكلة الثانية: اللغة تُفْضح التكلُّف والالتواء
– ومشكلته الثانية أنّ اللغة نفسها لا تُسعفهم بل تفضحهم، فلماذا يعبّر الله عن الذين آمنوا واتبعوا الرسالة بهذا التعبير الملتبس؟ وحتى لو أراد أن يقول إنهم “الذين أسروا” فلماذا قال “بنو إسرائيل” بإضافة البنوّة إلى شخص ولم يقل ببساطة “الذين أسروا”؟ هل يتعمّد الله – حاشاه سبحانه – تصعيب الأمر على القارئ؟ (دعْ عنك أنه اسم علَم مركّب لا يُشتق). ولو أراد من النساء شيئا مشتقّا من النسيئة أي الأمور المتأخرة أي “الموضة” كما يزعم شحرور، فلِمَ يصفها بكلمة يعرف الناس اختصاصها بجنس المرأة (النساء) بل ينضبط سياق مجيئها بالحديث عن المرأة؟ ألهذا الحدّ يصبح القرآن ألغازًا تحتاج إلى 1400 عام حتى يكتشفها أحدهم وقد سبقه جهابذةٌ من العلماء هُم أحسن منه عُدّةً في اللسان بما لا يقاس؟!
المشكلة الثالثة: تفسير القرآن بالقرآن يُبطل التأويل
– ومشكلته الثالثة أننا لو فسّرنا القرآن بالقرآن، فنظرنا إلى ألفاظ “الإسلام” و”بنو إسرائيل” و”النساء” وغيرها في الآيات الأخرى التي جاءت فيها سنجد تثبيت المعنى الذي أجمعتْ عليه الأمة، بأنّ “الإسلام” في سياق الرسالات كلّها هو إسلام الوجه لله أي التوحيد أي إفراده بالعبادة، وفي سياق الرسالة المحمّدية يتضمّن إلى جانب ذلك اتباع الشريعة الناسخة لِما قبلها والتي نزلت على محمّد صلى الله عليه وسلّم. وبأنّ “النساء” هم ما نعرف من جنس المرأة. وبأنّ “بني إسرائيل” هم قوم مخصوصون (وليسوا كل البشر بعد نوح) أكثرَ القرآن من ذكر سيرتهم وأخبارهم الخاصة وليسوا “صفة” كما زعم يوسف أبو عواد، وهكذا يكون جمع الآيات إلى بعضها مبيِّنا لمعاني هذه الألفاظ وفاضحًا لتأويلاتهم السقيمة.
وانظر مثلا إلى مصطلح “بني إسرائيل”، فقد كانوا “بني إسرائيل” قبل رسالة عيسى: {ورسولًا إلى بني إسرائيل}، بل حين ثبت كفرهم برسالته لم يُسمَّ أتباع عيسى “بني إسرائيل”، أي الذين أَسروا إلى الله واتبعوا الرسالة، بل سمّاهم “أنصار الله” و”المسلمين” كما قال تعالى بعد آيات قليلة: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ} أي من بني إسرائيل {الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}. وظلّوا “بني إسرائيل” بعد كفرهم بل لُعنوا، فهل يُلعن من هو مؤمن “أسرى إلى الله”: {لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل}، وهل يُدعى إلى التوحيد من آمن وأسرى إلى الله: {يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربّي وربّكم}!
ويقول تعالى لنبيّه محمّد صلى الله عليه وسلّم: {سَلْ بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيّنة}، فلو كانت تسمية بني إسرائيل “مرحلة الإسراء ونشر المبدأ” كما يزعم يوسف أبو عوّاد، فكيف يسمّى هؤلاء المنكرون للرسالة المحمّدية بنو إسرائيل؟! وسمّاهم الله تعالى “قومًا” في كتابه: {وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعَفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمت ربّك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا}، وذكر أنّهم من ذريّة نبيّ الله “إسرائيل” الذي ذكره مع الأنبياء {أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيّين من ذريّة آدم وممّن حملنا مع نوح ومن ذريّة إبراهيم وإسرائيل وممّن هدَيْنا واجتبينا}، وذكرهم مع اسم أبيهم منفردًا ليؤكّد أنّ التركيب عائد إليه: {كلّ الطعام كان حِلًّا لبني إسرائيل إلّا ما حرّم إسرائيلُ على نفسه}، فكيف يقال بعد كل ذلك إنّ بني إسرائيل ليسوا قومًا مخصّصين فيضمّ يوسف أبو عواد إليهم كل البشر بعد نوح بل يضمّ إليهم قبائل العرب! ويجعلهم “الذين أسروا إلى الله” أو المؤمنين في “مرحلة الإسراء”؟! هذا في الواقع تكذيب للقرآن! وبهذا يظهر تهافت تأويله عند جمع الآيات التي ذُكر فيها المصطلح، والأمر ذاته ينطبق على معظم تأويلاته لمصطلحات خرج فيها عن المعروف في الشريعة.
المشكلة الرابعة: إغفال السياق التاريخي والنقلي المتصل
– ومشكلته رابعًا أنّ هذا القرآن ليس كتابًا مجهولًا عُثر عليه صدفةً في إحدى الصحاري وعُثر بجانبه على معجم “المقاييس” حتى نعاني في الكشف عن معانيه! بل أزعم أنه لو كان كذلك لبقيت تأويلاتهم متكلَّفة ممجوجة! ولكنّ القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلّم الذي علّمه بنصّ القرآن للمؤمنين من الصحابة الذين صحبوه وعاشوا أحداث القرآن وتحدّثوا بلسان القرآن، وهم جيل منتصرٌ حيّ، نقلَ معارفه حول القرآن إلى الجيل الذي تلاه من التابعين وصولا إلى الأجيال الحالية. بل بدأ تدوين معاني القرآن مبكّرا في القرن الأول وازداد في الثاني والثالث. ففَهْمُ القرآن سياقٌ مجتمعي متّصل، إذ لم تنقطع الأمة يومًا عن ممارسة دينها، ولا يمكن إغفال هذا السياق المجتمعي المتّصل وشطبه كأنْ لم يكن ثم نفسّر القرآن كما فسّر خبراء الآثار اللغة الهيروغليفية بواسطة حَجَر رشيد!
منهج شحرور وأبو عواد: هدم للثوابت تحت ستار التجديد
وهناك مشكلات أخرى، لكن أكتفي بهذه الأربع لهدم هذه التأويلات السقيمة التي تهدف كما بيّنتُ إلى مسايرة أمزجة علمانية وليبرالية معاصرة لا أكثر، بشكل مفضوح لمن يتتبّع مآلات خطاب هؤلاء، بل تظهر دوافعهم أحيانًا في لحن القول، كما كان شحرور يقول حين يختم تأويله التحريفي: وهذا مطبَّق في الدول المتقدّمة اليوم!
المصدر
صفحة الأستاذ شريف محمد جابر، على منصة ميتا.
اقرأ أيضا
كيف حرّف يوسف أبو عواد مفهوم الإسلام؟