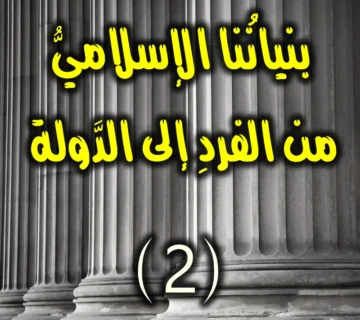دعوة الإسلام ليست ترقيعا جزئيا، بل هي إصلاح شامل وتغيير عميق، تبدأ بالنفس والنفس تبدأ بالعقيدة، ويتم الإصلاح الفردي؛ فيعقبه تغيير جماعي عام.
دعوة الإصلاح والتغيير
إن الدعوة الإسلامية التي حمل لواءها خاتم الأنبياء، صلى الله عليه وسلم، لم تكن دعوةً إلى إصلاح جزئي يعالج انحرافاً معيناً وقع فيه المجتمع فاحتاج إلى عملية ترقيع أخلاقية أو اجتماعية تنقذه من الهاوية التي تردّى فيها أو أشرف على الهبوط فيها، عندما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
ولكن هذه الدعوة الخاتمة، جعلها الله تعالى دعوة تغيير شامل لِما بالنفس والمجتمع، لينشئ بذلك أمة خيّرة فاضلة. ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110].
وجعلها أمة قائدة رائدة وشاهدة على الأمم الأخرى؛ لأنها هي “الأمة الوسط العدل” في عقيدتها ومنهجها: ﴿وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ [البقرة: 143].
عملية بناء الأمة
هذه الأمة التي تبث الخير، وتحمل الحق إلى العالم كله، ليثوب إلى دين الله الواحد، لم تكن عملية بنائها وتربيتها عملية سهلة، هيّنة ليّنة، ولم يكن الطريق إلى ذلك قفزات سريعة، يستعجل فيها الداعون الوصول إلى الهدف المنشود؛ ولكنها كانت عملية بناء متكامل، يبذل فيها المسلمون الجهد والعناء، ويصبرون على أشواك الطريق الذي يسيرون عليه بخُطىً متئدة متدرجة، كل خطوة تسلمهم إلى تاليتها ليكونوا بذلك على الجادة المستقيمة من الطريق بعد تلك المجاهدة والمصابرة: ﴿والَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69].
أثر الفرد في الإصلاح
فلم يكن عجباً ـ والحال ما ذكرْتُ ـ أن يبدأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم ـ بوحي من ربه ـ في تربية الأمة كلها بتربية أفرادها أولاً؛ فالفرد هو الخلية الأولى في بناء المجتمع، فليكن هو نقطة البدء في الإصلاح والبناء؛ فإن إصلاح مجموعة من الأفراد في كل بلدة، إصلاحاً يجعلهم أئمة في الهدى والخير والاستقامة هو الذي يؤدي إلى استقامة شؤون البلدة كلها ونظافة حياتها الاجتماعية.
الرسول، صلى الله عليه وسلم، يربي جيل مكة
وظل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في مكة المكرمة ثلاثة عشر عاماً يُعني بتربية أفراد من أمته، حتى إذا اجتمع له منهم عشرات، شرع في بناء الدولة الصالحة والحضارة الإنسانية.
إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وابن مسعود.. وأمثالهم من الرعيل الأول، هم الذين أقاموا صرح الدولة الإسلامية والحضارة المؤمنة المشرقة، وهم الذين كان يجتمع إليهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في شعاب مكة وفي دار الأرقم، وفى فناء الكعبة، يقوّي أرواحهم، ويصقل نفوسهم، ويهذب أخلاقهم، حتى إذا مضى، صلى الله عليه وسلم، لربه تعالى والتحق بالرفيق الأعلى، كان لهم في التاريخ شأن أيّ شأن! وكان لهم في هداية البشرية نصيب وأي نصيب. (1انظر: أخلاقنا الاجتماعية للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله)
التأثير بين الفرد والمجتمع
ومن سنة الله تعالى في الحياة الاجتماعية أنه لا يتم تغيير ما بالمجتمع حتى يبذل المرء جهده في عملية التغيير النفسي أولاً: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]، وهذا التغيير والتزكية للنفس هو مفتاح الفلاح وسبب الفوز: ﴿ونَفْسٍ ومَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 7-10] ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى واتَّقَى * وصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل: 5-7].
فلا صلاح لمجتمع إلا بصلاح أفراده، ولا صلاح للفرد إلا بتهيئة المناخ الطيب النظيف، فهناك علاقة متبادلة بين هذا وذاك، ولعل في هذا إشارة إلى واحدة من الحِكم الكثيرة التي تتجلى في دعامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لتكوين الرأي الفاضل والمجتمع النظيف، الذي يعرف المعروف ويدعو إليه، وينكر المنكر ويحذر منه.
الطريق العملي للإصلاح
ولعلك تتساءل ـ أيها المسلم الغيور ـ عن الطريق العملي لهذا الإصلاح الذي ينشده الإسلام للفرد، ليكون خطوة على طريق الإصلاح الشامل للمجتمع الإنساني كله؟
وما أظن أن أحدا ينازع في أن الخطوة الأولى في بناء النفس وإصلاحها، هي التي تقوم على التوحيد المطلق لله سبحانه، وأن يشعر الإنسان بعبوديته الخالصة لله سبحانه، فيمتلئ قلبه محبة وإجلالاً لله، ليدفعه ذلك إلى طاعته واتباع أوامره ومتابعة نبيه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]. ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ولا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 3].
وقد فطر الله تعالى الإنسان على التوحيد: ﴿فِطْرَتَ الله الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله﴾ [الروم: 30].
ولن يقبل الله تعالى من إنسان دينا غير هذا الدين: ﴿إنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإسْلامُ﴾ [آل عمران: 19]، ﴿ومَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].
وهذه هي العقيدة التي تحرر صاحبها من الوهم والخرافة ومن العبودية للهوى والشهوة والشيطان، لتجعله عبداً لله تعالى وحده، فيشعر عندئذ بحريته الحقيقية وإنسانيته الكاملة.
وهذا القلب الذي أصلحته ليكون سبباً لصلاح الفكر والشعور والجسد، سيكون قلباً حياً حساساً ومَحكمة داخلية في نفسك، تُشعرك بالمسؤولية، وتدفعك إلى القيام بالواجب، فتُنصف من نفسك لغيرك، وتترك الانتصاف لها من الغير، فإن فعلت ذلك كنت أحسن الناس خُلقاً وأطيبهم معاملة، فغدوت أحب إليهم من نفوسهم وأقرب إليهم من أقاربهم، وهذه هي الخطوة الثانية على الطريق.
ويبقى أمامك أن تعود إلى هذه النفس فتُجمّلها بالمعاني الفاضلة وتحملها عليها ـ ان استعصت عليك ـ وإلا فإنها ستنبع من نفسك وتفيض على الآخرين من حولك؛ فإن العقيدة لابد أن يظهر أثرها في الأقوال والأعمال، فهي المرآة التي ينعكس فيها سلوك الإنسان ومعاملته لربه سبحانه، وللناس من حوله، وإلا كانت عاطفة فائرة، أو مستسرة في القلب، أو كلمات يديرها الإنسان على لسانه، لا تجاوز الحنجرة، وأصبحت أماني لا تنفع صاحبها: ﴿لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 123-124].
خاتمة
طريقنا للتغيير ليس طريقا بدعا من الطرق، بل هو المأخذ النبوي الموروث، وهو طريق من سبقنا من المؤمنين؛ يمر بالنفوس فيصلحها، ويصطفي خيرها وأزكاها فيكونوا مراكز للتغيير ونفوسا تجتذب إخوانها للخير والصلاح؛ فيسري الصلاح الى المجتمع؛ ويأخذ الناس طريق الجادة.
فمن أراد سلوك طريق الإصلاح لنفسه ولأمته فليسلك طريق محمد وصحبه. صلى الله عليه وسلم.
الهوامش:
- انظر: أخلاقنا الاجتماعية للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله.
المصدر:
- مجلة البيان، ربيع الأول – 1410هـ،أكتوبر – 1989م،(السنة: 4)، عثمان جمعة ضميرية.