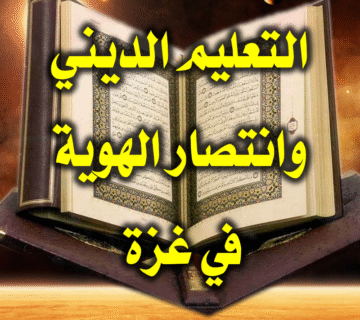تشكل تونس نموذجًا نادرًا من التجانس بين أفراد الشعب، فالبلد لا تعرف تعدد الأجناس ولا تعدد الأديان ولا المذاهب، فهي نسيج عربي سني واحِدٌ لا يُفرِّقُ أَهْلَهُ شيءٌ، وفي الأرض ثروات طبيعية تفي بحاجات الناس، وأعظم من هذه الثروات، الثروة البشرية لشعب تُوهّلُهُ نِسبته مقارنة بمساحة الأرض إلى أن يصنع ثورة اقتصادية تُوفّر له الرَّخاء المادي، وله من التراث المعرفي الأصيل ما يسمح له أن يستلهم من موروثه ما يفك به قيود التخلف. والبلد بذلك تمثل أفضل اختبار لمزاعم جَنَّة الخلد التي تعد بها العالمانية.
خديعة الاستقلال وتنصيب بورقيبة
بدأ النَّخْرُ في الهوية التونسية التي لم تعرف لنفسها غير الإسلام عنوانا مع بداية الاحتلال الفرنسي في القرن التاسع عشر، غير أن المكر الأكبر لم يبدأ إلا مع خديعة الاستقلال سنة ١٩٥٦م، حيث استطاعت فرنسا أن تُحقق بتنصيب بورقيبة1(1) الحبيب بورقيبة (۱۹۰۳ – ۲۰۰۰م): أول رئيس لتونس بعد الاستقلال وانتهاء عهد البايات تخرج حقوقيا في جامعة باريس. أسس الحزب الدستوري الجديد الذي تحول إلى الحزب الاشتراكي الدستوري. فتك برفاقه القدماء، كصالح بن يوسف، بعيد الاستقلال. منح نفسه امتياز الحكم مدى الحياة. حكم من بداية الاستقلال إلى سنة ۱۹۸۷م تاريخ انقلاب رئيس وزرائه زين العابدين بن علي عليه . أحمد العلاونة، ذيل الأعلام، ٤٦/٢. ما لم تطمع في بعضه في ظل حكمها الاحتلالي العسكري.
لم يهتم بورقيبة برد تونس إلى مهدها العقيدي، وإنما كان أبرز مُنجز له ضرب جامع الزيتونة الذي كان الحِصْنَ الأكبر لذاتية البلاد، وألغى الأوقاف والقضاء الشرعي، وسارع في زمن قياسي إلى إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر حالة نادرة في العالم الإسلامي بتعديها على سُلطان الشريعة في مجال الزواج والطلاق والتبنّي، وقد أحْدَثَ كُلُّ ذلك شرخا هائلا في طبيعة الواقعين: القانوني والفكري، وبلغ بورقيبة في توقحه مبلغ الخروج على الناس في رمضان وفي يده كأس ماء يدعوهم إلى الإفطار مثله لأن الصوم بزعمه يُعطل الإنتاج !.
بقي الإسلام مقصيا عن إدارة أمور الناس ورعاية مصالحهم في زمن خليفته المخلوع، ليصبح التدين عنوان تُهْمَةٍ جنائية والهمس بالولاء للشريعة «تهورا» بل «انتحارا»، ورافق كُلَّ ذلك ضخ إعلامي متواصل يريد أن يزرع في عقول الناس خديعة كبرى هي أن تونس قد استطاعت بفضل عبقرية الملهم العالماني بورقيبة أن تنخلع من منظومة التخلف العربية والإسلامية لتصبح بذلك من أرض أوروبا بعد الطفرة المعرفية التي ربطت البلاد أيديولوجيا بدول الغرب العالمانية المتطورة. وبلغ الإسفاف التجميلي مدى فجا في تزييف الوعي حتى أوهم الناس – حقيقة لا مبالغة – أنه لولا بورقيبة لم يدخل التعليم تونس، وأن منظومتي التعليم والثقافة في تونس قد أبهرتا الغرب قبل الشرق. وكان شر الدعايات في هذه المدة بث خديعة تحرير «المرأة»، والقول إن النموذج التونسي قدم للعالم الإسلامي النموذج المثالي لحقوق المرأة.
الحصاد المر لعلمانية بورقيبة وابن علي
وبعيدا عن الدعايات التسويقية للآلة الإعلامية لبورقيبة وابن علي، تتبدى الصورة على حقيقتها بَشِعَةٌ مُجْدِبَةٌ، فلم تَجْنِ البلاد غير الحصاد المر على جميع المستويات، إذ إن تنين العالمانية الذي كانت فرنسا تَصْفُلُ أَنْيَابَهُ قد بَقَرَ كُلَّ حُلُم يُحقق للمسلم أدنى ما يرجوه لمعاشه ومعاده.
المجال الاقتصادي
لم تكن تونس على المستوى الاقتصادي سوى مزرعة خلفية للمصالح الاقتصادية للدول الغربية، ولم تُعرف البلاد بتصنيع ولا ابتكار، على الرغم من توافر العقول والهمم عند أبنائها، وبقيت عالة على القروض والمعونات المشروطة، واستفحل الفساد في كُلِّ قطاعات الإنتاج، وأخفقت التجربتان الاشتراكية التعاضدية البورقيبية والرأسمالية البورقيبية والبنعلية.
المجال الثقافي
لم تعرف البلاد في هذه الفترة حركة فكرية ذاتية تنطلق من المخزون المعرفي الأصيل للبلاد، وإنما كان الفكرُ السّائد كُلُّهُ مُسْتَورَدًا مُعَلبًا. وقد بلغت الثقافة السائدة مبلغا عظيمًا من الإفلاس حتى توجه الكثير من الكتاب إلى استفزاز مشاعر المسلمين الهامدة في القلوب خوفًا من سطوة القَمْعِ العالماني، فانتشرت في هذه الفترة كتب تُقرِّرُ أنّ الإسلام لم يُحرم اللواط، وتزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد افترى القرآن الكريم من عنده بعدما تعلم من “شيوخه” السريان ما شاء من العلم، وأنّ السُّنَّة النبوية مُجرَّدُ فِرْيَةٍ اخْتَلَقَتْهَا الأجيال المسلمة، وأنّ الإسلام يجب أن يتخلص من قضايا الحلال والحرام، وغير ذلك من سقط الكلام ومبتذل الفكر، وبقيت جيوب الماركسية تنخُرُ في الجامعة نَخْرًا، وأُطلِقَتْ يد الحداثيين لِتَعْقِرَ أُصُولَ التدينِ بالإسلام عقرا .
لم تَجْنِ تونس في أكثر من نصف قَرْنٍ من العالمانية شيئًا سوى ترسيخ قواعد الأمية المعرفية. وقد أقحطتْ الجامعات التونسية فلم تعرف حركة علمية حية، وإنما اعتلى العالمانيون، خاصة الحداثيون منهم، منابرها للنفخ في ذواتهم وملكاتهم دون رصيد على الأرض من عَمَلٍ، ولذلك لم تساهم تونس في هذه الفترة في شيء يذكر من المعارف العربية على الرغم من أنها قد أخرجت للأمة قبل ما يعرف إعلاميا بالاستقلال، مؤلفات علمية نادرة، ككتب الإمام الموسوعي محمد الطاهر ابن عاشور.
لقد انتقلت البلاد من الريادة في نشر الثقافة الأصيلة أيام الاحتلال العسكري الفرنسي إلى المنافسة على المراتب الأخيرة في التعليم والثقافة في زمن الاحتلال المُقَنَّع الصائل بسيف العالمانية .
ولعل أبرز ما تتميز به جماعات العالمانيين في تونس عن بقية بلاد العرب، بالإضافة إلى تطرّفها العقيدي، وَلَعُها بلغة «العورات المغلظة» كُلَّما أَعْوَزَتْهَا الحُجَّةُ وضاقت عليها سُبُلُ المُحاجَجَةِ عند افتضاح فَقْرِها العلمي وفساد دعاويها وتبريراتها و«تقليعاتها»، وهي لُغَةٌ تَزْكُمُ الأنوف، وعادةً – إِلَّا ما ندر – تخرج من أفواه النساء، في سوقية لا يمكن أن تصدر عن واع بمعاني ما يصدر عن لسانه. وإذا لم تُجدِ «لغة العورات المغلظة» وتفجيج العبارة، التجاً بنو علمان إلى وصمِ خُصومهم بلسانِ التَّهويل أنهم جُفاةٌ وغُلاةٌ وبُغاةً، فلم يَبْقَ للسجال معهم فكريا باب بعد أن حَصرُوا الكلام بين ابتذال «العُوْراتِ المغلظة» وسيف التشويه المهتاج، فإنْ نَجَوْتَ من إقذاعِ العَوْرَاتِ فلن تنجو من صراخ الروعات!
المجال التعليمي
أَسْلَمَتْ المنظومة السياسية التونسية الجامعات لغلاة التغريبيين لإفراغها من روح الإبداع، ولذلك جاءت كُلية الآداب (العاصمة) التي تحتضن رؤوس الحداثيين، في تقرير سنة ۲۰۱۳م مُتأخرة في ترتيب جامعات إفريقيا، إلى المرتبة السبعين بعد جامعاتٍ كثيرة لدول شديدةِ الفَقْرِ تَنْتَهِبُها الحروب مثل الصومال، وهي أول جامعة تونسية في هذه القائمة، مع أن الوهم الأكبر الذي كان كثير من أساتذة هذه الجامعة يبيعونه للطلبة، هو أنهم قد استطاعوا القفز فوق سُرعةِ الزَّمَنِ وفارقوا المنظومات التقليدية (الغبية والمتقهقرة في بقية العالم الإسلامي!)، ليلتحقوا بِرَكْبِ الجامعات الغربية الكبرى، على الرغم من تَأخُرِهِم حتى على مستوى التعليم الجامعي في إفريقيا نفسها .
قضية المرأة
الإحصائيات ناطقة صارخة بالمأساة الكبرى؛ إذ إنّ جُرْأَة النظام العالماني على الدين لم تصنع واقعا ينتصف لحقوق المرأة وإنما “رفع” تونس إلى المرتبة الأولى عربيا في نسب الطلاق سنويًّا، والمرتبة الرابعة عالميا ، وبلغت نسبة العنوسة ٦٠٪ من الإناث، وشاعَتْ رُوحُ الصراع بين الجنسين، وطفت على الساحة ظواهر شادةٌ مثل ظاهرة استهلاك الفتيات للمخدرات.
كما وُئدَتْ كُل طاقة لأنثى لا تسير في مضمار العالمانية، وواكب ذلك توقح إعلامي فج يريد أن يُقنع الناس أن المرأة التونسية قد حققت ما لم يُحققه غيرها !
الهوية وإقامة الشريعة
كشفت دراسة استقرائية لمؤسسة استشراقية أمريكية متخصصة في دراسة التطورات القيمية في الشرق الأوسط نشرت في آخر سنة ٢٠١٣م – في مقارنة الاختيارات العقيدية والقيمية والسياسية في تونس بست دول أخرى (السعودية، ومصر، والعراق، وباكستان ولبنان وتركيا) ؛ أي: بعد ما عُرف “بثورة الربيع العربي” التي أطاحت بابن علي -، عن موقف جمعي سلبي إلى درجة كبيرة من إقامة الشريعة وما ارتبط بذلك من قيم :
– ٪۱۸ فقط من المستفتين يرون أن الشريعة هي الأمر الأكثر أهمية لمصلحة البلاد.
– ١٦٪ فقط يرون إقامة الشريعة أهم وسيلة للخروج من حال التخلف.
– ٪۱۳ فقط وافقوا بشدّة على أن الحكومة الجيّدة هي التي لا تقيم غير أحكام الشريعة .
– ٪۲۰ فقط اختاروا حكومةٌ تُطبق الشريعة في مقابل ۸۰٪ اختاروا حكومة تقيم قوانينها على اختيارات الناس.
– ٢٢٪ وافقوا على أن حال البلاد سيكون أحسن لو تمَّ فَضْلُ الدِّين عن السياسة، ووافق ٥٠% على الأمر نفسه بشدّة، بمجموع ۷۲% يرون خيار الفصل مقابل ٩٪ في باكستان !
– ۳۳ ٪ قبلوا أن يُسْمَحَ بحرية التعبير حتى لو تعارضت مع دينهم.
– ٥٦٪ يرون أن تلبس المرأة كما تشاء، وهي النسبة الأعلى بين الدول السبع. ويقابلها ١٤٪ في مصر.
قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن هذه النسب (المخيفة) تعكس حال نفور عام من الولاء العاطفي للإسلام، وليس الأمر كذلك يقينا إذ إن هذه الإحصائية نفسها كشفت أن ۳۱٪ يرون أنهم تونسيون قبل أن يكونوا مسلمين في حين اختار ٥٩٪ القول إنهم مسلمون قبل أن يكونوا تونسيين، لتكون نسبة المفضلين لهويتهم العقيدية على انتمائهم الوطني أكبر من بقية الدول باستثناء ، باکستان، كما أنّ ٨٤٪ يعتقدون أن هناك مؤامرات ضد المسلمين، و٧٣٪ يرون خطورة الغزو الفكري الغربي، وفي ذلك استحضار واضح لمعاني الانتماء الذاتي للجماعة العقدية الكبرى وتميزها المبدئي!
ما الذي نحن بإزائه إذن؟
الذي يبدو من هذا التضارب المنكر بين الموقف من الشريعة والموقف من الانتماء العام للهوية الإسلامية أن التجربة العالمانية في تونس قد أخْفَقَتْ في جعل الشَّعْبِ مواليا بِكُلِّيته للغَرْبِ (الفرنكفوني بالذات)، وقد كان ذلك مطمحا مُلِحاً لها، غير أنها نجحت في أن تُنشئ حال اغتراب لا واعٍ عن حقيقة الهوية، أو قُلْ حالة من «تيْهِ الهَوِيَّةِ» عند غالبية الشعب، وهو أمر له أسبابه التاريخية الظاهرة، خاصة في حقبة الانسلاخ البورقيبية التي ضربَتْ روافد الانتماء الديني في العلم الشرعي والدعوة وكذلك في البنية التشريعية.
وفي مثل البيئة التونسية التي تعرف فصامًا نَكِدًا حادًا بین الانتساب إلى الإسلام والولاء لأصُولِه، لا عُذْرَ لِحَمَلَةِ الدَّعوة إلم يتنبهوا لحقيقة الحال، ومبلغ الإشكال، ليدركوا أن إعادة بناء ما هَدَمَتْهُ العالمانية لا يكون إلا بإعادة إحياء المعاني الإسلامية في الأنفس على مدى طويل؛ بالكشف عن هذه المعاني، ونَفْضِ غُبارِ التَّحريفِ والتَّزييف عنها ، ثم تربية جيل جديد لم يبتلعه تنين العالمانية النَّهم، فإن رحلة التيه التي استمرَّتْ عُقودًا طوالا بعد ما سُمِّي بالاستقلال قد أنتجت تمدُّدات سرطانية في وعي أجيال «ما بعد الاستقلال»، ولا خروج من هذا التيه إلا بزَرْعٍ جديد لم يَنبُتُ وَعْيُهُ مِن سُحْتِ الأَضاليل، أما الحلول السريعة التي تتعايش مع الوَرَمِ أو تتغافل عنه فلن تُورِّثَ البلاد غير جنى السَّرابِ وحَصِيدَ الخَبَالِ.
الهوامش
(1) الحبيب بورقيبة (۱۹۰۳ – ۲۰۰۰م): أول رئيس لتونس بعد الاستقلال وانتهاء عهد البايات تخرج حقوقيا في جامعة باريس. أسس الحزب الدستوري الجديد الذي تحول إلى الحزب الاشتراكي الدستوري. فتك برفاقه القدماء، كصالح بن يوسف، بعيد الاستقلال. منح نفسه امتياز الحكم مدى الحياة. حكم من بداية الاستقلال إلى سنة ۱۹۸۷م تاريخ انقلاب رئيس وزرائه زين العابدين بن علي عليه . أحمد العلاونة، ذيل الأعلام، ٤٦/٢.
المصدر
كتاب: “العلمانية، طاعون العصر: كشف المصطلح وفضح الدلالة”، سامي عامري، ص158-165.
اقرأ أيضا
أهل السنة.. وحسم الموقف من العلمانية