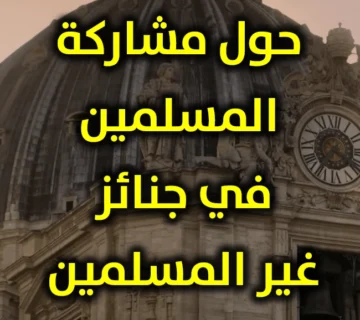ثمة دعوات خبيثة ظاهرها مغرٍ وحقيقتها تمييع الدين وذوبان هوية الأمة والسماح بذبحها في هدوء، ومنها دعوات “الإنسانية” و”تقارب الأديان”.
مقدمة
من أساليب الكفار والمنافقين الخبيثة في هدم أصل الدين والبراءة من الكافرين وتلبيسهم على المسلمين في ذلك، دعوات متلونة تدعو للتسامح الديني وحوار الأدين وتقاربها والدعوة الإنسانية العامة، وحقيقتها احتفاظ الغرب بهويته التي يقررها كهوية عالمية، وإخضاع المسلمين، وتذويبهم بعيدا عن دينهم.
الدعوة إلى الإنسانية والمناداة بحوار الأديان والتقارب بينها
وأكتفي هنا بما ذكره الشيخ محمد قطب رحمه الله تعالى عن هذا المصطلح الخبيث وخطورته والتلبيس على الناس به، قال رحمه الله تعالى:
“الإنسانية ـ أو العالمية كما يدعونها أحياناً ـ دعوى برّاقة، تظهر بين الحين والحين، ثم تختفي لتعود من جديد..!
“يا أخي! كن إنساني النزعة”، “وجِّه قلبك ومشاعرك للإنسانية جمعاء”، “دع الدين جانباً فهو أمر شخصي، علاقة خاصة بين العبد والرب محلها القلب، لكن لا تجعلها تشكل مشاعرك وسلوكك نحو الآخرين الذين يخالفونك في الدين، فإنه لا ينبغي للدين أن يفرق بين البشر، بين الإخوة في الإنسانية..!” “تعال نصنع الخير لكل البشرية غير ناظرين إلى جنس أو لون أو وطن أو دين..!”
إن أُناساً قد يُخدعون بدعوى الإنسانية لما فيها من بريق؛ فيؤمنون بها أو يدْعون إليها غافلين عن الحقيقة التي تنطوي عليها. وقد لا يصدقون أصلاً أنها دعوى إلى “التحلل من الدين” يبثها الشياطين في الأرض لأمر يراد. فلنصدق مؤقتاً أنها دعوى مخلصة للارتفاع بـ “الإنسان” عن كل عصبية تلوِّن فكره أو سلوكه أو مشاعره، ليلتقى بالإنسانية كلها لقاء الصديق المخلص الذي يحب الخير للجميع..
فلنصدق ذلك في عالم الأحلام، فما رصيد هذه الدعوى في عالم الواقع؟!
ما رصيدها في العالم الذي تجتاحه القوميات من جانب، والعصَبيات العِرقية والدينية والسياسية والاجتماعية من كل جانب؟
فلنأخذ مثالاً واحدا من العالم المعاصر من المعاملة التي يلقاها المسلمون في كل مكان في الأرض يقعون فيه في حوزة غير المسلمين، أو في دائرة نفوذهم من قريب أو من بعيد.
فلننظر إلى “الإنسانية” التي يعامَلون بها و”السماحة” التي يقابَلون بها، “وسعة الصدر” و”حب الخير” الذي ينهال عليهم من كل مكان!
هذه فلسطين ظلت أربعة عشر قرنا من الزمان أرضاً إسلامية. ثم جاء اليهود ليقيموا عليه دولة يهودية. ولم يستنكر أحد من “الإنسانيين” طرد السكان الأصليين وإجلاءهم عن أرضهم بالقنابل والمدافع، بل بشقّ بطون الحوامل والتلهّي بالمراهنة على نوع الجنين كما فعلت العصابات اليهودية التي كان رأس إحداها “مناحم بيجن”. وإنما استنكرت من المسلمين أن يطالبوا بأرضهم، وألا يخلوها عن طيب خاطر للغاصبين!
ويطول الأمر بنا لو رحنا نستعرض أحوال المسلمين الواقعين في قبضة غير المسلمين، أو الذين يتعرضون لعدوان الكفار في كل مكان في الأرض؛ في روسيا الشيوعية التي قتلت ما يقرب من أربعة ملايين من المسلمين، وفي يوغسلافيا التي قتلت ثلاثة أرباع مليون منهم وفي أفغانستان التي تستخدم فيها الأسلحة المحرّمة “دولياً” و”قانونياً” و”إنسانياً!، ومثل ذلك في العراق والصومال وسوريا، وفي أوغندا، وفي تنزانيا، وفي.. وفي.. وفي.. وفي.
فما بال “الإنسانيين” ما بالهم لا يتحركون؟! ما بالهم لا يصرخون في وجه الظلم الكافر الذي لا قلب له ولا ضمير؟!
إنما توجَّه دعوى “الإنسانية” فقط ضد أصحاب الدين!
فمن كان متمسكاً بدينه فهو “المتعصِّب” “ضيّق الأفق” الذي يفرق بين البشر على أساس الدين، ولا يتسع قلبه “للإنسانية” فيتعامل معها بلا حواجز في القلب أو في الفكر أو في السلوك!
أو قُلْ على وجه التحديد إن الذين يحارَبون اليوم بدعوى “الإنسانية” هم المسلمون!”. (1مذاهب فكرية معاصرة (صـ 510- 524) باختصار وتصرف يسير).
طرق وأهداف حرب المسلمين بدعوى “الإنسانية”
“وهي طرق يحارَب بها المسلمون من طريقين، أو من أجل هدفين:
- الهدف الأول: هو إزالة “استعلاء” المسلم الحق بإيمانه الناشئ من إحساسه بالتميز عن الجاهلية المحيطة به في كل الأرض وهدم عقيدة “الولاء والبراء”، لكي تَنْبهِم شخصيته وتتميع.
- والهدف الثاني: هو إزالة روح الجهاد من قلبه؛ ليطمئن الأعداء ويستريحوا!
فباسم الإنسانية يقال للمسلم الحق: “يا أخي لا تعتزل الناس! إن الإنسانية كلها أسرة واحدة، فتعامَل مع الأسرة كفرد منها، ولا تُميز نفسك عنها! وشارك في النشاط “الإنساني” ومظاهر الحضارة الإنسانية”.
تلك هي القضية! إنّ تمسّك المسلم بإسلامه شيء يغيظ أعداء الإسلام بصورة جنونية، ولا يهدأ لهم بال حتى يُذهبوا عنه ذلك التمسك ويُميعوه”. (2المصدر السابق)
من وسائل الخداع
“ومن وسائل ذلك ـ كما أسلفنا ـ دعوى الإنسانية والعالمية فإذا تميّع بالفعل، ولم تعد له سِمَته المميزة له، احتقروه كما احتقرت أوروبا الأتراك بعد أن أزال أتاتورك إسلامهم و”فرنجهم” و”غرّبهم”! بينما يقول أحد المبشرين في كتاب “الغارة على العالم الإسلامي”:
“إن أوروبا كانت تفزع من “الرجل المريض” (وهو مريض) لأن وراءه ثلاثمائة مليون من البشر مستعدون أن يقاتلوا بإشارة من يده”.
وهذا النص الأخير يدخل بنا إلى النقطة الثانية أو الهدف الثاني من استخدام دعوى “الإنسانية” في محاربة المسلمين.
إن أشد ما يخشاه أعداء الإسلام من الإسلام هو فريضة “الجهاد” الكامنة فيه!. “ودعوى الإنسانية” من أسلحة الحرب الموجَهة ضد روح الجهاد عند المسلمين؛ (يقولون):
“يا أخي! لقد تغيّرت الدنيا! لا تتكلم عن الجهاد! أو إن كنت لا بد فاعلاً فتكلم عن “الجهاد الدفاعي” فحسب! ولا تتكلم عنه إلا في أضيق الحدود! فهذا الذي يتناسب اليوم مع “الإنسانية المتحضرة”! لقد كانت للجهاد ظروف تاريخية وانقضت! أما اليوم فقد أصبحت الإنسانية أسرة واحدة! وهناك قانون دولي وهيئات دولية تنظر في حقك وتحل قضاياك بالطرق “الدبلوماسية”! فإذا فشلت تلك الهيئات في رد حقك المغتصب فعندئذ لك أن تقاتل دون حقك ولكن لا تسمِّه جهاداً! فالجهاد قد مضى وقته! وإنما سَمِّه دفاعاً عن حقوقك المشروعة!
أما نشر الدعوة فإياك أن تتحدّث فيه عن “الجهاد”! هناك اليوم وسائل “إنسانية” لنشر الدعوة فاسلكها إن شئت. هناك الكتاب والمذياع والتلفاز والمحاضرات والدروس، إياك أن تتحدث عن الجهاد فتكون مضغة في أفواه “المتحضرين!”.. (الى آخر ما يقولون بما يمثل ضغطا نفسيا مخادعا للمسلم).
إن الإسلام صريح في توجيه أتباعه إلى التميز عن أحوال الجاهلية، التميز بنظافة السمت ونظافة الأخلاق ونظافة السلوك، والاستعلاء بالإيمان على كل مصدر ليس إسلاميا أو متعارضٍ مع الإسلام، حتى لو لحقت بهم هزيمة مؤقتة أو ضعف طارئ: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران:139). (3المصدر نفسه)
مصدر تميز المسلم
ومصدر التميز هو الإحساس بأنهم “على الهدى” وغيرهم “على الضلال”، وأن المنهج الذي يعيشون به هو المنهج الأعلى لأنه “المنهج الرباني”، والذي يعيش عليه غيرهم هو المنهج الأدنى لأنه منهج جاهلي.
فهو ليس تميزاً مبنياً على الجنس ولا اللون ولا الجاه ولا الغنى ولا القوة ولا أي معنى من المعاني الأرضية التي تعتز بها الجاهلية وتستعلي بها على الناس؛ إنما التميز المستمَد من معرفة المنهج الرباني و اتباعه”. أ. هـ (4المصدر نفسه)
الدعوة الى حوار الأديان، وحقائق العقيدة
ومن شُبه الداعين إلى الإنسانية الدعوة لحوار الأديان وتقاربها وذلك بقولهم إن حوار المسلمين مع أهل الديانات الأخرى ليس حوار عقائد وإنما هو حوار على القواسم المشتركة المتفق عليها بين الجميع كخُلق التسامح والعدل ومحاربة الظلم ونشر السلام والقيم الفاضلة.
ولا يخفى ما في هذا الكلام من غباء ومغالطة ومخالفة لبدهيات العقل والشريعة.
أيّ عدل وأي أخلاق فاضلة يُطمع فيها من الكفار الذين كفروا بربهم فهم بين ملحد دهري أو مشرك مؤمن بعقيدة التثليث وتأليه عيسى عليه السلام، أو غير ذلك من الجاهليات الوثنية.
أيّ عدل وخُلق يُرجى من الكفار الصليبيين الذين قتلوا الملايين من المسلمين وشردوهم وسجنوهم وحاصروا بلدانهم حتى مات مليون طفل من حصارهم في العراق وغزة وغيرهما.
إن من كفر بالله عز وجل قد وقع في الظلم الأعظم وعليه فلا يتوقع مَن هذه حاله، إلا الظلم والأخلاق الرذيلة والاستبداد والطغيان قال الله عز وجل: ﴿وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال:70). والواقع شاهد بذلك.
إن من يرجوا سلاماً أو عدلاً أو أخلاقاً طيبة من الكفار كمن يستنبت بذوراً في الهواء أو يحرث في البحر.
إنه لا شيء يضبط السلوك الإنساني ويزكي النفوس ويأطرها على محاسن الأخلاق وترك سيئها غير توحيد الله عز وجل والخوف منه سبحانه ورجاء ثوابه ومراقبته في السر والعلن والشعور باطّلاعه عز وجل على خفايا القلوب ومنحنيات الدروب.
وهذا كله لا يأتي إلا بالتربية على التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته ومقتضياتها والتعبد له سبحانه بها مما يكون له الأثر في ظهور أثارها على أخلاق الناس وسلوكياتهم وإذا لم يوجد هذا الشعور وهذه التربية على العقيدة فإنه لا تنفع أي محاولة ـ مهما كانت ـ في تهذيب سلوك الناس، مهما وضع من النظم والقوانين والعقوبات، فغاية ما فيها ضبط سلوك الفرد أمام الناس والقانون فإذا غاب عن أعينهم ضاعت الأخلاق واضطربت القيم.
وهذا هو الفرق في علاج انحراف النفس البشرية والمجتمع الإنساني بين منهج الله عز وجل القائم على تربية الناس على العقيدة وبين المناهج الجاهلية البعيدة عن منهج الله عز وجل.
إن “عقيدة” التوحيد هي الأصل في إصلاح النفوس والأخلاق وبدونها تفسد الأخلاق والقيم. ولو صلحت بعض الأخلاق بدوافع أخرى غير العقيدة كالعادات ورقابة القانون أو المصالح النفعية فإنها لا تدوم بل تزول بزوال المصلحة أو الرقيب.
ويحسُن بنا في هذه الوقفة تنبيه المخدوعين من أبناء المسلمين الذين انخدعوا ببعض الأخلاق النفعية التي يجدونها عند الكفار في ديارهم؛ كـ “الصدق” في المواعيد، و”الأمانة”، و”الوفاء بالعقود”، إلى أن هذه الأخلاق لم يكن دافعها الخوف من الله عز وجل ورجاء ثوابه في الدنيا والآخرة. وإنما هي “أخلاق نفعية” مؤقَّتة يريدون منها مصالحهم الخاصة والدعاية لهم ولشركاتهم؛ ولذلك فإنها لا تدوم معهم وإنما تدور معهم “حسب مصالحهم”؛ بدليل أن هذه الأخلاق تنعدم ويحل محلها الأخلاق السيئة من “الكذب” و”الخداع” و”الظلم” و”الطغيان” إذا كانت مصالحهم تقتضي ذلك. ومراجعة سريعة للحروب الصليبية لبلدان المسلمين القديم منها والحديث يشهد على ذلك.
أما المسلم المتربي على العقيدة الربانية فأخلاقه ثابتة معه في ليله ونهاره في سِرّه وعلانيته في سرائه وضرائه في بلده وخارجه.
أهداف الدعوة المضلِلة
والحاصل أن الدعوة إلى (الإنسانية) التي تلغي البعد العقدي في علاقة الإنسان بالإنسان إنما هي دعوة مضلله مؤداها أهداف خطيرة من أهمها:
1) الخطر على عقيدة التوحيد التي صُلْبها الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبراءة والبغض للشرك والمشركين.
ونتيجة هذا الخطر مداهنة الكفر وأهله والكفّ عن ذكرهم بسوءٍ في عقيدتهم وأفكارهم، والمساواة بين المسلم الموحد والكافر الملحد. والله عز وجل يقرر في كتابه الكريم حتمية الخصومة والعداوة والمواجهة بين أوليائه وأعدائه.
2) إعادة النظر في مناهج التعليم والإعلام في بلدان المسلمين وحذف كل ما يشير إلى عداوة الكافر ومجاهدته في سبيل الله عز وجل، وقد بدأ هذا بالفعل في أكثر بلدان المسلمين.
3) المطالبة بفتح الكنائس والمعابد الوثنية في بلدان المسلمين ولا سيما في جزيرة العرب.
4) إبطال شعيرة “الجهاد” و”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بحجة أن يبقى الناس؛ مسلمُهم وكافرُهم في سلام ووئام وتزول الكراهية بينهم.
5) هذه الدعوة طريق يُمهِّد إلى تطبيع العلاقات مع اليهود والاعتراف بدولتهم على تراب فلسطين.
6) فتح المجال “للتنصير” في بلدان المسلمين أسوة بالمراكز الإسلامية في ديار الكفار.
7) حرية التدين وتغيير الدين وحرية الرأي والتفكير ولو كان بالإلحاد والردة وسبّ الدين. وهذا مما يفرح به الزنادقة والمنافقون من الليبراليين والعلمانيين، ويغتنموه في مزيد من الإفساد وبث الشبهات والشهوات.
8) محاصرة التوجه السلفي المستعصي على هذه الأطروحات المضللة الداعي إلى التمسك بأصول السلف وعقيدتهم في التوحيد والموالاة والمعاداة عليها، ورميه بشتى التهم والسعي لاحتوائه بالترغيب أو الترهيب، وإن لم يُجْدِ ذلك فبالتصفية والزجّ بأهله في غياهب السجون.
9) ومما يزيد الأمر خطورة ويشير إلى قوة المكر في هذه الدعوات تبني بعض الإسلاميين من بعض الدعاة وطلبة العلم لهذه الدعوة، ومباركتها..!
ولا ندري هل هذا جهل منهم أو مجاملة ومصانعة لمن يتبناها وينادي بها من وجهاء الناس وكبارهم؟!
وأيّاً كان أحد الأمرين فإنه مصيبة؛ وإن كان بعض المصائب أهون من بعض.
فـإن كنت لا تـدري فتلـك مصيبـة ** وإن كنـت تـدري فالمصيبـة أعظـم
خاتمة
لا يقبع تحت الكفر وخنادقه إلا ما أخبر الله في كتابه وقرّره وكرّر بيانه، وحذّر منه عباده وأولياءه ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ (التوبة: 10) ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ (الممتحنة: 2) ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ (البقرة: 217) ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ﴾ (آل عمران: 118) وغيرها من الآيات.
ثم لم يترك هؤلاء المجرمون تكذيبا ولا ريبة لما أخبر الله؛ بل هم يمارسون هذه الحقائق ليل نهار، وإنما يغفل من أعمى الله قلبه وطمس بصيرته، أو من له مصلحة عاجلة، أو من وافقهم من أهل النفاق والريب.. أو جموع تائهة نرجو له أن تستفيق لتسترجع أمرها وتدرك ما فاتها، وعسى أن يكون قريبا.
……………………………………..
الهوامش:
- مذاهب فكرية معاصرة (صـ 510- 524) باختصار وتصرف يسير.
- المصدر السابق.
- المصدر نفسه.
- المصدر نفسه.
لقراءة البحث كاملا على الرابط:
اقرأ أيضا:
- الناس خصمان شرعاً وواقعاً .. (1-2)
- الناس خصمان شرعاً وواقعاً .. (2-2)
- الغزو المصطلحي (1-2) دلالة المصطلحات على مفاهيم الأمم
- الغزو المصطلحي (2-2) تبعية المصطلحات، والصراع الفكري