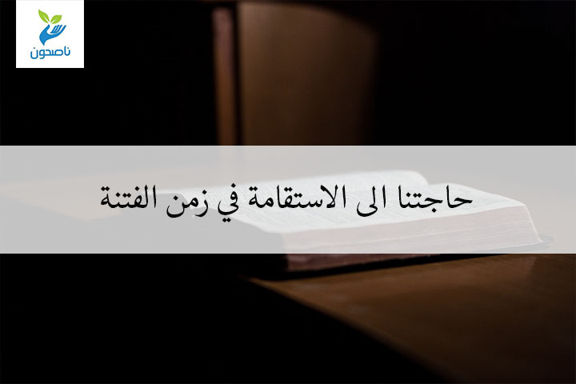إن للتسليم لله عز وجل في أخباره وأحكامه الشرعية والقدرية والإخلاص له وعبادته وحده سبحانه آثارا طيبة وثمارا يانعة في الدنيا والآخرة، يذوق المسلم حلاوتها، ويتفيأ ظلالها، ويشعر فيها بالقيمة الحقيقية للحياة وغايتها، التي يرحل كثير من الناس من هذه الدنيا ولم يذوقوا لها طعما.
جنة الدنيا أعظم ثمرة للتسليم لله عز وجل
إن أعظم ثمرة للتسليم لله عز وجل يمن بها سبحانه على من يشاء من عباده، هو أن يدخله جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. وجنة الدنيا هي السعادة القلبية، والطمأنينة النفسية، وتذوق حلاوة الإيمان، وجنة الآخرة التي فيها ما تشتهيه النفوس وتلذه الأعين، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم هذا النعيم رضا الله سبحانه ، والتلذذ برؤية وجهه الكريم. يقول الله عز وجل عن جنة الدنيا والآخرة: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: 21] ويقول سبحانه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].
وعن جنة الدنيا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (فاحرص أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل كما قال بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا)1(1) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص (30-31) باختصار. ت: عبد الله المديفر..
هذه أعظم ثمرة للتسليم في الدنيا والآخرة من حيث الجملة . ويمكن تفصيل فروع هذه الثمرة في الثمار الآتية:
السعادة والطمأنينة وسلامة النفوس من القلق والاكتئاب والرضا بقضاء الله تعالى.
إن العبد المسلم لربه المستسلم لحكمه لا تراه إلا مطمئنا راضيا سعيدا سالما، مما يعتري كثير من الناس من الهموم والغموم والاكتئاب والاضطراب، وذلك لمعرفته لربه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، التي تثمر في القلب تعظيم الله عز وجل ومحبته ورجائه وحسن الظن به سبحانه، وهذا من مقتضى رحمته وعلمه وحكمته وبره ولطفه، وهذا كله يثمر الطمأنينة والسعادة في النفس، فلا تجزع ولا تسخط، بل ترضى وتسلم عند حلول المصائب والمحن. ولا يعني هذا أن المسلم لربه لا يحزن ولا يصيبه هم وغم. بل المقصود أن الحزن والغم عند المصائب يخففه كثيرا معرفة العبد لربه ولأسمائه الحسنى واستسلامه لحكمه وحسن الظن به، والرضا بقضائه.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته، فقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97]. وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعیمه إلا نعيم الجنة.. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها، ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره، وهي عكس الحياة الطيبة. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث. أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والمعيشة الضنك تكون في الدور الثلاث. فالأبرار في النعيم هنا وهنالك، والفجار في جحيم هنا وهنالك. قال الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ [ النحل: 30])2(2) مدارج السالكين 3/259، باختصار..
ويتحدث سید قطب رحمه اللہ تعالى عن أثر التسليم لأقدار الله عز وجل في الرضا والطمأنينة، فيقول: (إنه قدر الله وراء طرف الخيط البعيد، لكل حادث، ولكل نشأة، ولكل مصير، ووراء كل نقطة، وكل خطوة، وكل تبديل أو تغيير إنه قدر الله النافذ، الشامل، الدقيق، العميق.
وأحيانا يرى البشر طرف الخيط القريب، ولا يرون طرفه البعيد. وأحيانا يتطاول الزمن بين المبدأ والمصير في عمرهم القصير، فتخفی عليهم حكمة التدبير. فيستعجلون ويقترحون. وقد يسخطون. أو يتطاولون.
والله يعلمهم في هذا القرآن أن كل شيء بقدر، ليسلموا الأمر لصاحب الأمر، وتطمئن قلوبهم وتستريح، ويسيروا مع قدر الله في توافق وفي تناسق، وفي أنس بصحبة القدر، في خطوه المطمئن الثابت الوثيق)3(3) في ظلال القرآن 6/3441..
وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادتهم ونشاطهم. ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع – بعد أن يبذلوا ما في وسعهم من التفكير والتدبير والاختيار – بالرضا والتسليم والقبول. فإن عليهم ما في وسعهم والأمر بعد ذلك لله .
والطمأنينة والسعادة يهبها الله عز وجل للناس أفرادا وجماعات عندما يستسلمون لشرع الله عز وجل وأحكامه، التي كلها خير ويسر وعدل ومصلحة للعباد، فكلما حكم الناس في حياتهم شرع الله واستسلموا له وتحاكموا إليه فإن السعادة والمودة والأمن والسلام يسود هذا المجتمع، وينعم الناس فيه بالهناء، والعكس من ذلك حينما يحكم في الناس أحكام الجاهلية وقوانينهم الظالمة الجاهلة، فإن التعاسة والشقاء والشحناء هي التي تظلل مثل هذه المجتمعات، كما هو مشاهد اليوم في واقعنا المعاصر.
إخلاص العبادة لله وحده، وذوق حلاوتها، والسلامة من الرياء.
العبد المستسلم لربه سبحانه وحده لا يعبد إلا الله وحده، ولا يرید بعمله إلا وجه ربه سبحانه، ولا يلتفت إلى غيره من طلب محمدة أو شهرة أو مصلحة دنيوية. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا معبرا يفرق فيه سبحانه بين الرجل المستسلم لله وحده لا شريك له، وبين رجل له شرکاء متشاكسون، لا يدري من يرضي ومن يقصد، قال الله عز وجل: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 29].
يقول ابن القيم رحمه الله تعالی عند هذه الآية: (هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد. فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحون، والرجل المتشاكس الضيق الخلق. فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى، شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته، لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين. والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له، وعلم مقصده، وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه، بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه، مع رأفة مالکه به، ورحمته له، وشفقته عليه، وإحسانه إليه، وتوليه لمصالحه، فهل يستوي هذان العبدان)4(4) إعلام الموقعين 1/187..
ويتحدث ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أثر التسليم لله عز وجل في ذوق حلاوة العبودية وإخلاصها لله تعالى: فيقول:
(فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان، المتضمن عبوديته لله، ومحبته له، وإخلاص الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا منه، راغبا راهبا، كما قال تعالى: ﴿مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾ [ق: 33].
وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه، فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله، فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسنح له، ويتشبث بها يهواه، كالغصن أي نسیم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة، وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار، وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه، ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات)5(5) العبودية لابن تيمية ص 124-123 باختصار ..
ومن علامات الإخلاص وصدق العبودية لله تعالى محبة ما يحبه الله ومن يحبه، وبغض ما يبغضه الله عز وجل ومن يبغضه والبراءة منه.
تفويض الأمور إلى الله عز وجل، وصدق التوكل عليه سبحانه، والخوف منه وحده
إن المسلم المستسلم لربه عز وجل الفقيه بأسمائه الحسنی، المتعبد له سبحانه بها، لا تراه إلا مطمئن القلب، قد فوض أموره إلى مولاه سبحانه، راضيا بحكمه، موقنا بحكمته ورحمته ولطفه، محسنا الظن بربه. في كل ما يقضيه ويقدره عليه، وهذا يثمر صدق التوكل عليه سبحانه، الذي هو غاية الاعتماد مع غاية الثقة. يفعل الأسباب عبادة لله سبحانه غیر متعلق بها، لأنه يعلم أن خالق الأسباب ومسبباتها هو الله عز وجل، وهذا اليقين يجعله متبرءا من الحول والقوة، غیر متعلق بمخلوق في خوفه أو رجائه أو رغبته أو رهبته، كما قال سبحانه عن نبيه هود عليه السلام عندما هدده قومه: ﴿قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [هود: 54 – 56].
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه، وقضائه وقدره، ومنعه وعطائه، وعافيته وبلائه، وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب کماله المقدس، الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب في مواضعه، والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان، والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به، بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء، أوجب له ذلك العلم والعرفان، إذ نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف، بل متجرد لله ﴿إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * مِن دُونِهِ﴾ [هود: 54 – 55]، ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه، وذل كل شيء لعظمته، فقال: ﴿مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود: 56]، فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره، وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه، وهل هذا الأمر إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم، ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم، فكل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه، فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره وظلمه، فإنه على صراط مستقیم، وهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقیم)6(6) الجواب الكافي ص 147..
سلامة القلب من الحقد والحسد والشر للمسلمين.
إن سلامة الصدر مع المسلمين ثمرة من ثمار القلب السليم الراضي بحكم الله عز وجل في منعه وعطائه وقبضه وبسطه، لا يحسد أحدا من عباد الله عز وجل على ما آتاه الله، لعلمه أن الحسد إنما هو اعتراض على قدر الله عز وجل ، والمعترض على قدر الله غير مستسلم لله تعالى.
(وسلامة الصدر راحة لصاحبها، وصلاح بال، وصفاء ذهن، وطمأنينة قلب، وعافية نفسية، وبرء من آلام وأوجاع ومعاناة الغل والحقد والحسد، ومن سائر أدواء مرض الصدر وآفاته.
وإن غير سليم الصدر هو أبأس المعانين، وأتعس المتخاصمين، وأشدهم تضررا، وأعظمهم عذابا؛ لأنه يعاني ضيقا في كل ما ينبغي أن يكون واسعا؛ ضيقا في صدره، وفي أخلاقه، وفي فكره.. وهل تجد سلیم الصدر إلا ودودا بإخوانه، ذلولا لهم، رؤوفا رحیما بهم وبعموم المؤمنين، محبا لهم ما يحبه لنفسه، طالبا لما فيه صلاحهم، حريصا على ما فيه نفعهم؟ وذلك ما يجعله شغوفا بنصحهم، مهموما بما فيه عنتهم، يتوخى صلاحهم من كل سبيل؛ فهو على إثر من قال فيه الله عز وجل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]. إنه بلا شك الصدر السليم.
جاء في تفسير قول الله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: 84]. (.. أن عوف الأعرابي قال: سألت محمد بن سیرین: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله عز وجل في خلقه)7(7) تفسير القرطبي 15/91 دار عالم الكتب.. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن أسألك قلبا سليما»8(8) رواه أحمد 4/ 123، والترمذي (3407).. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير»9(9) مسلم (2840)... قال الإمام القرطبي معلقا على هذا الحديث: «يريد والله أعلم أنها مثلها في أنها خالية من كل ذنب، سليمة من كل عيب، لا خبرة لهم بأمور الدنيا10(10) تفسير القرطبي 13/114.)11(11) انظر مقال: (مرجعية موحدة) مجلة البيان عدد (202)..
وما أجمل ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من سلامة القلب وحب الخير للمسلمين، فقد روى أبو نعيم في الحلية عن كهمس بن الحسن عن أبي بريدة قال: شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس: إنك لتشتمني، وفي ثلاث خصال: إني لآتي على الآية من كتاب الله تعالى فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه، فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين، فأفرح به، ومالي به من سائمة12(12) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 131 رقم 10474)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 3800)..
الهوامش
(1) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص (30-31) باختصار. ت: عبد الله المديفر.
(2) مدارج السالكين 3/259، باختصار.
(3) في ظلال القرآن 6/3441.
(4) إعلام الموقعين 1/187.
(5) العبودية لابن تيمية ص 124-123 باختصار .
(6) الجواب الكافي ص 147.
(7) تفسير القرطبي 15/91 دار عالم الكتب.
(8) رواه أحمد 4/ 123، والترمذي (3407).
(9) مسلم (2840).
(10) تفسير القرطبي 13/114.
(11) انظر مقال: (مرجعية موحدة) مجلة البيان عدد (202).
(12) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 131 رقم 10474)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 3800).
اقرأ أيضا
أصل الإسلام والتسليم .. لماذا الحديث عنه؟
إبراهيم وإسماعيل إذ يجسدان معنى التسليم