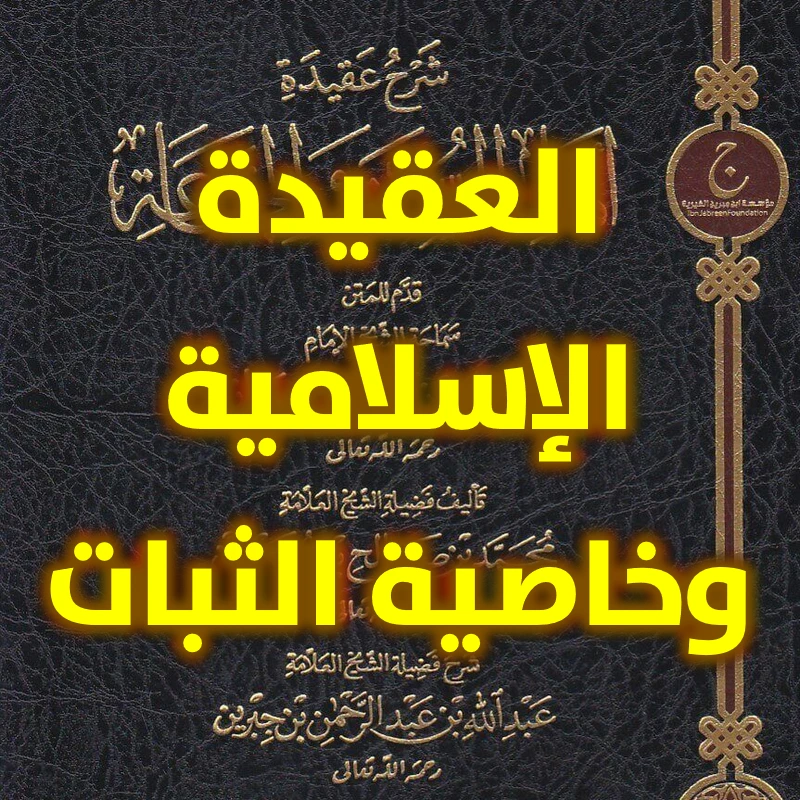“الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت” خاصية مهمة في دين الله، تحترم فطرة الإنسان، وتربطه بربه، وتجعله يتطور للخير دون هبوط، ودون الإفلات من حبل النجاة.
مقدمة
يقول سيد قطب رحمه الله وهو يتحدث عن خاصية الثبات كخاصية من خصائص العقيدة الإسلامية: «من الخاصية الأساسية للتصور الإسلامي ـ خاصية الربانية ـ تنبثق سائر الخصائص الأخرى، وبما أنه «رباني» صادر من الله، ووظيفة الكينونة الإنسانية فيه هي التلقي والاستجابة والتكيّف والتطبيق في واقع الحياة، وبما أنه ليس نتاج فكر بشري، ولا بيئة معينة، ولا فترة من الزمن خاصة، ولا عوامل أرضية على وجه العموم.. إنما هو ذلك الهدى الموهوب للإنسان هبة لدنية خالصة من خالق الإنسان، رحمة بالإنسان..
بما أنه كذلك فمن هذه الخاصية فيه تنشأ خاصية أخرى؛ خاصية:
«الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت».
هناك «ثبات» في مقومات هذا التصور الأساسية، وقيمه الذاتية، فهي لا تتغير ولا تتطور؛ حينما تتغير «ظواهر» الحياة الواقعية، و«أشكال» الأوضاع العملية؛ فهذا التغير في ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع، يظل محكومًا بالمقومات والقيم الثابتة لهذا التصور..
ولا يقتضي هذا «تجميد» حركة الفكر والحياة، ولكنه يقتضي السماح لها بالحركة ـ بل دفعها إلى الحركة ـ ولكن داخل هذا الإطار الثابت، وحول هذا المحور الثابت.
ونزوع هذا الإنسان إلى الحركة لتغيير الواقع الأرضي وتطويره، حقيقة ثابتة كذلك منبثقة أولًا من الطبيعة الكونية العامة، الممثلة في حركة المادة الكونية الأولى وحركة سائر الأجرام في الكون، ومنبثقة ثانيًا من فطرة هذا الإنسان، وهي مقتضى وظيفته في خلافة الأرض، فهذه الخلافة تقتضي الحركة لتطوير الواقع الأرضي وترقيته؛ أما أشكال هذه الحركة فتتنوع وتتغير وتتطور.
وهكذا تبدو سمة: «الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت» سمة عميقة في الصنعة الإلهية كلها، ومن ثم فهي بارزة عميقة في طبيعة التصور الإسلامي.
وهنا نستعرض نماذج من المقومات والقيم الثابتة في هذا التصور، وهي التي تمثل «المحور الثابت» الذي يدور عليه المنهج الإسلامي في إطاره الثابت.
إن كل ما يتعلق بالحقيقة الإلهية ـ وهي قاعدة التصور الإسلامي ـ ثابت الحقيقة، وثابت المفهوم أيضًا، وغير قابل للتغيير ولا للتطوير:
حقيقة وجود الله وسرمديته، ووحدانيته، وقدرته، وهيمنته، وتدبيره لأمر الخلق، وطلاقة مشيئته… إلى آخر صفات الله عز وجل وآثارها في الكون والحياة والناس.
وحقيقة أن الكون كله ـ أشياءه وأحياءه ـ من خلق الله وإبداعه، أراده الله سبحانه فكان، وليس لشيء ولا لحي في هذا الكون أثارة من أمر الخلق في هذا الكون، ولا التدبير ولا الهيمنة، ولا مشاركة في شيء من خصائص الألوهية بحال.
وحقيقة العبودية لله، عبودية الأشياء والأحياء، وعموم هذه العبودية للناس جميعًا، بما فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام عبودية مطلقة، لا تتلبس بها أثارة من خصائص الألوهية، مع تساويهم في هذه العبودية.
وحقيقة أن الإيمان بالله ـ بصفته التي وصف بها نفسه ـ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره شرط لصحة الأعمال وقبولها، وإلا فهي باطلة من الأساس، غير قابلة للتصحيح، مردودة غير محتسبة وغير مقبولة.
وحقيقة أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله لا يقبل من الناس دينًا سواه، وأن الإسلام معناه إفراد الله سبحانه بالألوهية وكل خصائصها، والاستسلام لمشيئته، والرضا بالتحاكم إلى أمره ومنهجه وشريعته، وأن هذا هو دينه الذي ارتضاه، لا أي دين سواه.
وحقيقة أن «الإنسان» ـ بجنسه ـ مخلوق مكرَّم على سائر الخلائق في الأرض، مستخلَف من الله فيها، مسخر له كل ما فيها، ومن ثَم فليست هناك قيمة مادية في هذه الأرض تعلو على قيمة هذا الإنسان أو تهدر من أجلها قيمته..
وحقيقة أن الناس من أصل واحد، ومن ثم فهم ـ من هذه الناحية ـ متساوون، وأن القيمة الوحيدة التي يتفاضلون بها ـ فيما بينهم ـ هي التقوى والعمل الصالح؛ لا أية قيمة أخرى، من نسب، أو مال، أو مركز، أو طبقة، أو جنس… إلى آخر القيم الأرضية.
وحقيقة أن غاية الوجود الإنساني هي العبادة لله… بمعنى العبودية المطلقة لله وحده، بكل مقتضيات العبودية، وأولها الائتمار بأمره ـ وحده ـ في كل أمور الحياة صغيرها وكبيرها والتوجه إليه ـ وحده ـ بكل نية وكل حركة، وكل خالجة وكل عمل، والخلافة في الأرض وفق منهجه ـ أو بتعبير القرآن وفق دينه ـ إذ هما تعبيران مترادفان عن حقيقة واحدة.
وحقيقة أن رابطة التجمع الإنساني هي العقيدة، وهي هذا المنهج الإلهي؛ لا الجنس، ولا القوم، ولا الأرض، ولا اللون، ولا الطبقة، ولا المصالح الاقتصادية أو السياسية، ولا أي اعتبار آخر من الاعتبارات الأرضية.
وحقيقة أن الدنيا دار ابتلاء وعمل، وأن الآخرة دار حساب وجزاء.
وأن الإنسان مبتلى وممتحَن في كل حركة، وفي كل عمل، وفي كل خير يناله أو شر، وفي كل نعمة وفي كل ضر. وأن مردَّ الأمور كلها إلى الله.
هذه وأمثالها من المقومات والقيم كلها ثابتة، غير قابلة للتغير ولا للتطور، ثابتة لتتحرك ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع في إطارها، وتظل مشدودة إليها، ولتراعي مقتضياتها في كل تطور لأوضاع الحياة، وفي كل ارتباط يقوم في المجتمع، وفي كل تنظيم لأحوال الناس أفرادًا وجماعات في جميع الأحوال والأطوار.
وقد تتسع المساحة التي تتجلى فيها مدلولات هذه المقومات والقيم، كلما اتسعت جوانب الحياة الواقعية؛ وكلما اتسع مجال العلم الإنساني، وكلما تعددت المفاهيم التي تتجلَّى فيها هذه المقومات والقيم، ولكن أصلها يظل ثابتًا، وتتحرك في إطاره تلك المدلولات والمفاهيم…
قيمة خاصية الثبات في حياة البشرية
وقيمة وجود تصور ثابت للمقومات والقيم على هذا النحو هي ضبط الحركة البشرية والتطورات الحيوية؛ فلا تمضي شاردة على غير هدى، كما وقع في الحياة الأوربية ـ عندما أفلتت من عروة العقيدة ـ فانتهت إلى تلك النهاية البائسة، ذات البريق الخادع واللَّأْلَاءِ الكاذب، الذي يُخفي في طيَّاته الشِّقوة والحيرة والنكسة والارتكاس.
وقيمته هي وجود الميزان الثابت الذي يرجع إليه «الإنسان» بكل ما يعرض له من مشاعر وأفكار وتطورات؛ وبكل ما يجد في حياته من ملابسات وظروف وارتباطات، فيزِنُها بهذا الميزان الثابت ليرى قربها أو بعدها من الحق والصواب، ومن ثم يظل دائمًا في الدائرة المأمونة، لا يشرد إلى التِّيه، الذي لا دليل فيه من نجم ثابت، ولا من معالم هادية في الطريق..!
وقيمته هي وجود «مقوّم» للفكر الإنساني، مقوّم منضبط بذاته، يمكن أن ينضبط به الفكر الإنساني؛ فلا يتأرجح مع الشهوات والمؤثرات، وإذا لم يكن هذا المقوم الضابط ثابتًا، فكيف ينضبط به شيء إطلاقًا إذا دار مع الفكر البشري ـ كيفما دار ـ ودار مع الواقع البشري ـ كيفما دار ـ فكيف تصبح عملية الضبط ممكنة، وهي لا ترجع إلى ضابط ثابت يمسك بهذا الفكر الدَّوَّار..؟ أو بهذا الواقع الدَّوَّار..؟!
إنها ضرورة من ضرورات صيانة النفس البشرية، والحياة البشرية أن تتحرك داخل إطار ثابت، وأن تدور على محور لا يدور..! إنها على هذا النحو تمضي على السنة الكونية الظاهرة في الكون كله، والتي لا تتخلف في جِرْم من الأجرام..!
إنها ضرورة لا تظهر كما تظهر اليوم، وقد تركت البشرية هذا الأصل الثابت؟ وأفلت زمامها من كل ما يشدُّها إلى محور، أصبحت أشبه بجِرْم فلكي خرج من مداره، وفارق محوره الذي يدور عليه في هذا المدار، ويوشك أن يصطدم فيدمر نفسه ويصيب الكون كله بالدمار. ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: 71].
والعاقل «الواعي» الذي لم يأخذه الدُّوار الذي يأخذ البشرية اليوم، حين ينظر إلى هذه البشرية المنكودة يراها تتخبط في تصوراتها، وأنظمتها، وأوضاعها، وتقاليدها، وعاداتها، وحركاتها كلها تخبطًا منكرًا شنيعًا، يراها تخلع ثيابها وتمزقها كالمهووس..! وتتشنج في حركاتها وتتخبط وتتلبط كالممسوس، يراها تغير أزياءها في الفكر والاعتقاد، كما تغير أزياءها في الملابس وفق أهواء بيوت الأزياء..! يراها تصرخ من الألم، وتجري كالمطارَد، وتضحك كالمجنون، وتُعَرْبِد كالسكير، وتبحث عن لا شيء..! وتجري وراء أخيلة..! وتقذف بأثمن ما تملك، وتحتضن أقذر ما تمسك به يداها من أحجار وأوضار..!
لعنة..! لعنة كالتي تتحدث عنها الأساطير..!
إنها تقتل «الإنسان» وتحوله إلى آلة… لتضاعف الإنتاج..!
إنها تقضي على مقوماته «الإنسانية»، وعلى إحساسه بالجمال والخلق والمعاني السامية لتحقيق الربح لعدد قليل من المرابين وتجار الشهوات، ومنتجي الأفلام السينمائية وبيوت الأزياء..!
وتنظر إلى وجوه الناس، ونظراتهم، وحركاتهم، وأزيائهم، وأفكارهم، وآرائهم، ودعواتهم؛ فيخيل إليك أنهم هاربون..! مطارَدون..! لا يلوون على شيء، ولا يتثبتون من شيء..! ولا يتريثون ليروا شيئًا ما رؤية واضحة صحيحة، وهم هاربون فعلًا..! هاربون من نفوسهم التي بين جنوبهم..! هاربون من نفوسهم الجائعة القلقة الحائرة التي لا تستقر على شيء «ثابت»، ولا تدور على محور ثابت، ولا تتحرك في إطار ثابت، والنفس البشرية لا تستطيع أن تعيش وحدها شاذة عن نظام الكون كله، ولا تملك أن تسعد وهي هكذا شاردة تائهة، لا تطمئن إلى دليل هاد، ولا تستقر على قرار مريح..!
وحول هذه البشرية المنكودة زمرة من المستنفعين بهذه الحيرة الطاغية، وهذا الشرود القاتل، زمرة من المرابين، ومنتجي السينما، وصانعي الأزياء والصحفيين، والكُتَّاب.. يهتفون لها بالمزيد من الصرع والتخبط والدوار، كلما تعبت وكلَّت خطاها، وحنَّت إلى المدار المنضبط والمحور الثابت، وحاولت أن تعود..!
زمرة تهتف لها… التطور.. الانطلاق.. التجديد.. بلا ضوابط ولا حدود، وتدفعها بكلتا يديها إلى المتاهة كلما قاربت من المثابة، باسم التطور، وباسم الانطلاق، وباسم التجديد.
إنها الجريمة، الجريمة المنكرة في حق البشرية كلها، وفي حق هذا الجيل المنكود..!
خاتمة
واليوم تأتينا موجات الإلحاد متتالية لموجات الإباحية، تتلوها موجات الشذوذ، تليها موجات الأثَرة المادية، وحروب الفيروسات، وتمجيد الطغيان، واحتقار الإنسان وتحويله الى حيوان يتحسس شهواته ويمجد نزواته ويُحرَم من الرقي والسموّ ونور الوحي الكريم.
ولا يزال الإسلام ـ دين الله الباقي ـ يهتف بالناس للعودة، وينير لهم الطريق ويتحمل أهله الأذى في سبيل بيان الحق والصبر على أذى القيادة الشريرة التي تتحكم في البشرية اليوم.
المصدر:
- «خصائص التصور الإسلامي» (ص 85 – 93) (باختصار) وتصرف يسيرين.