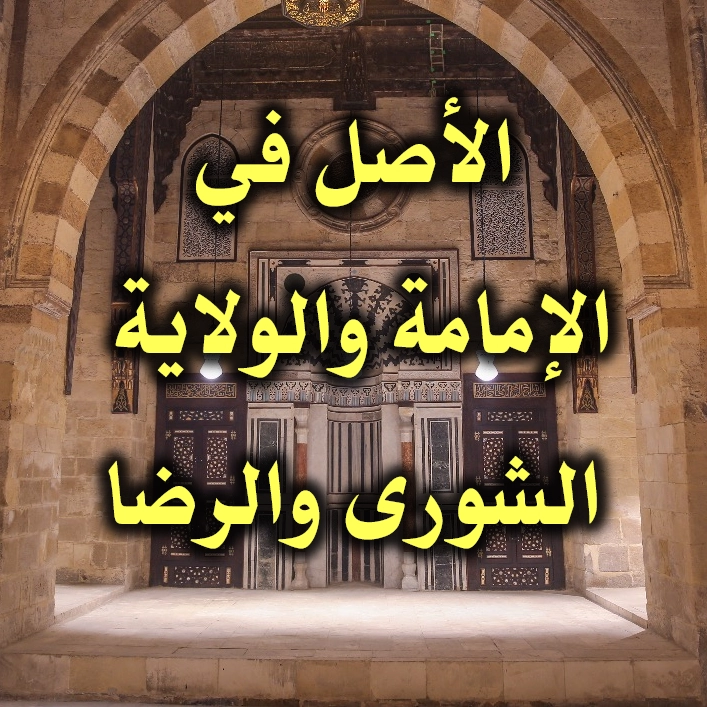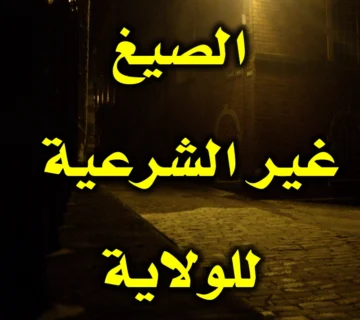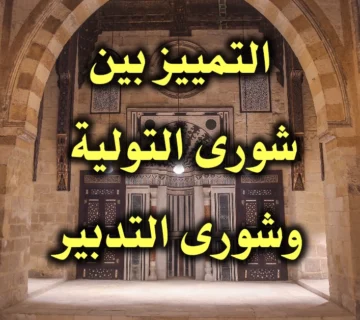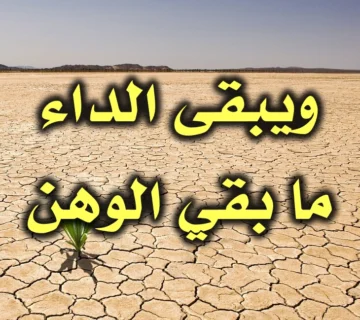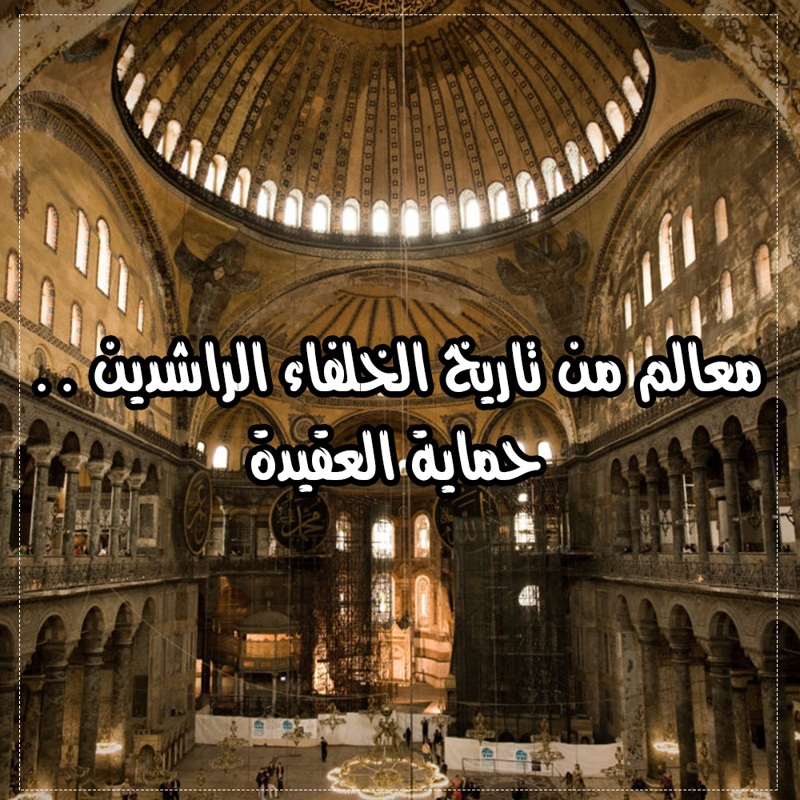في هذه السلسلة من المقالات تلخيص مكثف لمفهوم (السياسة الشرعية) الذي يتطلع إليه الإسلاميون، على شكل مفاتيح أساسية لفهم المشروع الإسلامي في الحكم..
السياسة الشرعية: المفاتيح الأساسية لفهم المشروع الإسلامي في الحكم
مبدأ الشورى
وهذا الأصل دلت عليه نصوص شرعية كثيرة منها أن الله سمى سورة كاملة في القرآن باسم الشورى، وجاء فيها (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) [الشورى: 38] فوضع الشورى بين الصلاة والزكاة تنويهاً بشرفها.
وأمر الله نبيه –صلى الله عليه وسلم- فقال: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)[آل عمران:159].
فإذا كان الله أمر النبي أن يشاور من دونه، فكيف بمن دون النبي؟ يقول ابن تيمية عن هذه الآية (فغيره – صلى الله عليه وسلم – أولى بالمشورة)(1).
وجاءت في ذلك أحاديث وآثار عن الصحابة سنشير لها لاحقاً.
الأصل في الشورى أن تكون عامةً في المسلمين، لا خاصةً بطائفةٍ منهم
ذكر بعض أهل العلم المعاصرين أن الشورى خاصة بطائفة كتخصيصها بأهل الحل والعقد (بمعناه التخصيصي)، أو أهل الشوكة، أو أهل الاختيار، ونحوها، والراجح أن الأصل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين كما دلت عليه العمومات الشرعية ومنها: عموم قوله تعالى في آيتي الشورى (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) ، (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)، فعم ولم يخصص.
ولأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال عام الحديبية: (أشيروا علي أيها الناس) (2). وقام النبي –صلى الله عليه وسلم- في حادثة الإفك خطيباً في الناس وقال: (أما بعد، أشيروا علي في أناس..)(3) وعن أنس (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاور الناس يوم بدر)(4).
فتلاحظ في هذه المواقف التي تروى فيها بعض مشاورات النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه يميل إلى “تعميم الشورى” ولا يخصص، ويستخدم صيغة “أيها الناس” العامة، أو يخاطب المسلمين خطاباً عاماً.
عمر بن الخطاب يحذّر: بيعة بلا شورى المسلمين خيانة تستوجب القتل!
وقام عمر بن الخطاب في المدينة خطيباً وقال: (من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو، ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا)(5) فنص عمر على أن الشورى في “المسلمين” وهو لفظ عام غير خاص.
عبدالرحمن بن عوف ونموذج الشورى الحقيقية..
ولما فوض الصحابة عبدالرحمن بن عوف لكي يطوف في الناس لتنفيذ الشورى وإجراء الانتخاب وفرز الأصوات لتحديد الإمام من مجموع المرشحين، لم يجعل عبد الرحمن بن عوف الشورى خاصة بطائفة، بل شاور الناس، كما يروى البخاري القصة وفيها (فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، فلما ولّوا عبد الرحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحمن، حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط، ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي)(6).
فهذا نص رواية البخاري وفيها أن عبدالرحمن مكث عدة ليالي، وأن “الناس” وليس طائفة معينة اجتمعوا على عبدالرحمن لتنفيذ الشورى، كما في النص السابق ” ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي”.
الشورى كانت عامة للمسلمين لا حكرًا على فئة
وفي البخاري –أيضاً- في نفس هذه الرواية أن عبد الرحمن بن عوف بعدما انتهى من فرز الأصوات دعا الصحابة وقام خطيباً بعد الفجر وأعلن أنه شاور الناس، وليس طائفة خاصة، كما يروي البخاري (فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال: “أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان”)(7). فنص عبدالرحمن أنه فحص إرادة الناس عامة قدر إمكانه وطاقته، وليس إرادة طائفة خاصة.
وفي نهاية القصة –كما رواها البخاري- قام المسلمون وبايعوا عثمان، ولم تقتصر بيعته على طائفة خاصة، ولو كان ليس للمسلمين عامة مدخل في الشورى لكانت بيعتهم عبث ينزه الصحابة عنه، كما يروي البخاري: (فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار، وأمراء الأجناد، والمسلمون)(8).
اتفاق الحكمان على جعل الأمر “شورى بين المسلمين” بعد خلع علي ومعاوية
ولما اتفق الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص على خلع علي ومعاوية، اتفقوا أن يجعلوا الأمر شورى في المسلمين، كما تروي كتب التاريخ (أن نخلع هذين الرجلين علي ومعاوية، ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين، فيختاروا لأنفسهم من أحبوا)(9).
فتلاحظ في صيغتهم هذه التي ترددت في كتب التاريخ النص على جعل الولاية “شورى في المسلمين” فعموا ولم يخصوا طائفة بعينها.
الإمام أحمد يحدد شرط الإمامة: ‘رضا المسلمين جميعاً’ وليس تزكية النخب!
وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: (أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول “هذا إمام” فهذا معناه)(10).
فلو لم يكن لعموم المسلمين مدخل في الشورى لم يعتبر الإمام أحمد رضاهم واختيارهم في معيار الإمامة الكاملة هاهنا، وهي إمامة الاستحقاق لا إمامة الانعقاد.
ابن تيمية يُفنّد أكذوبة ‘الشرعية بالبيعة المحدودة‘
وقد علّق الإمام ابن تيمية على إمامة أبي بكر وعمر، كلاهما، تعليقاً وضح فيه أن إمامتهما لم تنعقد وتستقر باختيار طائفة معينة ولا بعقد، بل انعقدت واستقرت باختيار ورضا جمهور المسلمين، يقول ابن تيمية عن خلافة أبي بكر:
(ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوا أبابكر، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة)(11).
فاعتبر ابن تيمية أن انعقاد البيعة لأبي بكر لم يحصل بمجرد بيعة خاصة الصحابة، بل بمبايعة جمهور الصحابة.
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً: (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز)(12).
فاعتبر ابن تيمية هاهنا -أيضاً- أن انعقاد البيعة لعمر لم يحصل بمجرد عهد أبي بكر له، بل بمبايعة جمهور الصحابة له.
فابن تيمية في الحادثتين لم يعتبر في الانعقاد إلا مبايعة جمهور الصحابة، لا بيعة الخاصة، ولا العهد من الإمام السابق.
الشورى العامة في الإسلام: أدلة قرآنية، سنية، وإجماع الصحابة
هذه جملة من نصوص الشورى التي تأملتها وتمعنت فيها، وهي آيات الشورى، وأحاديث مشاورة النبي –صلى الله عليه وسلم- أصحابه، وخطبة عمر في الشورى، وتصرف عبدالرحمن بن عوف في إجراء الشورى والانتخاب، واتفاق الحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص، وعبارات أئمة أهل السنة كأحمد بن حنبل وابن تيمية، وغيرها من الشواهد، وظهر لي اتفاقها جميعاً على أن الأصل والأكمل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين، وليست خاصة بطائفة معينة، وقد رأيت بعض المحققين كابن تيمية فرق في نص ثمين بين الانعقاد والاستحقاق، وجعل الاستحقاق مصدره الرضا والاختيار العام من المسلمين، وسيأتي كلامه لاحقاً، وطوال بحثي في مسائل السياسة الشرعية لم أجد نصاً واحداً من كتاب الله أو سنة رسوله أو آثار الصحابة يخص شورى التولية بطائفة معينة، ومن ادعى من أهل العلم المعاصرين تخصيص شورى التولية بطائفة معينة من حيث الأصل فعليه الدليل، مع إقرارنا أنه اجتهاد محترم له وزنه، وقال به علماء كبار في فقه السياسة الشرعية، والله أعلم.
المعتبر في الشورى والانتخاب هو الأغلبية
بعض الناس يتحسس من لفظ “الأغلبية” وهذا غير دقيق، بل المعتبر في السياسة الشرعية في انتخاب الإمام هو (الأغلبية) كما قال الجويني: (الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع)(13).
وقال ابن تيمية رحمه الله: (ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة، فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة)(14) .
متغيرات الاتصالات وأثرها في تعميم الشورى
يتساءل كثير من قراء السياسة الشرعية لماذا لم يطبق الصحابة فكرة صناديق الاقتراع أو تعميم الشورى فرداً فرداً في مملكتهم الإسلامية؟ والحقيقة أن هذا التساؤل ينطوي على إهدار مضامين تاريخية جوهرية، فمن الاعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها في البحث في مسائل السياسة الشرعية هو (تطور وسائل الاتصال المعاصرة)، فهذا معطى جوهري له دور بالغ في فهم تطور الديمقراطية ذاتها، وبالتالي فقياس فترات تاريخية تتفاوت في هذا المعطى هو بكل اختصار (قياس مع الفارق) كما يقول الأصوليون.
اعتذار ابن حزم عن الانتخاب العام لصعوبة الجغرافيا..
فقبل تطور وسائل الاتصال المعاصرة لم يكن بالإمكان أصلاً تطبيق الاختيار العام، أو الاقتراع العام، بهذا الشكل الذي نراه اليوم، وسأنقل شاهداً مهما لابن حزم يشرح فيه هذا الامتناع التاريخي، يقول ابن حزم:
(أما من قال أن “الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد” فباطل، لأنه تكليف ما لا يطاق، وما ليس في الوسع، وما هو أعظم الحرج، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقال تعالى “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرُّف إجماع فضلاء من في المولتان والمنصورة، إلى بلاد مهرة، إلى عدن، إلى أقاصي المصامدة، بل طنجة، إلى الأشبونة، إلى جزائر البحر، إلى سواحل الشام، إلى أرمينية وجبل القبج، إلى اسينجاب وفرغانة واسروسنه، إلى أقاصي خراسان، إلى الجوزجان، إلى كابل المولتان، فما بين ذلك من المدن والقرى، ولا بد من ضياع أمور المسلمين قبل أن يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء أهل هذه البلاد)(15).
فتلاحظ في هذه المناقشة التي يستعرضها ابن حزم أنه يستند أصالةً إلى (عائق الاتصالات)، وأنه لا يمكن معرفة أصوات الناخبين بين هذه الأقطار المتباعدة إلا بوقت طويل تتعطل به مصالح الناس، ويفوت به غرض الإمامة.
الغزالي: ‘انتظار الإجماع قد يطول‘
ويشير الغزالي –أيضاً- إلى عقبة الاتصالات بصورة متخيلة طريفة، نقلها عن من يناقشهم وأقرها، يقول فيها:
(وباطل أن يُعتبر إجماع جميع أهل الحل والعقد في جميع أقطار الأرض، لأن ذلك مما يمتنع، أو يتعذر تعذراً يُفتقَر فيه إلى انتظار مدة عساها تزيد على عمر الإمام فتبقى الأمور في مدة الانتظار مهملة)(16).
إذا كان ذلك كذلك فما الذي كان يجري في عصر الخلفاء الراشدين؟ الذي كان يجري هو التوسع في مفهوم (التمثيل) فبلدان المسلمين المتباعدة كانوا يسلمون الأمر للمدينة النبوية ومن فيها من الصحابة، فمن اختاروه رضيت به بقية البلدان، ولذلك لم يظهر معارضة منهم في خلافة الثلاثة.
الهوامش
(1) [الفتاوى:28/387].
(2) [البخاري:4178].
(3)[البخاري:4757].
(4) [مسند أحمد: 13296].
(5) [البخاري:6830].
(6) [البخاري: 7207].
(7) [البخاري: 7207].
(8) [البخاري: 7207].
(9) [تاريخ الدينوري:200، وتاريخ الذهبي:3/549].
(10) [منهاج السنة:1/529].
(11) [منهاج السنة:1/530].
(12) [منهاج السنة:1/530].
(13) [الغياثي:67].
(14) [منهاج السنة:8/335].
(15) [الفصل:5/13].
(16) [فضائح الباطنية:175].
المصدر
“مفاتيح السياسة الشرعية”، الشيخ إبراهيم السكران.