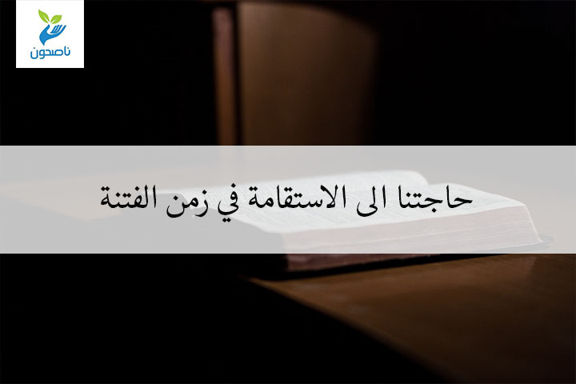يؤتَى الإنسان من مداخل شتى تصرفه عن العبودية لله تعالى. ومن أعظمها الإعجاب بالنفس والانخداع بالعقل والقطع بالظنون والأهواء؛ فتصد العبد عن مأخذ العبودية والتسليم.
تجاوز العقل لدوره
لم يكن لديَّ شك في أن هذا خطأ، وانحراف، ومعارضة تنافي واجب التسليم لله ولرسوله، صلى الله عليه وسلم..
هذا ما كان يدور في خاطري وصوت القائل يتردد في أذني يؤكد بعد إنكاره لبعض الأحكام الشرعية:
“أنه يؤمن بأن الشريعة والنصوص النبوية لا تنافي العقل أو تتعارض مع المصلحة، وإن وَجَدَ خلافَ ذلك فإن من إيمانه بالشريعة أن ينزِّهها عن هذا الحكم؛ فلا يقرُّه ولا يؤمن به”.
وقد كنتُ أحسبها واضحة عند من يسمعها حتى بعثر حساباتي ما سمعته وقرأته من بعض الناس ممن حمله مثل هذا الكلام على معنى:
“أن الشريعة والنصوص النبوية تأتي على ما فيه المصلحة والعقل”.
تأمَّلْ في عبارته جيداً؛ إنه لم يجعل أحكام الشريعة مؤدِّية لما فيه مصلحة، وما يتفق مع العقل والفطرة السوية، وإنما وضع “شرطاً” للأحكام الشرعية التي سيؤمن بها ويقبلها، وهو أن تكون على ما فيه المصلحة والعقل؛ فهو انقياد للنصوص الشرعية “مشروط” بسلامة النتيجة؛ بحيث لا تخالف العقل والمصلحة.
الفرق بين تعامل المؤمن وتعامل المرتاب
أين من يقرأ في نصوص الشريعة ويبحث في أحكامها؛ لينظر في مراد الله ومراد رسوله، صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يؤمنَ به ويعملَ بمقتضاه، ويؤمن بعد ذلك كله، أن هذا هو العقل والمصلحة، ويعتمد في سبيل ذلك على أقاويل الصحابة وتفاسير التابعين ومذاهب الفقهاء واللغويين؛ حتى يهتدي إلى “مراد” الله و”مراد” رسوله، صلى الله عليه وسلم..؟
أين هذا ممن يضع “أحكاماً” عقلية مسبقة و”مصالح” دنيوية معيَّنة يرى أنها ـ بحسب هواه وعقله القاصر ـ هي “العقل” و”المصلحة” التي لا تأتي الشريعة بما ينافيهما؛ فإذا وجد آية محكَمَة أو حديثاً صحيحاً يهزُّ بعض جوانب هذه الثوابت المتقرِّرة لديه، بادر بتكــذيــب الخبــر أو تأويله؛ لأنه ينافر العقل والمصلحة ـ بزعمه..!
ليست هي مقابلة بين “الشريعة” و”العقل”؛ بل هي مقابلة بين الشريعة وعقل هذا الإنسان وفَهْمِه وإدراكه؛ فهو يجعل أحكام الشريعة مرهونة التطبيق حتى تنفك من معارضتها للعقل بحسب فَهْمِه، فإذا لم يفهم العقل بطلت الشريعة؛ فأصبح عدم الفهم لحكمة الشريعة سبباً لتوقف العمل بالأحكام الشرعية.
إن الحكم على الشيء بأنه موافق للعقل أو منافٍ له إنما يتأثر بذات الشخص، وتجاربه، وعلمه، وبيئته التي يعيش فيها؛ فهو إدراك نسبيٌّ في لحظة معيَّنة تتغير مع تقدُّم العُمُر، أو اكتساب المعرفة، أو حدوث التجربة، وبناءً على ذلك فالعقل الذي يتحدث عنه عقل آني متغير، وكل ما يقال عنه: إنه العقل، ويوجد في الضفة المقابلة من يقول: هو ضد العقل وينافي جميع المقدمات العقلية؛ فعلى أيِّ الضفتين ستستقر الأحكام الشرعية؟
الريبة في قلوبهم
إن جزءاً من الشريعة ـ بناءً على هذه المشروطية ـ غير قابل للتنفيذ، وهذا الجزء يضيق ويتسع بحسب “العقل” الذي يحمله كل إنسان، وبحسب المصلحـة التـي يعرفها أو يريدها؛ فالأحكام التي يفترق فيها الرجل عن المرأة في الشريعة متوقفة عند العقل الذي يرى المصلحة في “المساواة”، والأمر بالأحكام الشرعية والإلزام بها. وإقامة الحدود عليها متوقفة أيضاً عند العقل الذي يرى المصلحة في “الحريات”. والنصوص الشرعية في الإيمان بأسماء الله وصفاته متوقفة كذلك عند العقل الذي يرى التأويل أو التفويض. والإيمان بصحيح سنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، متوقف عند العقل الذي يرى المصلحة في الاكتفاء بالقرآن، أو بالمتواتر من السُّنة، أو بإخراج السُّنة عن دائرة التأثير في العقائد أو التشريعات.
وهكذا يدخل “العقل”، وتأتي “المصلحة” لتسحب جزءاً من الشريعة عن الإيمان والتسليم؛ وإن كان هذا الجزء لدى كثير منهم هو قليل بالنسبة لما يؤمنون به من الشريعة إلا أن هذا الجزء لا يُدرَى ما حدُّه؟ وما ضابطه؟ فكل جزء من الشريعة هو قابل لأن يُقَرَّ أو يُرفَضَ، وما تؤمن به الطائفة الفلانية فمن الممكن أن تنكره الطائفة الأخرى بسبب العقل والمصلحة، وكل ما يؤمنون به مما يعتقدون أنه موافق للعقل والمصلحة يمكن أن ينكَر عند آخرين لمخالفته للعقل والمصلحة.
إن المسلم حين يؤمن بأن الإسلام هو دين الله الذي أنزله على محمد، صلى الله عليه وسلم، وأن أحكامه وشرائعه هي ما يريده الله ويرضاه، فإن واجب التسليم لله أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله، صلى الله عليه وسلم، حين يصح عنه؛ فيؤمن بأن ما جاءت به الشريعة هو من أعظم المصالح وأكمل ما تهتدي إليه العقول. وكل التجارب التي عارضت النصوص بدعوى المصلحة أو العقل لا يطول عليها الزمان حتى تنكشف الدلائل والبراهين عن أحقية النص الشرعي بالعقل والمصلحة مما قد غاب عن مدارك الكثيرين.
إن من كمال العقل أن يعتقد أن ما يجيء في الشريعة هو العقل والمصلحة، وحين يضع عقله سقفاً يحول دون نفوذ شعاع الوحي؛ فإنه سيحرم نفسه خيراً عظيماً في النصوص والأحكام التي يُحكَم من خلالها على معقولات الناس، وتضيع المعايير التي تحدد المعنى الذي يقبله العقل والذي يرفضه؛ فالواجب أن تكون أحكام الشريعة حاكمة على العقل ومحدِّدة لأُطُرِه ومسيِّرة لعمله، وليس العقل هو الذي يحدد الشريعة ويضع عليها الشروط والمواثيق.
إنهم بهذا يؤمنون بأحكام الشريعة إلا قليــلاً، وهذا القليل لا يعلمه إلا الله؛ فقد ينكشف في أبــواب الاعتقــاد أو المعاملات أو العبادات، وقد يكون كثيراً أو قليلاً، وقد يكون من الأحكام الـمُجمَع عليها أو المختلف فيها، وقد يكون من آيات القرآن أو من نصوص السُّنة، ولا يعلم أحد من أي طريق سيأتي هذا البلاء..؟
ألا فَلْتنسَ كلَّ هذا، ويكفيني أن تعرف أن الفرق بين الشخصين الذين يقول أحدهما:
“أؤمن بالشــريعة. وكــلُّ ما فيها فهو حق ومصلحة”.
ويقول الآخر:
“أؤمن بالشريعة ما لم تعارض العقل والمصلحة”.
كالفرق بين من يقول:
“أؤمن بالشريعة؛ لأنها صدق ولا تخالف الواقع”.
وبين من يقول:
“أؤمن بالشريعة ما لم تكن كذباً ومخالفة للواقع”.
الحق قديم
إنه شيء مدهش حقاً، لم أكن أظن أن هذا المعنى الذي بسطتُ شرحه، وأجهدتُ نفسيَ والقارئَ الكريم في تَتَبُّعه وملاحقة أفكاره، قد صاغه “شيخ الإسلام ابن تيمية” بأسطر من نور يعجز البيان عنها لولا توفيق رب العالمين، يقول، رحمه الله:
“إن ما يستخرجه الناس بعقولهم أمر لا غاية له؛ سواء كان حقاً أو باطلاً؛ فإذا جوَّز المجوِّز أن يكون في “المعقولات” ما يناقض خبر الرسول لم يثقْ بشيء من أخبار الرسول؛ لجواز أن يكون في “المعقولات” التي لم تظهر له بَعْـــدُ ما يناقض ما أخبر به الرسول، صلى الله عليه وسلم. ومن قال: أنا أُقِرُّ من الصفات بما لم ينفِهِ العقل أو أُثْبِت من السمعيات ما لم يخالفه العقل، لم يكن لقوله ضابط؛ فإن تصديقه بالسمع مشروط بعدم “جنس” لا ضابط له ولا منتهى. وما كان مشروطاً بعدمِ “ما لا ينضبط” لم ينضبط؛ فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان؛ ولهذا تجد من تعوَّد معارضة الشــرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان”. (1درء تعارض العقل والنقل: 1/ 177)
الهوامش:
- درء تعارض العقل والنقل: 1/ 177.
المصدر:
- د. فهد بن صالح العجلان، مجلة البيان، العدد : 275.
اقرأ أيضا:
- قاعدة الإسلام عبر الرسالات
- الغزو الفكريّ .. حقيقته وركائزه ووسائله
- إبراهيم وإسماعيل إذ يجسدان معنى التسليم